Web - Windows - iPhone


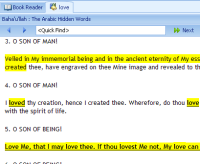

المحفل الروحاني المقدّس للبهائيين في حيفا .................................... 11 1- جناب نبيل الأكبر - آقا محمد القائني ................................. 13 2- حضرة اسم الله الأصدق .............................................. 18 3- حضرة ملاّ علي أكبر ................................................. 22 4- حضرة الشيخ سلمان .................................................. 26 5- حضرة أفنان السدرة المباركة - جناب آقا ميرزا محمد علي ........... 30 6- حضرة الحاجي ميرزا حسن أفنان .................................... 35 7- حضرة آقا محمد علي إصفهاني ...................................... 38 8- جناب آقا عبد الصالح الباغبان (البستاني) ............................ 41 9- جناب الأستاذ إسماعيل .............................................. 44 10- جناب نبيل الزرندي ................................................. 47 11- جناب درويش صدق علي ........................................... 51 12- آقا ميرزا محمود وآقا رضا .......................................... 54 13- جناب پدرجان القزويني .............................................. 57 14- جناب آقا الشيخ صادق اليزدي ....................................... 58 15- جناب شاه محمد أمين ................................................ 60
16- جناب مشهدي فتّاح ................................................. 63 17- جناب نبيل قائني ................................................... 65 18- جناب آقا سيد محمد تقي المنشادي .................................. 71 19- جناب آقا محمد علي صبّاغ اليزدي ................................ 75 20- جناب آقا عبدالغفار ................................................ 77 21- جناب آقا علي النجف آبادي ....................................... 79 22- جناب مشهَدي حسين ومشهدي محمد الأذربايجانيّين ............... 81 23- جناب الحاج عبدالرحيم اليزدي ................................... 83 24- جناب الحاج عبدالله النجف آبادي ................................. 86 25- جناب آقا محمد هادي الصحّاف ................................... 87 26- جناب آقا ميرزا محمد قُلي ......................................... 90 27- جناب أستاذ باقر وجناب أستاذ أحمد ................................ 92 28- جناب آقا محمد حنا ساب .......................................... 94 29- جناب الحاجي فرج الله التّفرشي .................................... 96 30- آقا إبراهيم الإصفهاني وإخوانه .................................... 98 31- جناب آقا محمد إبراهيم الملقّب بمنصور ........................... 102 32- جناب آقا زين العابدين اليزدي .................................... 104 33- جناب الحاج ملا مهدي اليزدي ................................... 106 34- حضرة الكليم يعني جناب آقا ميرزا موسى ....................... 108 35- جناب الحاج محمد خان .......................................... 113 36- جناب آقا محمد إبراهيم أمير ..................................... 116 37- جناب آقا ميرزا مهدي الكاشاني .................................. 117
38- جناب مشكين قلم ................................................. 120 39- جناب الأستاذ علي أكبر النّجار ................................... 124 40- جناب آقا شيخ علي أكبر المازكاني ............................... 126 41- جناب آقا ميرزا محمد خادم المسافر خانه ......................... 128 42- جناب آقا ميرزا محمد الوكيل ..................................... 130 43- جناب الحاج محمد رضا الشيرازي ............................... 139 44- جناب حسين أفندي التبريزي ...................................... 141 45- جناب آقا جمشيد الكرجي .......................................... 143 46- الحاج جعفر التبريزي وإخوانه ..................................... 145 47- حضرة الحاج ميرزا محمد تقي أفنان ............................... 149 48- جناب آقا عبدالله البغدادي .......................................... 153 49- حضرة آقا محمد مصطفى البغدادي ................................. 155 50- جناب سليمان خان التنكاباني ........................................ 158 51- جناب آقا عبدالرحيم مِسگر (النحاس) ............................... 163 52- جناب آقا محمد إبراهيم التبريزي ................................... 164 53- جناب آقا محمد علي الأردكاني ..................................... 165 54- الحاج آقاي التبريزي ............................................... 167 55- جناب الأستاذ غلام علي النجار ..................................... 169 56- جناب منيب ........................................................ 171 57- جناب آقا ميرزا مصطفى النراقي .................................. 174 58- جناب زين المقربين ................................................ 177 59- جناب عظيم التفرشي ............................................... 181
60- آقا ميرزا جعفر اليزدي ............................................. 183 61- جناب حسين آقا التبريزي ........................................... 186 62- جناب الحاج علي عسكر التبريزي .................................. 188 63- جناب آقا علي القزويني ............................................. 192 64- جناب آقا محمد باقر وآقا محمد إسماعيل ............................ 195 65- جناب آقا أبو القاسم سلطان آبادي وجناب آقا فرج ................... 198 67- جناب حرم سلطان الشهداء ......................................... 200 68- شمس الضّحى واللوح المبارك الذي نزل بشأنها ..................... 203 69- جناب الطاهرة (قرّة العين) .......................................... 217
كلمة النّاشريُعتبر كتاب تذكرة الوفاء الصّادر من قلم حضرة عبدالبهاء أثرًا يُمثّل وفاء مركز العهد والميثاق لنفوس أخلصت وجوهها لحضرة بهاءالله، فصارت، في أشخاصها ونهج حياتها، رموزًا تحكي عن القِيَم البهائيّة في حالتها التّطبيقيّة. فقد ضحّى البعضُ من تلك النّفوس النّفيسة بروحه في سبيل الجمال المبارك، كما ضحّى البعضُ منها بحياته وما فيها من متاع الدّنيا لأجل إعلاء أمر الله وإثبات كلمته المباركة بين العالمين حتّى يتحقّق الهدف الأسمى من رسالته المباركة، ألا وهو وحدة العالم الإنساني.
عندما يسرد قلمُ حضرة عبدالبهاء سيرة كلّ فرد من أولئك الّذين يذكرهم في هذه التّذكرة، إنّما يذكّر أهلَ العالم بما ينبغي أن يكون عليه الإنسان إذا أراد أن يكون صورة الرّحمن ومثاله بين خلقه. لذلك ليس هذا الأثر المبارك كتابًا في التاريخ، بالمعنى المتعارف عليه، أو في تراجم السّلَف من المؤمنين، بقدر ما هو رسالة في منهاج الحياة البهائيّة المتمثّلة عمليّاُ في سيرة كلّ مؤمن خَصّص له قلمُ الميثاق قسمًا من هذا الكتاب.
وإنّه من دواعي السّرور أن ننشر للمرّة الأولى ترجمةً لتذكِرة الوفاء إلى اللّغة العربيّة قام بها المغفور له حسين روحي ابن الحاج ملاّ علي
التّبريزي. وُلد حسين في القاهرة سنة 1878م، بعد قدوم والده إليها بأمر من حضرة بهاءالله. إثر مقتل والده أثناء رحلة تبليغيّة في ديار بكر، وكان حسين فتىً يافعًا، عاش هذا الأخير فترةً في كنف والدته قبل أن يتكفّل الحاج ميرزا حسين الخراساني بتربيته وتعليمه اللّغة الفارسيّة. عندما أرسل حضرة عبدالبهاء الميرزا الخراساني المذكور عام 1899 مع آخرين إلى أمريكا، اختير حسين روحي مترجمًا لهم، فأقاموا في شيكاغو حتّى عام 1902. في تلك الفترة أكمل حسين دراسته الجامعيّة، مما أهّله للعمل في تدريس الإنجليزيّة في مدارس مصر بعد عودته إليها. التقى عام 1906 بالميرزا أبي الفضل الكلبايكاني في القاهرة، وكان يحضر معظم مجالسه التبليغيّة. في السّنة ذاتها أسّس حسين روحي في القاهرة مدرستين سمّاهما "العباسيّة"، تيمّنًا باسم حضرة عبدالبهاء عباس، واحدة للذّكور وأخرى للإناث، استمرّتا في العمل حتى إغلاقهما عام 1919. في السّنة التالية – 1920 – عُيّن مفتّشًا للتّربية والتّعليم في فلسطين، وكان مقرّ عمله في القدس، ومنها كان يقوم بزيارات إلى حيفا التي كان موجودًا فيها في اليوم الأربعين لصعود حضرة عبدالبهاء، وذلك عندما تُليت ألواح الوصايا وأُعلن فيها عن تعيين حضرة شوقي أفندي وليًّا لأمر الله. بقي في فلسطين شاغلاً مناصب حكوميّة إلى أن أُحيل إلى التّقاعد عام 1935. عندها عاد حسين روحي إلى مصر بأمر من حضرة وليّ أمر الله، فخدم فيها الأمر المبارك في المجالات الإداريّة والتبليغيّة، كما ساهم في ترجمة بعض الآثار المباركة الفارسيّة إلى العربيّة، ومنها تذكرة الوفاء. في الشّهر الحادي عشر من عام 1960 توُفّي المترجِم، ووري الثّرى في المدافن البهائيّة في القاهرة.
المحفل الروحاني المقدّس للبهائيين في حيفاوافق المحفل الروحاني المقدّس للبهائيين في حيفا، في شهر يناير/ك2 سنة 1924م الموافق لشهر جمادى الأولى سنة 1342ﻫ، على أن يقوم جناب آقا محمد حسين جراف اليزدي الشهير بالكهربائي، بناء على طلبه، بطبع الكتاب الموسوم ب "تذكرة الوفاء" المدرج بين دفّتيّه تراجم عدد من الذوات المباركة من المهاجرين والمجاورين رقمها قلم مركز الميثاق الأنور (حضرة عبدالبهاء)، حقائق المقدّسين لتراب عتبته المقدّسة فداء، في سنة 1915م. فنثرت هذه التراجم الدرر واللئالىء المضيئة من بحر الجود والإحسان والعفو والغفران السّاطعة من أشعة الشمس المضيئة على قلوب أهل الاطمئنان.
والمعلوم أنه قد سبق أن حصل حضرة حسين الكهربائي المذكور من ساحة المولى الأعز الأكرم (حضرة عبدالبهاء) على الإذن بطبع الكتاب المذكور والقيام بهذه الخدمة. غير أنه قد حال دون القيام بطبع الكتاب هبوب نار الفراق التي أحرقت قلوب العشاق بلظى الهجران الذي أجّجه حادث الصعود المبارك الذي أرجف السبع الطباق. أمّا المذكور فلم يُثنِه شيء عن القيام بإنارة المقامات المقدّسة الثلاث بالكهرباء كعادته، بما عُهد فيه من صِرف المحبة والإخلاص في هذا السبيل بهمّة زائدة ونشاط له قيمته. وكان التوفيق حليفه في جميع
الأحوال إلى أن تحيّن الفرص بطلب الإذن بطبع الكتاب المذكور من ساحة مركز الأمر ولي الأمر الرحماني (حضرة شوقي أفندي ربّاني) أرواحنا لوحدته الفداء.
وما أن صدر له الإذن المبارك بذلك حتى شدّ ساعد الهمّة بكلّ اشتياق وباشر في طبع الكتاب على نفقته. وقد جعلنا حقوق الطّبع محفوظة لنفس النّاشر جناب محمد حسين علي الشّهير بالكهربائي.
تحريرًا في شهر يناير/ك2 سنة 1924م.كان ضمن تلاميذ الشيخ مرتضى، المجتهد الشهير في النجف الأشرف، شخص لا نظير له يُدعى آقا محمد القائني الذي لقّبه حضرة جمال القدم بِ النبيل الأكبر، وكان هذا الشخص الجليل متفوّقًا على جميع تلاميذ ذلك المجتهد بدرجة أن معلّمه قد استثناه ومنحه إجازة الاجتهاد مع أن المرحوم الشيخ مرتضى لم يَمنح أحدًا إجازة الاجتهاد غير هذا التلميذ. وفضلاً عن كل هذا فقد كان النبيل الأكبر غزير المادة متمكّنًا من حكمة الإشراقيين ومباحث العرفاء وأنواع المعارف الشيخيّة والفنون الأدبية بدرجة تفوق حد الوصف. وبالإجمال: كان شخصًا جامعًا قويّ الحجة والبرهان وقد أصبح شعلة رحمانية وسراجًا مضيئًا وعطّر مشامّه بنفحات القدس واستنار بنور الهدى بإيمانه بالبهاء فأوقد في مشكاة وجوده مصباح الوجد الكليّ والشغف والوله حتى صار كالحوت السابح في خضمّ العشق المتماوج.
وبعد أن نال درجة الاجتهاد بكمال التفوق من شيخه ظعن إلى بغداد حيث فاز بشرف اللقاء (لقاء حضرة بهاءالله) واقتباس الأنوار من شجرة السيناء المباركة وما لبث أن استولت روح الأمر على جميع أركانه
ودبّت في عروقه حمية الإيمان بدرجة جعلته في هياج مستمر.
وبينما كان ذلك الرجل الجليل (النبيل الأكبر) المحترم جالسًا على الأرض ذات يوم في محضر النّور المبين (حضرة بهاءالله)، وإذا بالحاجي ميرزا حسن عمو معتمد المجتهدين في كربلاء قد حضر ومعه زين العابدين خان فخر الدولة. ولمّا شاهد حضرة النبيل الأكبر جاثيًا على الأرض بكمال الأدب والخضوع والخشوع أخذه العجب وهمس في أذن النبيل قائلاً: "يا جناب الآقا ما الذي أتى بك إلى هنا؟" فأجابه جناب النبيل الأكبر قائلاً: "نفس الغرض الذي أتيت أنت من أجله". فكان هذا الجواب، وأيم الحق، سبب اندهاش الحاجي ميرزا حسن عمو وزميله لعلمهما أنّ النبيل الأكبر مشهور بامتيازه وتقواه وتفوّقه على سائر المجتهدين وأنّ اعتماد الشيخ مرتضى الجليل كان على النبيل بدرجة عظيمة جداّ.
وقصارى القول: إن حضرة النبيل قصد بعد ذلك إيران وألقى عصاه في إقليم خراسان حيث أدّى له أمير إقليم قائن نهاية الاحترام في أول الأمر معتبرًا حضوره مَغْنَمًا لا يقدّر حتى اعتقد الأهلون أن نفس الأمير صار مغرمًا بجناب النبيل ومن عشّاقه المتعلّقين به لعظيم فصاحته وعلو كعبه في مختلف العلوم والفنون وهذا أدّى أيضاّ إلى احترام الجميع للنبيل "والناس على دين ملوكهم".
فمرّت عدة أيام على حضرته كان خلالها مغمورًا بالتعزيز والاحترام ومع كل هذا، فلم يقدر على كتمان الحقيقة التي أشعلتها في فؤاده نار محبة الله الموقدة وتملّكته عوامل الحيرة والاندهاش بدرجة أنّه ترك جميع الأعمال وأخذ في خرق الحجبات بما استطاع من قوة على حد قول القائل: (ما ترجمته):
جاهدت بكلّ قواي حتى ألبس من العشق ثوبًاأما إقليم قائن فقد أضاء بنور الحقيقة وآمن العدد الكثير من الأهلين. ولمّا اشتهر حضرته بعقيدته بين القوم. قام أهل الحسد من العلماء بالنّفاق والشّقاق والسعاية به لدى الحكومة في طهران، فاستفزّ ذلك ناصر الدين شاه على الانتقام فدبّ الخوف في رَوْع أمير إقليم قائن وقام، خوف نفس الشاه، على جناب النبيل ومناوأته. فهبّ ريح الولولة وأُوقظت الفتنة العظيمة من نومها في مدينة قائن وهاج القوم وقاموا يدًا واحدةً على مناوأة النبيل الأكبر والتعرّض له. ولكن عزيمته لم تفتر بل قاوم الجمهور بقلبٍ أصلب من الصخر من شدّة حبّه للمحبوب. وفي النهاية ألقوا القبض على ذلك الواقف على السرّ المكنون وأرسلوه مخفورًا إلى طهران حيث آقام خالي الوفاض لا يملك قوت يومه وتطاولت عليه الرعاع وانبثت العيون في العاصمة لإلقاء القبض عليه ومعاقبته وأذاه، وذاق من أهل الظلم ضروب الإهانات في كل مكان آوى إليه وكانوا لا ينظرون إليه إلا شزرًا. وبالآخرة أُجبر على أن يلبس طِربوشًا بدل العمامة حتى لا يعرفه المناوئون ويسلَم من تحرّشهم وأذاهم، وكان لا يهدأ عن نشر النفحات في الخفاء بكل همّة ونشاط بإلقاء الحجج والبراهين المألوفة.
حقًا، إنه كان سراجًا نورانيًا وشعلة رحمانية. كان وجوده في خطر عظيم غير أنه كان ملء قلبه الحذر إذ كانت الحكومة مرسلة عيونها عليه والأحزاب في قيل وقال بالنسبة إليه فألجأه كل هذا إلى الرحيل إلى بوخارى وعشق آباد وأخَذَ في إلقاء بيانات الأسرار كالسراج الوهاج، ولم يُثنِهِ شديد الصّدمات ولا عظيم البليّات عن نشر النفحات
بل كان يزداد توقّدًا. أما ذلاقة لسانه وتفنّنه في معالجة أمراض المجتمع فحدّث عنهما ولا حرج. كان كالمرهم لِما بالقوم من جراح، يَهدي الناس بكلّ حكمة سائرًا على قاعدة أهل الإشراق والعارفين، يكشف اللّثام عن وجوه الحقائق ويثبت ظهور مليك الوجود بكل حجة دامغة، ويقنع مشايخ الشيخيّة بصريح عبارات كلّ من المرحوميْن الشيخ أحمد الإحسائي والسيد كاظم الرشتي. أما الفقهاء فكان يقنعهم بآيات القرآن وأحاديث أئمّة الهدى بالدليل الواضح والبرهان القاطع، وكان يعالج كل داء بعلاج فوري، ويمدّ فقراء العقول بما يُلهمهم الصواب. ولكنه أصبح في بوخارى بلا معين وابتلي بصدمات لا حدّ لها، وكانت عاقبة ذلك، الشّهم كاشف الأسرار، الانتقال إلى ملكوت ذي الجلال تاركًا رسالته البليغة وضمّنها الأدلة الواضحة والبراهين القاطعة. ولكن يد الاغتيال سطت عليها، ولم تشأ يد الأقدار أن تُنشر لتكون سبب تنبّه العلماء والفضلاء.
والخلاصة، إنه وإن كان حضرته محاطًا بالبلايا أيام حياته غير أنه محا وأزال من الوجود أسماء وصيت جميع المشايخ العظام أمثال الشيخ مرتضى، وميرزا حبيب الله، وآيةالله الخراساني، وملا أسدالله المازندراني، وجعل ذكر مشايخ السلف والخلف في خبر كان. أما نجم جناب النبيل الأكبر فسيبقى لائحًا منيرًا من أفق العزة الأبدية لأنه كان على الدوام ثابتًا على الأمر راسخًا فيه، مشغولاً بالخدمة وتبليغ النفوس، ونشر التفحات.
ومن الواضح أن كل عزّة أصابت المرء عن طريق غير طريق أمر الله تنتهي إلى الذلّة، وكل راحة يشعرها الإنسان في غير سبيل الله تنتهي إلى المشقّة والعناء، وكذلك كل ثروة تنتهي إلى الفقر
والمسكنة.ومما لا ريب فيه أن جناب النبيل الأكبر كان آية الهدى والتقوى في الأمر المبارك، مضحيًّا بالنفس والنفيس بكل سرور وانشراح وقد عاف العزّة الدنيوية وأغمض عينيه عن الغِنى والجاه والتربّع في دسوت المناصب وفكّ نفسه من أسْر التقييد وجرّدها من جميع الأفكار غير المجدية. وكان عالمًا فاضلاً ماهرًا في جميع الفنون، مجتهدًا لا يُجارى، حكيمًا عارفًا، طويل الباع في العلوم الأدبية، فصيح اللسان بليغ التعبير، نطوقًا لا يضارع، وكان في حدّ ذاته جامعة بمعنى الكلمة وكانت خاتمة المطاف بادية الألطاف. عليه بهاءالله. نوّر الله مرقده بأنوار ساطعة من الملكوت الأبهى وأدخله في جنة اللقاء وأخلده في ملكوت الأبرار مستغرقًا في بحر الأنوار.
(2) حضرة اسم الله الأصدقمن جملة أيادي أمر الله الذين صعدوا إلى الرفيق الأعلى عليهم نفحات الرحمن كان جناب اسم الله الأصدق وجناب النبيل الأكبر (آقا محمد القائني) وجناب الملا علي أكبر وجناب الشيخ محمد رضا اليزدي وحضرة الشهيد (الميرزا ورقاء) وغيرهم. وحقًّا إن حضرة اسم الله الأصدق قد خدم الأمر من فجر حياته إلى النَفَسْ الأخير خدمة حقّة. تتلمذ في أيام شبابه على يد المرحوم السيد كاظم الرشتي وعاش في معيّته وكان مشهورًا بكمال التقديس في إيران وكان معروفًا بين القوم بالملاّ صادق المقدّس. كان إنسانًا مباركًا، وعالمًا فاضلاً، يحترمه الجميع وكان أهالي خراسان متعلّقين به تعلّقًا كليًّا لأنّه كان في الحقيقة فاضلاً نحريرًا ومن مشاهير العلماء الذين لا نظير لهم. كان في التبليغ ذا لسان فصيح قويّ الحجّة بدرجة تستوجب الإعجاب، وكان يُقنع مناظريه دون تعقيد أو لَبس.
وبعد أن حضر إلى بغداد وفاز بشرف الحضور واللقاء، كان جالسًا ذات يوم في محلّ الاستقبال على حافة البستان وتصادف أنّني كنت في غرفة مطلّة عليه وإذا بالشاه زاده (حفيد فتح علي شاه) قد حضر وأومأ إلى جناب اسم الله الأصدق وقال: "أراك هنا!" فأجابه اسم الله
الأصدق قائلاً: "أنا عبد هذا الرحاب وبستاني هذا البستان". وشرع في تبليغ الشاه زاده وكنت أتسمّع لحديثه من الغرفة المذكورة. وإذا بالشاه زاده قد احتدّ واعترض ولم يلبث جناب اسم الله الأصدق أكثر من ربع ساعة حتى أسكته بعد أن كانت دلائل الإنكار وآثار الحدّة بادية على وجهه بكل وضوح وما أن هدأت تلك الحدّة حتى قال لجناب اسم الله الأصدق: "إنني لمسرور جدًا بلقائك ولقد أصغيت لحديثك بأُذُنٍ واعية".
وبالإجمال، إن اسم الله الأصدق كان دائمًا أثناء التبليغ هشًّا بشًّا، وإذا رأى من مناظره غضاضة وحدّة قابلها باللّين واللّطف بثَغر باسم. أما طريقته في التبليغ فلا نظير لها إذ كان في الحقيقة اسمًا على مسمى يعني اسم الله حقًا.
أما في حفظ الأحاديث فكان خزانة جامعة وعلى الأخص في مطالب المرحوميْن الشيخ الإحسائي والسيد الرشتي. وقد آمن بالأمر من بدايته في شيراز واشتهر بذلك هناك. ولما كان يبلّغ الناس جهرة وبدون مبالاة، ألقت الحكومة عليه القبض وخزموه من أنفه وحاموا به في الطرقات. أما هو فلم ينزعج بل كان دائمًا مسرورًا ضاحك الوجه بشوشًا ولا يسكت عن محادثة رفاقه.
وبعد أن أطلقوا سراحه حكموا عليه بالرحيل إلى خراسان حيث أخذ في التبليغ كعادته ثم رافق جناب باب الباب (الملا حسين البشروئي) إلى قلعة الطبرسي وتحمّل المصائب ودخل في زمرة الفدائيين. وما لبث أن أسروه في القلعة وسلّموه ليد رئيس الحكومة في مازندران فأبعده هذا الأخير إلى جهة أخرى من إقليم مازندران ليسقوه كأس الشهادة. وما أن وصل إلى المحلّ المقصود حتى قَيّضَ له
الله شخصًا فكّ ما عليه من السلاسل والأغلال وخلّصه من السجن في منتصف الليل وأوصله إلى محلٍّ آمنٍ وما فتئت الامتحانات تنصبّ عليه وهو يتحمّلها برباطة جأش ورسوخ. وبينما كان محصورًا في القلعة كان لا يبالي بما كانت تَصُبّه الأعداء من القنابل من فُوّهات المدافع على القلعة بلا انقطاع. وقد أمضى هو والأحباب في القلعة ثمانية عشر يومًا بلا طعام حتى أنهم أكلوا جلود أحذيتهم وصبروا على الماء بقيّة أيام محاصرتهم وكان كلّ منهم لا يتناول أكثر من جرعة واحدة من الماء في كل صباح وكنت تراهم مطروحين على الأرض من شدّة ما أصابهم من ضعف. وكانوا كلّما شعروا بهجوم الجنود على القلعة دبّت فيهم، من عند الله، روح القوّة فصدّوا العساكر وأخرجوهم من القلعة.
أما كونهم طووا الضلوع على الجوع مدة ثمانية عشر يومًا فذلك من أشدّ الامتحانات من جهة أنّهم كانوا غرباء محصورين، ومن جهة ثانية الجوع، والذي زاد الطين بِلّة هجوم الجنود وسقوط القنابل والمفرقعات في ساحة القلعة.
حقًّا إنّه لمن الصعب أن يتحمّل الإنسان ذلك ويبقى ثابتًا راسخًا في معتقده ولم يتزلزل. وأيم الحق، إن جناب اسم الله لم يعترِه، رغم هذه المصائب والشدائد، أدنى فتور إذ أخذ في التبليغ بعد أن أُطلق سراحه وأوْقف كل أنفاسه للنداء بملكوت الله وإحياء النفوس، وقد فاز بشرف اللقاء في العراق وفي السجن الأعظم (عكّاء) وكان محطّ العناية العظمى من الجمال المبارك.
أما هو فكان بحرًا زاخرًا في العلوم وبازًّا مرتفعًا في آفاق الفنون المتنوعة ذا قدرة وقوة عجيبة واستقامة لا تجارى في التبليغ، براهينه
الدامغة وأدلّته المسكتة تتدفق كالسيل وكان حال تلاوة الأنجية تنهمر الدموع من آماقه كالمطر المدرار وكان نوراني الطلعة رحماني الأخلاق عالمًا ملهمًا، همّته سماوية وانقطاعه وزهده وورعه وتقواه كان ربانيًّا.
جدثه المنوّر في همدان وقد جرى القلم الأعلى في حقّه بألواح شتّى وأيضًا نزل له بعد وفاته لوح للزيارة خاص به، وكان إنسانًا عظيم القَدْر كامل الصفات. وقد تركت أمثال هذه النفوس المباركة هذا العالم والحمد لله ولم تشأ الإرادة الإلهية لهم أن يبقوا حتى لا يشاهدوا ما حلّ من البلايا بعد الصعود المبارك وحتى لا يقعوا بين مخالب الامتحانات الشديدة التي تزلزلت منها الجبال الراسيات والقُلل الشامخة. وفي الحقيقة إنّه اسم الله بكل ما في هذه الكلمة من معنىً. طوبى لنفس طاف حول جدثه واستبرك بتراب رمسه. وعليه التحية والثناء في ملكوت الأبهى.
(3) حضرة ملاّ علي أكبر عليه بهاءاللهكان من جملة أيادي أمر الله حضرة ملاّ علي أكبر عليه بهاءالله. دخل هذا الرجل العظيم المدارس منذ نعومة أظفاره ونشأ في أحضان العلوم والمعارف وحصَل بجدّه واجتهاده على أعلى الدرجات وتضلّع في جميع قواعد القوم والمعارف المليّة والفنون العقليّة والعلوم الفقهيّة وبرع في كل ذلك، ثم اندمج في سلك الحكماء والعرفاء والشيخيّة فنبغ في كل ما كانوا عليه وكان من الإشرافيّين، غير أنه كان متعطّشًا للحقيقة ولسد رمقه الروحي بغذاء من المائدة السماوية. ولم يُعِقْه ما لآقاه في هذا السبيل من عقبات كأْداء، ولم يصرف ساعات حياته إلا في فائدة يستخرجها أو عائدة يستدرجها. ولم يفز بما يأمل فبقي متعطّشًا حيرانًا هائمًا على وجهه في بيداء الطلب حيث لم يجد بين الأحزاب نفحة الميل الشديد ولم يستشم منهم رائحة الانجذاب والعشق الروحي. ولمّا تعمّق فيما كانت عليه الأحزاب المختلفة، اتضح له أنّه منذ ظهور حضرة الرسول محمد المحمود إلى يومنا هذا، قد ظهرت أحزاب عديدة ومذاهب مختلفة وآراء متباينة ومسائل متنوّعة وطرائق كثيرة يدّعي كل منها المكاشفة المعنوية بأسلوب خاص، وعلى ظنّهم، أنهم يسلكون السبيل المستقيم. ولكن البحر المحمدي
إذا أرسل موجة واحدة من أمواجه لأغرق جميع هذه الأحزاب في عمقه حيث لا يُسمع لهم صوتٌ ولا رِكزٌ. وإذا ما تتبّع الإنسان التاريخ لوجد أنّه قد ظهرت أمواج من هذا البحر فقذفت بهذه الطرائق حتى أصبحت كالظلّ الزائل وانعدمت من الوجود. أما البحر فلم تتزعزع أركانه. لهذا قد ازداد تعطّش حضرة ملاّ علي أكبر يومًا غُبّ يوم حتى وصل إلى بحر الحقيقة فصاح قائلا:
الله أكبر هذا البحر قد زخرا وهيّج الريح موجًا يقذف الدررا
فاخلع ثيابك واغرق فيه ودع عنك السباحة ليس السبح مفتخرا
وبالاختصار، إن حضرة علي قبل أكبر قد فار كالفوارة وجرت منه حقائق المعاني كالماء المعين وكان في بداية سلوكه يسلك سبيل الرضاء في مسالك الفقر والغناء واقتباس الأنوار ثم أخذ في التبليغ وما أحسن ما قال: (ما ترجمته)
إنما النفس التي وهبها القدير وجودًافالمبلّغ عليه أن يبلّغ نفسه أولاً كي يستطيع تبليغ غيره. فإذا سلك سبيل الشهوات كيف يمكنه هداية الناس بالآيات البينات؟
ومجمل القول، إن هذا الشخص الجليل قد قام، بتوفيق من الله، بتبليغ عدد وفير من الأهلين وأوصل النداء إلى مسامع الذين جذبتهم محبّة الله وأصبح جنديًا في ميدان العشق الإلهي هائمًا في بيداء الوله الرحماني حتى أنه اشتهر بين الخلق بالمجنون. أما من جهة الإيمان والإيقان فقد هتك وفضح الخاص والعام في مدينة طهران وكان معروفًا ببهائيته وكان القوم يشيرون إليه بالبنان في الأسواق قائلين: "ها هو
البهائي"، وكلما وقعت فتنة، كان أول من تُلقي عليه الحكومة القبض وكان دائمًا مستعدًا لذلك إذ كان لا يأبه بما يكون لأنه كثيرًا ما زُجّ في أعماق السجون وقيّد بالأصفاد حتى أنّهم قد هدّدوه بقطع عنقه بالموسى أو بالسيف. وكان يبدو على شمائله، بينما كان مصفدًا هو وحضرة أمين الجليل، ما يدهش الناظرين من إمارات الرضاء والتسليم رازحًا تحت السلاسل والأغلال وهو في غاية الهدوء والاستكانة وبلغ به الأمر أنّه كان كلّما حصلت ضوضاء لبس عمامته وتردّى بعباءته واستعدّ لمجيء الشرطة ليعتقلوه ويزجّوه في أعماق السجون غير أن يد القدرة الإلهية كانت تحفظه وتصونه إبان كل ضوضاء. ومن الغريب أنّك كنت تلاحظ عليه الجفاف وهو بين أمواج بحر المناوأة وكان في خطر عظيم في كامل هنيهات حياته ولا مِراء في ذلك لأن الأعداء كانوا له بالمرصاد. أما هو فكان مشهورًا لمحبّته للنور المبين (حضرة بهاءالله) وقد حفظه الله، رغم كل ما ذكر، من جميع الآفات وأنقذه الله من بحر الأذى المتلاطم وجعل نار الضغينة والبغضاء بردًا وسلامًا عليه إلى أن وقع الصعود المبارك.
استمرّ حضرته بعد صعود المقصود ثابتًا راسخًا للغاية على عهد وميثاق الربّ الودود مناديًا بالميثاق مروّجًا لعهد نيّر الآفاق، وقد هرع في أيام اللّقاء بكمال الاشتياق إلى الساحة المقدّسة وتشرّف بالمثول بين يدي الحضرة وكان مشمولاً بعناية الحق وملحوظًا بعين الرعاية والعواطف الرحمانية. ثم عاد إلى إيران مكرّسًا لحظات حياته لخدمة الأمر. وكان شديد المراس في آقامة الحجّة للمناوئين الظالمين رغم التهديد والتخويف من جانب الأعداء ولم يطأطيء لهم الرأس حيث لم يَقوَ أحد على إفحامه وإسكاته. كان يقول كل ما عنّ له لأنّه كان واثقًا
من نفسه لأنه كان من أيادي أمر الله، ثابتًا مستقيمًا أرسخ من الراسيات.
أما أنا فقد كنت أحبّه محبّة مفرطة لأنه كان حلو الحديث ونديمًا لا يملّ وأذكر أنني قد رأيته ليلة في الرؤيا وكأنه جاء من سفرة بعيدة ورأيت أن جسمه أضخم مما كان عليه في السجن أيام حياته فقلت له: "يا جناب الملاّ أراك قد سمنت". فقال: "نعم، الحمد لله قد طوّحَتْ بي يد الترحال إلى جهات طاب هواؤها وعذُب ماؤها للغاية وكانت المناظر بها مبهجة والغذاء لذيذًا فلاءم كل ذلك جسمي فاستفاد السمن وازددت قوة ونشاطًا وعدت إلى نشوة الشباب الأولى وانتشقت النفحات الرحمانية وكنت دائمًا مشغولاً بذكر الحق ناطقًا بالبراهين خائضًا في بحار التبليغ (التبليغ في عالم الرؤيا عبارة عن نشر النفحات القدسية وهذا هو عين التبليغ). فمختصر القول: إنه بينما كنا نتحادث في عالم الرؤيا وإذا بجمع غفير من الناس قد حضروا واختفى هو عن ناظري.
أما مرقده النوراني فهو في طهران. ولو أن جسمه تحت الثرى غير أن روحه النقيّة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إنّني لمشتاق لزيارة مراقد أحباء الله إذا وفّقني ربّي إذ إن هؤلاء هم عبيد الجمال المبارك وقد تجرّعوا كؤوس البلايا في سبيله وعانوا المشاقّ ولاقوا الصدمات. عليهم البهاء الأبهى وعليهم التحية والثناء وعليهم الرحمة والغفران من ساحة الكبرياء.
(4) حضرة الشيخ سلمانقد سمع نداء الله هذا القاصد الأمين والرسول المبين حضرة الشيخ سلمان، عليه بهاءالله، في بلدة هنديان. فأصبح كالطير الروحاني طائرًا في أوج السرور منجذبًا بدرجة أدّت إلى سفره راجلاً إلى طهران. ولشدّة شوقه واشتياقه وشغفه وولهه الذي لا يُضارع اختلط خفية بالأحباء في طهران، وما لبث أن تعقّبته الشِّحنة ذات يوم وهو سائر في الطريق مع حضرة آقا محمد تقي الكاشاني، عليه بهاءالله الأبهى، وعرفوا المنزل الذي يأوي إليه وفي اليوم التالي أخذت الشرطة في التحرّي عنه إلى أن عثروا عليه وألقوا القبض عليه وساقوه إلى مركز البوليس حيث سأله المأمور قائلاً: "من أنت ومن أين أتيت؟" فقال: "أنا سلمان من أهالي بلدة هنديان، ومررت بطهران وأنا في طريقي إلى خراسان قصد التشرف بزيارة سيّدنا الرضا عليه السلام". فقال المأمور: "لماذا كنت سائرًا البارحة مع ذلك الشخص لابس العباءة البيضاء؟" فقال الشيخ سلمان: "ذلك لأني بعته عباءة يوم أول من أمس وأردت البارحة أن آخذ منه الثمن". فقال المأمور: "كيف ائتمنته على الثمن وأنت رجل غريب ولست من أهل طهران؟" فقال الشيخ سلمان: "قد كفله أحد الصيارفة المدعو آقا محمد الصراف عليه
بهاءالله". فأرسل المأمور أحد الشرطة برفقته إلى محلّ آقا محمد الصراف لتحرّي الحقيقة. ولما وصلا إلى محلّ الصراف المذكور، أقبل الشرطي على الصراف وقال: "قص علي قصة كفالتك لشاري العباءة من هذا الرجل". فأجاب الصرّاف بقوله: "لا علم لي بذلك" فالتفت الشرطي إلى الشيخ سلمان غاضبًا وقال: "الآن قد برح الخفاء فلا مناص من أنك من البابيين".
ثم قاد الشيخ إلى مركز البوليس وبينما هما في طريقهما إلى المركز قد اخترقا مفرق الطرق وفي تلك الأثناء أتى شخص تاجر أصله من بلدة شوشتر وأخذ في مصافحته ومعانقته لأنه كان لابسًا عمامة كعمامة أهالي شوشتر وقال: مرحبًا بك وأهلاً وسهلاً يا حضرة السيد محمد علي المحترم، أين كنت ومتى أتيت؟" فقال الشيخ سلمان: "أتيت منذ أيام والآن أنا في قبضة هذا الشرطي". فقال التاجر للشرطي: "ماذا تريد منه؟" فقال الشرطي: "إنه بابي". فقال التاجر: "أستغفر الله، إنني أعرف هذا المحترم، الأستاذ محمد علي، وإنه لمن المسلمين الأتقياء ومن شيعة سيدنا علي عليه السلام". ثم ناول الشرطي بعض الدراهم وخلّص الشيخ سلمان من يده. ولما دخلا حانوت التاجر أخذ هذا الأخير في الاستفسار عن أحوال الشيخ سلمان. وهنا أجاب الشيخ بقوله: "أنا لست ذلك الأستاذ محمد علي"، فأظهر التاجر دهشته ثم قال: "إنك والحقيقة هذه تماثل صاحبي الأستاذ محمد علي تمامًا في الشبه والملبس وبما أنك لست هو فيجدر بك أن تعطيني المبلغ الذي أعطيته للشرطي". فما كان من الشيخ سلمان إلا أن نَقَدَهُ المبلغ ثم توجّه توًّا نحو باب المدينة متوجّهًا إلى بلدة "هنديان" محلّ آقامته وبقي بها إلى أن شرّف الجمال المبارك أرض العراق العربي. فكان هذا الرسول الأمين الرحماني أول من قصد الساحة
المقدّسة وفاز بشرف اللقاء والمثول بين يدي الحضرة، وعاد إلى بلده حاملاً لوحًا مباركًا من الساحة المقدّسة إلى أحباء هنديان.
وكان يسافر في كل عام إلى أرض المقصود قَصْد التشرّف بالزيارة ومشاهدة المحبوب ثم يعود حاملاً الألواح المباركة إلى الأحباء بأصفهان وشيراز وكاشان وطهران وغيرها من المدن ويوصلها لأصحابها بكل أمانة. واستمرّ على هذا الحال من سنة 1269 لغاية 1309ﻫ إلى أن وقع الصعود المبارك وهو لا يفتأ يذهب راجلاً من إيران إلى العراق فأدرنه فالسجن الأعظم (عكاء) بنهاية الميل والاشتياق والشغف ويعود بهذه الكيفيّة بالألواح كالعادة متحمّلاً وعثاء الطريق بعزيمة لا تخور، وكان غذاؤه في الأسفار الخبز والبصل في معظم الأوقات، وكان عظيم الحركة ولم تقع عليه أنظار الشحنة في مكان ما. وكان حريصًا كل الحرص على العرائض والألواح التي تكون في عهدته ولم يفقد منها شيئًا وأوصلها جميعها إلى أصحابها رغم تَجشّمه المتاعب والمشاق في الأسفار في بعض البلدان وكان صبورًا شكورًا.
كان الأهلون من الأغيار يُسمّونه جبرائيل البابيين. وحقًا، إنه قد خدم أمر الله مدّة حياته خدمة عظيمة إذ كان سببًا لترويج الأمر وكانت خدماته مورد سرور جميع الأحباء، لأنه كان يحمل البشارات الإلهية كل عام إلى المدن والقرى في إيران، وكان مقربًا لدى ساحة الكبرياء مشمولاً بالعنايات المخصوصة. وقد نزلت في حقّه ألواح شتّى تراها مدرجة في بطون الكتب الإلهية. واستمر بعد صعود الجمال المبارك، روحي لأحبائه الفداء، ثابتًا راسخًا على العهد والميثاق القويم لا يدّخر وسعًا في خدمة الأمر بما أوتي من قوة وهمّة ونشاط، ولم ينقطع عن الحضور إلى السجن الأعظم كعادته حاملاً مكاتيب الأحباء ويعود حاملاً الإجابة
عنها ليوصلها إلى أصحابها في إيران، إلى أن حلّق بجناحيه في مدينة شيراز وطار إلى الملكوت الأبهى.
حقًا، إنه لم يُرَ في عالم الوجود منذ بدء الخليقة إلى يومنا هذا رسولٌ أمينٌ وقاصدٌ نورانيٌّ مثله. والآن توجد عدّة من ذويه واقعين في مخالب الفاقة والعوز لمناسبة الانقلاب الذي حلّ في إيران ومن المؤكد أنّ الأحباء لا يقصّرون في مدّ يد العون إلى المحتاج من ذويه. عليه بهاءالله الأبهى وعليه التحية والثناء.
(5)كان السجن الأعظم في أيام المبارك في أيامه الشداد إذ كانت الحكومة لا تصرّح لأحد من الأحباء بالخروج من القلعة أو الدخول في إليها. وكان المدعو كَجْ كُلاه هو وأحد السادة يسكنان في مكان فوق بوابة مدينة عكاء يرقبان الداخل من بوابة المدينة والخارج منها بكل دقّة، وإذا ما وقع نظرهما على أحد من المسافرين الأحباء وهو يدخل المدينة، أسرعا في إخبار الشرطة بذلك مؤكّدين لهم أن ذلك المسافر من أتباع البهاء وأنه يحمل رسائل البهائيين في بلاده، إلى حضرة بهاءالله وسيعود بالإجابة عنها. فتُلقي حينئذ الحكومة القبض على ذلك المسافر وتنتزع ما معه من الأوراق وتدخله السجن، وبعد مدّة تنفيه من البلاد. واستمرّ الحال على هذا المنوال ردحًا من الزمن، ثم أخذ يتضاءل شيئًا فشيئًا حتى زال بعد سبع سنوات. وبينما كان الحال على ما ذكرنا، إذ حضر من بلاد الهند أحد فروع السدرة المقدّسة المدعو (جناب الحاج ميرزا محمد علي الأفنان) ومرّ في طريقه بمصر ومرسيليا حتى وصل إلى أرض المقصود.
وبهذه المناسبة أقول، إنّني بينما كنت ماشيًا، قبيل الغروب، على
سطح المنزل مع بعض الأحباء التفتُّ إلى الساحل وإذا بعربة آتية عن بعد، فقلت لمن معي: "إنني أشعر بأن في هذه العربة شخصًا مقدسًا من الأحباء ولكني لم أتبيّنه. هلمّوا بنا نحو بوابة المدينة لاستكشاف الخبر، وإذا منعتنا الشرطة عن الخروج، فلننتظر حتى تدنو العربة من البوابة. وفعلاً ذهبنا نحو البوابة وأكرمت الشرطي الذي كان يحرس البوابة ببعض النقود ثم همست في أذنه قائلاً: "هناك عربة آتية وأظن أن بها أحد أصحابنا، فالرجاء عند دنوّها من البوابة لا تعترضها ولا تخبر الضابط بها". فأحضر الشرطي مقعدًا فجلسنا عليه وقت آذان المغرب والبوابة إذ ذاك مغلقة، غير أن خوختها (باب صغير في البوابة الكبيرة لمرور العابرين) كانت مفتوحة والحارس بجوارها. وما لبث أن وصلت العربة وكانت تقلّ حضرة الأفنان المذكور، فترجّل ودخل بوجهه المنير وكانت طلعته المباركة تسرّ الناظرين.
أما جناب الأفنان، فهو من الموقنين الثابتين الراسخين في الأمر، تقطر من شمائله البشاشة على الدوام، وترقّيه في الإيمان كان يزداد يومًا غُبّ يوم، وكذلك في الإيقان والنورانيّة والانجذاب والاشتعال، وعلى الأخص، في الأيام التي قضاها في السجن الأعظم بدرجة لا حدّ لها. وأذكر، أنه بينما كان في العربة في الطريق بين حيفا وعكاء، كانت نورانيّته تجذب الأنظار وشعر بروحانيّته كل من رآه.
وبعد أن استفاض من الفيوضات اللامتناهية، رُخّص له من المحضر المبارك بالسفر، فسافر إلى بلاد الصين لعدّة أيام مشغولاً برضاء الله مطمئنًا بذكره سبحانه وتعالى، ثم انتقل إلى بلاد الهند حيث قضى نحبه وجاور ربّه فأبى المسلمون أن توارى رفاته في مقابرهم. فرأى الأفنان والأحباء أن ينقلوا جسده المطهّر إلى العراق بحجّة أنّهم
سيقبرونه في النجف في جوار مدينة الله (بغداد). فتكفّل حضرة الحبيب (آقا سيد أسدالله) المقيم في بومباي بحمل الرفات المطهّرة بكمال الاحترام إلى بغداد، وقد أوفى بوعده.
وبينما كانت الجثّة في الباخرة، علم بذلك بعض الأعداء من الإيرانيين وأشاعوا الخبر في مدينة بوشهر بأن نعش الميرزا محمد علي البابي في الباخرة في طريقه إلى النجف الأشرف لمواراته هناك، وكيف يدفن البابي في وادي السلام في الجوار المقدّس مع أن هذا لا يجوز. ثم همّ القوم لإخراج النّعش من الباخرة، ولكن التقديرات الإلهية لم تمكّنهم من ذلك.
وبالاختصار، وصل الرفات المقدّس إلى البصرة. ولما كان الوقت يلزم فيه الحيطة والتقيّة، فتظاهر حضرة السيد أسدالله بأنّه ذاهب بالنّعش إلى النجف الأشرف. وكان منتهى آمال الأحباء كما ذكرنا. ولذا جعل الله الأعداء تقوم على المعارضة ومنعوا دفن الرفات في النجف وحاولوا أخذ الرفات من الحجر الصحي ليلقوه في اليمّ أو يطرحوا به في الصحراء وأصبح لهذه المسألة عظيم الأهميّة. وبالنتيجة لم يتمكّن حضرة السيد أسدالله من أخذ الرّفات إلى النجف بأيّة حال، فأجبر أن يذهب بها إلى بغداد. وهناك أيضًا لم يجد مكانًا لدفن الجثة التي حفظها الله من الأعداء. واستقرّ الرأي أخيرًا إلى أخذها إلى مقبرة سلمان الفارسي (الصحابي) على مسافة خمسة فراسخ من بغداد ليدفنوها على مقربة من قبر سلمان بالقرب من إيوان كسرى، ثم واروا تلك الوديعة الإلهية في مقرها الأخير بجوار إيوان نوشيروان في جدث محكم الأركان.
أما ذلك الإيوان الذي كان عاصمة ملك ملوك إيران الأوّلين فقد حوّلته يد المقادير، بعد ألف وثلاثمائة سنة، إلى هضبة من التراب
ممزّقة الأركان بعد أن كانت عظمته الملوكيّة لا تضارع وجلوته الكسرويّة تبهر الأنظار. حقيقة إنه كان قصرًا مشيّدًا وإيوانًا مجيدًا تعلوه قبّة طول قطر قاعدتها من الداخل يبلغ اثنين وخمسين قدمًا، وقد انهار نصف هذا الإيوان أما ارتفاع القبّة عن الأرض فيناطح السحاب.
ومختصر القول، إن التوفيقات الإلهيّة شملت بعض الإيرانيين السالفين وقيّضت لهم تعمير تخت الملك الذي تهدّم وأعادوا إليه رونقه فأصبح آهلاً بعد أن كان يَبَابًا بَلْقَعًا ولهذا قد هيّأت التأييدات الربانيّة الأسباب لدفن هذا الجسد المقدّس في تلك البقعة، ولا مِراء في أن ستصبح تلك البقعة مدينة عظيمة الشهرة، وترونني كثيرًا ما كتبت في هذا الصدد، إلى أن دُفِنَتْ هناك تلك الرفات المطهّرة وكانت رسائل جناب السيد أسدالله تأتيني من البصرة وكنت أجيب عنها بكل سرعة ممكنة، وقد كان في البصرة شخص من المأمورين له معنا رابطة صداقة كليّة فكنت أكتب إليه ليمدّ يد المساعدة لحضرة السيد أسدالله ويسهّل له الأمور. هذا وقد وردتني رسالة من السيد أسدالله وهو في بغداد يُظهر فيها حيرته في أمره وأين يدفن الرفات، وقال إنه يتوقع أن القوم إذا عرفوا مكان القبر ينبشونه ويخرجون الجثة، ولكن الله سلّم وكانت العاقبة (والحمد لله) على ما يرام ودُفنت الجثة في المكان المشار إليه وإن هذا المكان نفسه قد تشرّف لمرّات عديدة بقدوم الجمال المبارك وقد نزلت فيه ألواح مباركة، وكان يأتي أحباء بغداد في معيّة حضرته إلى ذلك الموقع الذي استقرّ فيه ذلك الجسد المطهر وهذه العناية لم تكن إلا لِمَا كان عليه جناب الأفنان من الخلوص وإلا لم يتم الأمر كما ذكرنا أبدًا، "ولله أسباب السموات والأرض".
لقد كنت أحبّ حضرة الأفنان حبًا جمًا، وكان سروري منه لا
يقدّر. وقد كتبتُ بشأنه زيارة تتلى على قبره المطهّر عند زيارته وأرسلتها مع مكاتيب أخرى إلى إيران.
إن البقعة التي ووري فيها ذلك الجسد المطهّر لَمِنَ البقاع المقدّسة، ويجب أن يشيّد فيها مشرق الأذكار فسيح الأرجاء وإذا أمكن فليعمّر إيوان كسرى بقبّته الشاهقة ويُتّخذ مشرقًا للأذكار تحيط به منشئات مشرق الأذكار من مستشفى للمرضى ومدارس متنوّعة ودار الفنون ومكاتب أوليّة وابتدائيّة وملجأ للفقراء والضّعفاء وآخر للأيتام والعجزة ودار ضيافة للمسافرين وما إلى ذلك.
سبحان الله! إن إيوان كسرى الذي كان في نهاية الزّينة مزركشةٌ جدرانه بالذهب الإبريز قد تبدل كل ذلك بطبقات من نسيج العناكب وحلّ نعيق الغربان في أركانه محلّ النغمات الموسيقى السلطانيّة مصداق ما تفضّل به جمال القدم جل ذكره بقوله تعالى: "كأنّها دار حكومة الصدى لا يُسمع في أرجائها إلى صوت ترجيعه". كانت القشلة (الثكنة المتّخذة معتقلاً) في مدينة عكاء على المنوال السابق عندما دخلناها، وكان في فناء المعتقل بعض شجيرات يأوي إليها البوم التي يصمّ نعيبها الآذان طوال الليل وفي الحقيقة إن صوتها كان مزعجًا للغاية يؤثّر في صماخ الآذان.
وأيم الحق، إن ذلك الفرع المقدّس جناب الأفنان المذكور استمرّ كامل أيام شبابه مستنيرًا مضيء الطلعة وضّاحًا كالشمعة الموقدة بين بني جلدته إلى أن حان حينه فطار إلى الأفق العزة الأبدية واستغرق في بحر الأنوار. عليه نفحات ربه الرحمن وعليه الرحمة والرضوان مستغرقًا في بحر الرحمة والغفران.
(6) حضرة الحاج ميرزا حسن أفنانإن الحاج ميرزا حسن الأفنان الكبير كان من أعاظم المهاجرين والمجاورين. قد فاز في أواخر أيامه بشرف الهجرة وتوفّق بالآقامة بجوار العناية الربانيّة. أمّا نسبه فيعود إلى النقطة الأولى، روحي له الفداء. وقد نصّ القلم الأعلى على أنّه من أفنان السدرة المباركة وكان له النصيب الوافر بأن رضع، وهو طفل في سن الرضاع، من ثدي عناية حضرة الأعلى وكان تعلقه بذلك الجمال المنير لا يُضارع.
ولما بلغ سن المراهقة، اندمج في صفوف ذوي المدارك العالية وقام بتحصيل العلوم والفنون وكان لا يفتأ ليلاً نهارًا في إشغال الفكر في المسائل الإلهيّة. وقد أخذته الحيرة لمّا شاهد انتشار الآيات الكبرى في الآفاق. تضلّع في العلوم الاكتسابية كالرياضيّات، والهندسة، والجغرافيا، وطال باعه في علوم شتّى وكان كثير الاطلاع واقفًا على آراء السلف والخلف. صرف القليل من أوقات ليله ونهاره في الاشتغال بالتجارة، غير أنه كان يصرف معظم أوقاته في المطالعة والمذاكرة وكان حقًا علامة الآفاق وسبب عزّة أمر الله بين العلماء الأعلام، يحلّ المسائل المعضلة والمشكلة بمختصر العبارات وبمنتهى الإيجاز. وهذا من ضروب الإعجاز.
وقد تعطّرت مشامّه بنفحات الهداية الكبرى في أيام حضرة الأعلى واشتعلت فيه نار المحبّة في أيام المبارك بدرجة أنه قام على إحراق جميع حجبات الأوهام واشتغل بترويج دين الله بكل ما في مكنته واشتهر في جميع الآفاق بمحبّة الجمال المبارك. على حدّ قول القائل (ما ترجمته):
أيها العشق قد تملّك مني من جرّائك جنون وحيرةوبعد صعود حضرة الأعلى، روحي له الفداء، واظب على خدمة حرم ذلك الجمال، جمال الكبرياء ضجيعة حضرة الأعلى الطيّبة الطاهرة وفاز بتوفيق من الله بهذه المنقبة العظمى. وعاش في إيران مغمومًا غارقًا في بحار الحيرة من شدّة فراق حضرة الرحمن، إلى أن فاز سليله الجليل بشرف المصاهرة فدبّت فيه عوامل السرور والحبور والفرح والابتهاج، فترك إيران إلى ظلال عناية حضرة المقصود ومجاورته. كانت محاسن طلعته تفوق الوصف بوجه نوراني وقد شهد الأغيار بأن في وجهه هالة من النور المبين.
ومختصر القول، إنه قد مكث أيامًا في مدينة بيروت وقابل في أثنائها العالم الشهير –الخواجة فنديك- ودارت بينهما مباحثات في مختلف العلوم والفنون مما أدهش الخواجة المذكور حتى صار يتمدّح بأوصاف حضرة الأفنان الكبير ويشيد بعلوّ كعبه في مختلف العلوم والفنون ويعدّد فضائله وكمالاته في الأندية والمحافل والمجتمعات.
وكان يقول على مسمع من الجمهور: "إن جناب الأفنان يندر وجود أمثاله بين المتفنّنين في الشرق". وفي النهاية، عاد حضرته إلى أرض المقصود وسكن في الجوار المبارك وحصر فكره في فضائل الإنسان، وكان يصرف معظم أوقاته مشتغلاً باستكشاف النجوم وحركات الكواكب وكان رفيقه المقراب (أي المنظار) للتطلّع إلى الكواكب في الليل والنهار. كان في حدّ ذاته بحبوحًا مرحًا فارغًا عن الدنيا، وفي غاية من السرور والبشاشة وكان يُقدّر مجاورته لحضرة الأحدية ويعتبرها جوهرة تتلألأ بالنهار وتجعل ليله منيرًا إلى أن وقع صعود حضرة المقصود واضطربت الخواطر وتبدّل الفرح والسرور بآهات الحسرة، وحلّت المصيبة الكبرى واحترقت القلوب من عظم الفراق، واصبغّ بياض النهار بسواد الليل المُدْلَهِمّ، وانقلب صفاء بستان الأوراد إلى هشيم القتاد الذي لا يصلح إلا للنار، وجرت الدموع من الآماق. فأمضى حضرته أيامًا يتقلّب على بساط الاحتراق بنار الفراق ولم يجفّ الدمع الهاطل من عينيه فلم يستطع تحمل ذلك العبء وأَلَمَ الفراق، ففارقت روحه الزكيّة، بعد أيام قلائل، عالم الفناء وسكنت عالم البقاء وفازت بالدخول في جنّة اللّقاء واستغرقت في بحر الأنوار. عليه الرحمة الكبرى، وله الموهبة العظمى، وله البركة على مرّ القرون والأعصار. قبره الشريف في حي المنشيّة بعكاء.
(7) حضرة آقا محمد علي أصفهانيجناب آقا محمد علي أصفهاني، هو من الأحباء الأقدمين الذين اقتبسوا من نار الهدى في أول الأمر، ويعدّ من زمرة العرفاء وكان منزله مجمع العرفاء والحكماء، موصوفًا بعظيم الكرم وعلى خُلُقٍ عظيم محسوبًا في عداد المحترمين في مدينة أصفهان. داره ملجأ ومأوى للغرباء من الأغنياء والفقراء على السواء. وكان من أهل الذوق وحُسْن المَشْرَبْ، حليمًا سليمًا ونديمًا مألوفًا مشهورًا في كل بلد بعيشته الراضية. وبعد أن اهتدى بنور الهدى، اشتعل بالنار الموقدة في شجرة السيناء وأصبح بيته وقفًا للتبليغ ومضافته مركز التمجيد للربّ الكريم، يجتمع عنده الأحباب ليلاً ونهارًا وهو بينهم كالشمعة منيرًا بنار المحبّة المشتعلة في صدره. واستمر بيته مثوًا وحظيرة قدس لترتيل الآيات والبيّنات وبيان الحجج والبراهين الدامغة. ومع ما كان عليه من الشهرة بمعتقده بين أهالي أصفهان فقد أصبح بفضل انتسابه لإمام الجمعة بالمدينة محفوظًا مصونًا من غائلة الأعداء. وبلغ الحال أن إمام الجمعة نفسه من كثرة ضغط الأعداء جاهَرَهُ معتذرًا بأنه لم يعُد في مقدوره المحافظة عليه وحمايته قائلاً: "إنني بعد اليوم لا يمكنني المحافظة عليك وحمايتك لأنك في خطر عظيم، فأولى لك أن تغادر
هذا البلد". فارتحل آقا محمد علي من أصفهان إلى العراق حيث فاز بشرف لقاء محبوب الآفاق، وما لبث أن قَلَبَ له الدهر ظهر المِجَنْ برهة ثم أخذت أحواله تتحسن. وكان يقنع بالقليل غير أنه عاش مسرورًا دمث الأخلاق ليّن العريكة يمازج الأغيار والأحباء على السواء إلى أن بارح الموكب المبارك بغداد إلى اسلامبول فسار بمعية حضرة بهاءالله إلى أدرنه –أرض السر- ولم تتغير حاله أبدًا ومضى بأدرنه متمتعًا بهناءة العيش مشتغلاً بالكسب نوعًا ما محفوفًا بالبركة التي لا تضارع ثم سافر ضمن الركب المبارك إلى قلعة عكاء حيث اعتقل أسيرًا واعتبر من المسجونين كل أيام حياته فائزًا بكمال الشرف في ظل الجمال المبارك.
كان طوال أيامه مسرورًا مبتهجًا مشتغلاً بالتجارة نوعًا ما ومكسبه كان ضئيلاً يصرف نصف نهاره في الاتّجار ويأخذ في النصف الآخر أدوات الشاي ويذهب على ظهر جواد إلى البساتين والحدائق الغلباء أو يتجه إلى الصحراء ويتناول شايه مبتهجًا مسرورًا. فطورًا تراه في المزرعة وطورًا في حديقة الرضوان أو في القصر المبارك فائزًا باللقاء غارقًا في بحار التنعم. وكلما شرب شايًا في القصر المبارك قال: "إنه لذيذ للغاية ورائحته ذكية ولونه جذاب وكان يستطيب الجلوس في الصحراء ومشاهدة الأوراد معجبًا بألوانها المختلفة الجذابة، وكان يقول إن كل شيء له رائحة عطريه حتى ماء الشرب والهواء الذي يستنشقه. وكان مسرورًا في جميع أوقاته بدرجة تفوق الحد والوصف وكان يعتقد أن ملوك العالم لم يتيسر لهم ما كان عليه من الفرح العظيم. ومع بلوغه سن الكبر، كنت تراه فارغ البال مرحًا مسرورًا، لا يأكل إلا من طيب الطعام. عاش في عكاء في هناء وأحسن مقام، ساكنًا
في بيت على حده، ورغم أنه كان مسجونًا فلم يضجر إلى أن عرج إلى أفق العزة الأبدية بعد أن ناهز الثمانين من عمره. ونزلت في حقه ألواح متعددة من القلم الأعلى، وكان مشمولاً دائمًا بالألطاف المتناهية. عليه بهاء الأبهى وعليه آلافٍ من الرحمة والرضوان ومتعه الله بالروح والريحان. أما جدثه المنير ففي عكاء.
(8) جناب آقا عبدالصالح الباغبان (البستاني)من المهاجرين والمجاورين في السجن الأعظم، كان جناب آقا عبدالصالح الباغبان من أولاد أحد قدماء الأحباء، توفي والده ونشأ يتيمًا ولم يكن له من معين. وقع مظلومًا في يد الأعداء حتى بلغ سن الحُلُمْ وعند ذلك طلب وجه المحبوب، فهاجر إلى سجن عكاء وفاز بالاشتغال كبستاني في حديقة الرضوان. وأصبح بستانيًا لا نظير له، متينًا في إيقانه رزينًا صادقًا وأمينًا، وكانت أخلاقه مصداق قوله تعالى: "وإنك لعلى خلق عظيم"، ولهذا كان مسرورًا في عمله كبستاني في حديقة الرضوان. وبهذه الوسيلة تمتّع بشرف اللقاء في أغلب الأيام وشملته الموهبة العظمى لأن الاسم الأعظم، روحي لأحبائه الفداء، كان مسجونًا في قلعة عكاء محاصرًا نحو تسع سنوات مع وجود العساكر وأرباب الأمر في الثكنة بالقلعة وبعد ذلك انتقل الجمال المبارك وسكن في بيت وضيع بعكاء، ولم يضع جمال القدم قدمه خارج ذلك الكوخ الضيق وكان الأعداء والمعرضون يتجسسون عليه وما انقضى الأجل المحتوم بعد السنوات التسع حتى خرج الجمال المبارك بكل عظمة واقتدار من القلعة وسكن خارج عكاء في قصر ملوكي رغم أنوف الأعداء اللدودين، عبدالحميد وأعوانه، الذين أظهروا كمال
الشدّة عليه في السجن ولكن حضرة بهاءالله، روحي لأحبائه الفداء، كان في نهاية العزّة والاقتدار كما يقرّ بذلك العموم. فكان يتنقّل حضرته من القصر إلى المزرعة فإلى حيفا حيث يمضي أيامًا على قمة جبل الكرمل في خيمته الخاصة والأحباء يأتون إلى محضره المبارك من جميع الديار ويفوزون بشرف اللقاء على مرأى من جميع أرباب الحكومة، ولم يقم أحد بالمعارضة وهذا من أعظم معجزات الجمال المبارك، وهو سجين كان يتحرك بكمال العظمة والاقتدار. كانت حياته حياة من كان في الإيوان ونفس السجن أصبح جنة الجنان ولم يحدث مثل هذا في القرون الأولى بمعنى أن شخصًا أسير السجون يترك معتقله بكل قوة واقتدار. ورغم رزوحه تحت السلاسل والأغلال فقد وصل صيت أمر الله إلى فلك الأثير وفتح الكثير من مدائن القلوب في شرق الأرض ومغربها وسخّر الأكوان بحركة من القلم الأعلى وهذا ما امتاز به هذا الظهور العظيم.
وقد حضر ذات يوم إلى القصر المبارك أرباب الحكومة وأمراء المملكة وعلماء المدينة ومشاهير عرفائها ولكن جمال القدم لم يجعل لمجيئهم أهمية ولم يصرح لهم بالورود في ساحته المقدّسة ولم يستفسر عن أحوالهم. أما هذا العبد فقد جلس معهم ساعة من الزمان أو ما يزيد يتحدث معهم حتى استأذنوا بالانصراف ثم قفلوا راجعين.
كان المرسوم الملكي القاضي بسجن الجمال المبارك يحتم بقاء حضرته داخل القلعة في حجرة على انفراد يحيط بها الجند والحراس بحيث لا يضع قدمه خارج تلك الحجرة ولا يقابل أحدًا من الأحباء، ومع هذا التشديد والحكم الصارم كانت خيمة حضرته وسرادقه المبارك منصوبة على جبل الكرمل. فأي قوة وأي قدرة أعظم من
هذا! حيث ارتفع علم الرحمن في غياهب السجن وتموج لواء أمره على أعلى التلال في جميع الآفاق. سبحان من له هذه القدرة والعظمة. سبحان من له العزة والكبرياء. سبحان من له الغلبة على الأعداء وهو في سجن عكاء!
وأيم الحق، إن طالع عبدالصالح المذكور لمرتفع ونجمه لمحظوظ لأنه كان فائزًا باللقاء أعوامًا عدة مستمتعًا بهذه الخدمة. أمضى أيامه متحليًا بالأمانة والديانة والصداقة خاضعًا خاشعًا لدى جميع الأحباء لم يَظهر الكدر من أحد طيلة أيام حياته وفي النهاية انتقل من مجاورة البستان إلى جوار الرحمة الكبرى.
كان جمال القدم عنه راضيًا ونزلت من القلم الأعلى زيارة في حقه، تتلى على قبره، وعدّة ألواح مباركة وخطابات من الفم المبارك له وكل ذلك مدرج في الكتب والألواح. وعليه البهاء الأبهى وعليه الرحمة في الملكوت الأعلى.
(9) جناب الأستاذ إسماعيلمن جملة النفوس المباركة حضرة الأستاذ إسماعيل المعماري، روح المخلصين له الفداء، لقد كان رجل الحق هذا كبير المعماريين لدى أمين الدولة، فرّخ خان، بطهران وكان عزيزًا ذا اعتبار زائد وفي بحبوحة من العيش محترمًا مسرورًا حتى أصبح شخصًا نورانيًا مفتونًا بجمال المحبوب عاشقًا ولهانًا، وأزال بنار العشق كل حجاب وستار متشبثًّا بذيل رداء محبة المحبوب واشتهر في طهران بأنه الركن الركين للبهائيين. وكان أمين الدولة يبذل ما في وسعه للمحافظة على الأستاذ إسماعيل وحمايته في بداية الأمر ولكنه أخيرًا أحضر الأستاذ عنده وقال له: "يا أستاذ أنت عزيز لدي للغاية وقد عملت ما في طاقتي لحمايتك والمحافظة عليك من أعدائك، غير أن الشاه قد وقف على حقيقة أمرك وأنت تعلم مقدار غضبه وميله لسفك الدماء. لهذا أخشى أن يأمر، على حين غرّة، بشنقك، وعليه، أرى من المستحسن أن تبادر بمبارحة هذه الديار إلى ديار أخرى لتخلص من هذا الخطر الداهم". فرضخ الأستاذ لنصيحة أمين الدولة وهاجر إلى العراق، وهو لا يملك شيئًا من حطام الدنيا. ومرّت عليه أيام تقلّب في خلالها على بساط الإفلاس هو وزوجته حديثة الاقتران به، والتي كان متعلقًا بها بدرجة لا توصف.
وما لبث أن جاءت أمّ زوجته إلى العراق وتمكّنت بكل حيلة وتدبير من أخذ ابنتها إلى طهران بصفة مؤقتة برضاء الأستاذ طبعًا، ولما وصلت إلى طهران ذهبت إلى المجتهد وقالت له: "إن زوج ابنتي قد ارتدّ عن دينه، ولذا فقد أصبحت ابنتي محرّمة عليه. فما كان من المجتهد إلا أن أصدر حكمًا بطلاق ابنتها من زوجها، وزوّجها لغيره. وما أن وصل هذا الخبر، إلى الأستاذ إسماعيل، المؤمن الصادق حتى ضحك وقال: "الحمد لله الذي وفّقني على هذه التضحية الطاهرة في سبيله، والآن لم يبق لدي من شيء حتى الزوجة قد ذهبت، لقد وفّقت بهذه التضحية".
ومختصر القول، إن جمال القدم والاسم الأعظم، روحي له الفداء، قد بارح بغداد إلى الروملّي وبقية الأحباء في بغداد إلا أقلهم. فقام عليهم أهالي بغداد وأرسلتهم الحكومة أسرى إلى الموصل، أما الأستاذ إسماعيل الجليل فقد سافر راجلاً، مع وهْن عظمه وكِبر سنه ولا زادٌ ولا مالٌ، إلى السجن الأعظم بعد أن طوى القفار وتسلق الجبال وقطع الوِهاد والوديان وحال وصوله رقم له الجمال الأبهى بعض الأبيات الغزلية من نظم، الملا الرومي، وأمره بأن يتوجه إلى النقطة الأولى، حضرة الأعلى، بتلك الأبيات الغزلية بصوت رخم ولحن بديع. فالأستاذ إطاعة للأمر المبارك، مضى أوقاته مترنّمًا بهذه الأبيات الغزلية (ما ترجمته):
أيها العشق قد تملك مني من جرّائك جنون وحيرةبعد ما كنت أول العارفين بل ممن محى في المعارف عمره
أيها الخمر الذي لا أرتضيه للمبيع مرة إثر مرةأنت ضارب الناي في كل حين بنعمة كلحن الحبيب في كل فتره
وإذا ابتغيت تنفسًا في حياتي فهاكني منذ قرن ميت بالمره
وأنت روح المسيح حيٌّ فحيٌّ وهو روح الحياة إذ ليس غيره
أولٌ أنت وآخرُ بل وظاهر أنت وباطن جلّ سترهنعم، إن هذا الطير مكسور القوادم والخوافي قد اشتغل بهذا اللحن البديع وقصد مقر المحبوب. ولما فاز بشرف اللقاء في القلعة عدّة أيام، صدر الأمر المبارك له بالسكن بلدة حيفا. فذهب إليها ولم يجد مسكنًا ولا مأوىً يقيه برد الشتاء وقيظ الشمس فسكن في مغارة خارج المدينة فريدًا وحيدًا بلا أنيس ولا صديق. وهيّأ عددًا من الخواتم وبعض الأواني الخزفية والأبر والدبابيس وما إلى ذلك، وصار يحوم بها في الطرقات طول النهار قصد بيع شيء منها، وكان محصلة ما يبيع مبلغًا زهيدًا لا يتجاوز القرشين في اليوم الواحد وطورًا أقل من ذلك وطورًا أكثر بقليل. ثم يعود إلى الكهف قانعًا بكِسرة من الخبز يسدّ بها رمقه ثم يأخذ في التسبيح والتهليل وتقديس الرب الودود شاكرًا ربّه على هذه النعمة ويقول: "الحمد لله الذي جعلني فائزًا بهذه النعمة وقد أصبحت مقطوعًا عن المعارف والأقرباء وآقامني ربي في هذه المغارة الصغيرة وجعلني ممن يشرون يوسف الإلهي. ما أعظم هذه النعمة!".
ثم إنه صعد وهو على هذا الحال إلى جوار الربّ المتعال. وطالما أظهر جمال القدم رضاه في حقّه وكان على الدوام مشمولاً بالألطاف المباركة ملحوظًا بلحظات عين الكبرياء. عليه التحية والثناء وعليه البهاء الأبهى.
(10)حضرة النّبيل الجليل، كان من المهاجرين والمجاورين. ترك هذا الشخص المحترم أهله وخلاّنه وبارح، وهو في عنفوان الشباب، مدينة زرند، ورفع بعون الحضرة الإلهية علم الهداية حتى أصبح قائد العاشقين وسيّد الطالبين. وألقى عصاه في العراق العربي بعد أن قضى ردحًا من الزمن في العراق العجمي، غير أنه لم يعثر على بغيته لأن حضرة المقصود كان إذ ذاك في كردستان، مقيمًا في مغارة على جبل سرگلو، فريدًا وحيدًا تفيض من خلوته أنوار عشق جماله على البرايا ولا أنيس له ولا حبيب ولا جليس ولا سمير. انقطعت عنه الأخبار بالكلية، وابتلى العراق بالخسوف والاحتراق من فراق نيّر الآفاق.
ولما رأى جناب النبيل أن النار الموقدة في القلوب قد خمدت ولم يبق من الأحباء إلا عدد معدود ويحي (الأزل) مختفيًا في حفرة الجفاء واستولى على الجميع عامل الخمود والجمود، اضطُرّ إلى الذهاب إلى كربلاء، حيث آقام وهو في حالة من الكرب والابتلاء، إلى أن عاد جمال القدم من كردستان (السليمانية) إلى دار السلام، فدبّت روح جديدة ووجدان عظيم وطرب لا حدّ له في الأحباء بالعراق وبينهم النبيل الجليل الذي أسرع إلى الحضور المبارك ونال نصيبًا موفورًا عدّة
أيام أمضاها في سرور وحبور وابتهاج، ونظم إبانها القصائد الرنانة في المحامد الربانية. كان فكره سيالاً وقريحته وقّادة وفصاحة لسانه تبهر الألباب. واستمر على حالة سروره وابتهاجه مدّة، ثم عاد إلى كربلاء ومنها إلى بغداد فإلى إيران حيث وقع في مخالب الامتحانات والافتتانات الشديدة من مخالطته بالسيد محمد. غير أنه كان بمثابة النجم لرجم شياطين الأوهام، وكالشهاب الثاقب غالبًا على أهل الوساوس، ثم عاد إلى بغداد مرة أخرى واستظلَّ في ظلال الشجرة المباركة حتى صدر الأمر المبارك بسفره إلى كرمانشاه في مأمورية عظيمة. فقام بما أمر به، ثم أخذ يسافر من إيران إلى العراق وهكذا دواليك، إلى أن تحرّك الرّكب المبارك من دار السلام إلى مدينة الإسلام (اسلامبول).
أما حضرة النبيل فقد تزيّا بزي درويش بعد سفر الجمال المبارك وجدّ في السير راجلاً حتى التحق بالموكب المقدّس، وفي اسلامبول أمره الحضرة بالعودة إلى إيران للاشتغال بتبليغ أمر الله وكان كلما دخل قرية في طريقه أبلغ الأحباء بكل ما وقع. وبعد أن أدّى المأمورية التي كلّف بها على وجه أتم حلّت سنة الثمانين التي ارتفع فيها صوت ناقور (ألسْتُ) فهرول مسرعًا وهو يقول: بلى! بلى! لبيك! لبيك! إلى أرض السر(أدرنه) مع من ترنّحوا بتلك النغمة وفاز باللقاء واحتسى صهباء الوفاء. ثم سافر حسب الأمر المبارك إلى كل حدب وصوب لينادي بظهور حضرة الربّ القيوم في كل صقعٍ ونادٍ ويبشّر الناس بطلوع شمس الحقيقة. فكان النبيل الجليل في هذا السبيل شعلة وقّادة وفائرة عشق لا تطفأ وكان يجوس خلال الديار بنهاية الانجذاب ويهدي القلوب روحًا موفورة بالبشارة الكبرى وكان يضيء في كل حفل
كالشمعة المنيرة مشارًا إليه بالبنان ماسكًا في قبضته جام خمر المحبّة وسقى منه المعاندين حتى ثملوا ثم قطع وعثاء الطريق بقدم ثابت وهو يضرب طبله ومزماره الروحي حتى بلغ السجن الأعظم.
كانت أيام وروده أيام شداد والضيق مستحكِمًا والأبواب مسدودة والطرق مقطوعة. وصل إلى باب مدينة عكاء متزيّيًا بزي شخص بخاري. وإذا بالسيد محمد (الأزلي) ورفيقه عديم التوفيق يخبرا الحراس والشرطة بوروده وقاما بالسعاية في حقه وقالا: "إن هذا الشخص ليس ببخاري بل إيراني أتى إلى هنا لمحض الوقوف على أخبار الجمال المبارك. فما كان من البوليس إلا أن أخرجوه فورًا. ولما خاب أمله ذهب إلى قصبة صفد (في شمال فلسطين) ثم ذهب إلى حيفا وآوى إلى مغارة في جبل الكرمل في عزلة عن الأحباء والأغيار مشتغلاً بالعبادة وتلاوة الأنجية ليل نهار، واعتكف هناك مدة في انتظار فتح باب التشرف واللقاء. وإذا بميقات السجن المحتوم قد انقضى وتجلّى بهاء مظلوم الآفاق بكمال الاقتدار وفتحت الأبواب، فهرع جناب النبيل الجليل إلى الحضور بصدر منشرح مضيئًا كالشمعة المشتعلة بنار محبة الله، يَنْظُمْ المقطوعات الغزلية آناء الليل وأطراف النهار، ويتبعها بالقصائد الرنانة والخماسيات والسداسيات الشعرية في محامد محبوب قلوب العالمين والمنتسبين إلى ذلك المقام. يحظى بالتشرف والمثول بين يدي الحضرة في أغلب الأيام إلى أن وقع الصعود المبارك فتزلزلت أركانه من هذه الرزيّة العظمى بدرجة أسالت من عينيه الدموع وأرجفت منه الضلوع، ووصل نحيبه وتأوّهه إلى الأوج الأعلى وطابق هذه المصيبة الكبرى بالسنين الشداد. وقد تحقق ذلك لأن حضرة المقصود قد أخبر عن هذه الوقائع.
ومختصر القول، إن النبيل الجليل قد اكتوى بنار الحرمان
والهجران وكانت الدموع تتدفق من آماقه كالسيل المنهمر مما أدهش الناظرين، واستوجب حيرة الجميع. كان يحترق ويحرق القلوب ضاربًا على ناي التضحية والفداء بالروح، حتى ناء بحمل هذه الوطأة وعيل صبره والتهبت في صدره جذوة من نيران العشق ولم يعد في قوس صبره من مِنزَع، فأصبح قائد العشاق وولى وجهه نحو البحر دون محاباة وأشار إلى تاريخ وفاته بكلمة "غريق" (وهي تعادل في حساب الجمّل 1310) قبل أن يضحّي بروحه التي أسلمها لبارئها وتخلّص من آلام الهجران والحرمان.
كان هذا الشخص علاّمة فهّامة، فصيحًا بليغًا، ناطقًا ومفوهًا، قريحته كانت صريحة ملهمة، وطبعه جذّابًا، وشِعره كالماء الزلال، كما يظهر من قصيدته (بهاء بهاء) المدلّة على أنه كان في حالة الانجذاب عندما نسج بُردها. كرّس النبيل الزرندي حياته منذ صباه إلى أن ابيضّ فرداه ووهن العظم منه للعبودية وخدمة حضرة الرحمن. تحمّل الصعاب والمشاق، وخاض غمار المتاعب والمشقات، وسمع من الفم الأطهر المبارك بدائع الكلمات، وشاهد تجلي ملكوت الأنوار، وفاز بكل ما تمنّى. وفي النهاية لم يعد يطيق الحياة بعد فراق نيّر الآفاق فألقى بنفسه في اليمّ وأصبح غريق بحر الفداء، وصعدت روحه إلى الرفيق الأعلى. عليه التحية الوفيّة، وعليه الرحمة الواسعة، وله الفوز العظيم والفيض المبين في ملكوت رب العالمين.
(11)من جملة المهاجرين والمجاورين والمسجونين، جناب آقا صدق علي، كان درويشًا حرًا، لا أهل له ولا أقرباء، سالكًا سبيل العارفين بالله، ومن الأدباء المعروفين. مرّت عليه أيام عانى فيها عوامل الفقر المدقع سائرًا على نمط الطريقة التي شرب خمرها. ولما كان من أهل التصوف كان يصرف أوقاته في تدخين الحشيش الأغبر الممقوت لعلّه ينال التزكية والخلوص بين معشر المتصوفين، وكان يبحث وينقّب عن الحق. طبعه الشعري في سبيل الحق كان في غاية السلاسة، نظم القصائد الغرّاء في محامد مظلوم الآفاق، وكان بيت القصيد في الخريدة التي نظم عقدها وهو سجين بالمعتقل ما معناه (مترجم):
لو بعّد الظلام الحالك خُصلاً من شعرك المسدول في ألف قلب
لترامت القلوب إثر القلوب إذا تموّج الشعر في أي درب
عاش حرًا طليقًا في بغداد وتقلّد وسام المحبوب اللاوسام وحظي بمشاهدة طلوع نيّر الآفاق من أفق العراق، ونال نصيبًا موفورًا من فيض الإشراق حتى أصبح مفتونَ محبوب الآفاق ومحبوبَ طلعة المحبوب المشفق الكريم. ولو أنه في بعض الأحيان كان ساكتًا صامتًا إلا أنّ كل جوارحه كانت السُنًا ناطقة بالبيانات الفائقة.
ولما حان تحرك الركب المبارك من دار السلام، أسرع متلهِّفًا وتمنى أن يكون سائسًا لجواد جمال القدم فتمّ له ذلك. وكان يسير مع القافلة طوال اليوم راجلاً ومهرولاً، وفي الليل يقوم بطُمار الخيل بكل روح وريحان ولا يهجع إلا بعد منتصف الليل، منكمشًا تحت لحاف رقيق. وكان لا يفتأ يقرض الشعر في الطريق، ويترنم بالمقطوعات الغزلية بولهٍ زائد مما جلب سرور الأحباء والأصحاب. حقًا إنه كان وصفًا من اسمه وهو الصدق المحض والحب الخالص والروح الطاهرة ومفتون الإيمان بالمحبوب. وكان يفتخر، وهو في هذا المنصب العالي، يعني العظمة الملوكية الحقة، على سلطنة العالم، عاكفًا ما دام على العتبة المقدّسة في مقدمة الأحباء الصادقين حتى وصلت قافلة مليك العشق إلى اسلامبول فإلى سجن عكاء بعد أدرنه. وكان جناب صدق علي هذا، في جميع المراحل لا يفارق الركب المبارك، مستقيمًا في إيمانه، وعظيم الإيقان في معتقده. ونزل ذات ليلة في المعتقل من القلم الأعلى خصيصًا باسم "صدق علي" قوله تعالى:
"على الدراويش أن يعقدوا مجلسًا في مثل هذه الليلة من كل عام، ويزيّنوا المكان بأنواع الأوراد والأزاهر المختلفة ألوانها، ويشتغلوا بذكر الحق سبحانه. ثم بيّن حضرته حقيقة الدراويش، بأنهم هم الأشخاص الذين يطوفون العالم غير طائشين وغير سلاّبين. والمراد هم النفوس المنقطعة عما سوى الله، المتمسكة بشريعة الله، الثابتة في دين الله، الراسخة على ميثاق الله، القائمة على العبودية لله، ولهم القدم الراسخ في العبادة لا على الطريقة المصطلح عليها بين أهل إيران وهي طريقة الحيرة والارتباك والهجوم على الغير والسير في طريق اللادينيين".
وبالإجمال، إن هذا الدرويش صاحب المقام الرفيع مضّى كل أيام
حياته في ظل عناية الواحد الأحد، منقطعًا عما سوى الله، مواظبًا على خدمة عباد الله بكل سرور وارتياح. وفضلاً عن خدمته للجميع، كان قائماُ على عبودية العتبة المقدّسة، إلى أن خلع قميص الوجود وهو في جوار الرب الودود وغاب عن الأبصار. غير أنه كان منظورًا بالبصيرة الخفية، وجلس على سرير العزّة الأبديّة وتخلّص من أسر هذا العالم العنصري، ونصب خيمته في العالم الوسيع غير المحدود. زاده الله قربًا ووصالاً، ورزقه الله المشاهدة واللقاء في عالم الأسرار مستغرقًا في بحر الأنوار. وعليه بهاءالله الأبهى. أما قبره المنور ففي عكاء.
(12)من جملة المهاجرين والمجاورين والمسجونين، جناب آقا ميرزا محمود من أهالي كاشان، عليه بهاءالله الأبهى، وجناب آقا رضا من أهالي شيراز. كان هذان الشخصان المباركان شمعتي محبة الله المشتعلتين بدُهن معرفة الله، وُفِّقا منذ طفولتهما على القيام بالخدمات المتنوعة في ظل العناية الإلهيّة مدة خمسة وخمسين عامًا. إن القلم يعجز عن حصر الخدمات التي قاما بتأديتها وتقريرها. ولما تحرك الموكب المبارك من بغداد قاصدًا اسلامبول، كان في المعيّة المباركة جمع غفير من الأصحاب وكان غلاء المعيشة شيئًا لا يطاق، والقحط في الطريق ضاربًا أطنابه، فوقع أفراد القافلة في حيرة ولكن الشخصين المذكورين كانا يقطعان مسافة لا تقل عن سبعة أو ثمانية فراسخ كل يوم لشراء ما يسدّ رمق الأصحاب، غير مبالييْن بالرمضاء ووعثاء الطريق، سائرين على الأقدام، ثم يعودان إلى الركب وقد أنهكهما التعب، ويسرعان على الفور بطهي الطعام وإعداده مما أدّى إلى راحة الأحباء، وحقًا إنهما كانا يتحملان المشاق الجسيمة في هذا السبيل، وكانت عيونهما في بعض الأيام لا تذوق طعم النوم أكثر من ساعتين أو ثلاث في الأربع وعشرين ساعة، لأنهما كانا بعد أن يتناول
الجميع طعامهم، يباشران في غسل الصحون وما إليها من أدوات الطبخ حتى منتصف الليل، ثم يناما إلى طلوع النهار، ثم يجمعان الصحون والأدوات ويحزمانها ويسيران بجوار الهودج المبارك.
لاحظوا عِظم الخدمات التي وُفّقا إلى القيام بها، والموهبة التي اختُصّا بها حيث كانا يسيران على الأقدام، بجوار الركب المبارك، المسافات البعيدة من بغداد إلى اسلامبول وكانا سببًا لسرور الأحباء وباعثًا على راحة الجميع وابتهاجهم، وعلى كمال الاستعداد لإحضار كل ما يطلبه كل حبيب.
وبالإجمال، إن آقا رضا وآقا ميرزا محمود كانا من جواهر محبة الله منقطعيْن عما سوى الله، لم يئنّا مما كانا رازحيْن تحته من ثقيل الأعباء وعظيم المتاعب والمشاق، ولم يتكدّر منهما أحد، ناسجيْن على مِنْوَل الصداقة والأمانة في جميع الأحوال، وتشملهما عنايات الجمال المبارك في كل الأحايين، وتراهما على اتصال في المحضر المبارك فائزيْن بالتشرف. وكان الجمال المبارك يُظهر دائمًا الرضا في حقهما.
أما آقا ميرزا محمود، فقد سافر من كاشان إلى بغداد وهو في سن البلوغ، وأما آقا رضا فقد آمن بالظهور في بغداد. كان لهذيْن الحبيبْين حالات عجيبة وكانا يسكنان مع خمسة من الأحباء الأجلاء في غرفة بسيطة للغاية في مدينة بغداد لضيق ذات اليد، وكانت عيشتهم ضنكًا ولكنهم كانوا على درجة من الروحانية لا تُضارع بحيث كانوا يرون أنفسهم أنهم في فردوس الجنان، روح الفرح والسرور سائدة بينهم يسهرون في بعض الليالي مشتغلين بتلاوة الأدعية ويسعون في النهار في طلب الرزق والكسب من الصباح إلى المساء، وكان دخل الواحد منهم في اليوم يتراوح ما بين ربع القرش و نصفه أو ما يقرب من القرش
الواحد. وكانوا يجمعون ما حصلوا عليه طول النهار ويشترون به طعامًا لهم. واتفقوا إن أصاب أحدهم نصف قرش أو قُل ثلاثة أرباع القرش ولم يكسب الآخرون فلسًا، حمدوا ربهم واشتروا بما أصابه ذلك الفرد تمرًا وقنعوا بذلك عشاءً لهم. وكانوا يعيشون بقناعة متناهية فرحين مسرورين غير متأففين من هذا الحال.
وخلاصة القول، إن هذين الشخصين المحترمين أمضيا أيامًا سعيدة في فضائل العالم الإنساني، وكانا من أهل البصيرة والعقل الراجح والأذن الواعية وحلاوة الحديث، وما كان أملهما إلا رضاء المبارك، ويعتبران خدمة العتبة المقدّسة أعظم موهبة وكانا بعد وقوع المصيبة الكبرى، يعني صعود الجمال المبارك، مضيئيْن كالشمع يتمنّيان الانتقال إلى الدار الآخرة. أما ثباتهما على العهد والميثاق فكان عظيمًا، وسعيا بكل ما في مكنتهما في ترويج أمر نيّر الآفاق، واتّخذا عبدالبهاء جليسهما ومؤانسًا لهما ومحلّ اعتمادهما في جميع الأمور. وكانا متواضعيْن خاضعيْن خاشعيْن مبتهليْن، ولم ينبسا ببنت شفه تدلّ على أن لهما كيانًا أو وجودًا، متفانييْن تفانيًا كليًّا إلى أن صعدا إلى ملكوت العزة في غيبة عبدالبهاء عن أرض المقصود. فتأثّرت جدّ التأثر وتحسّرت شديد الحسرة على أنني لم أكن حاضرًا وقت عروجهما إلى الأفق الأعلى ولكنني كنت حاضرًا بالقلب والروح متأثرًا متحسرًا وإن يكن على حسب الظاهر لم يتيسّر لي أن أودعهما الوداع الأخير ولهذا تراني متأثرًا.
عليهما التحية والثناء، وعليهما الرحمة والبهاء وأسكنهما الله في جنة المأوى وظل سدرة المنتهى مستغرقيْن في بحر الأنوار عند ربهم العزيز المختار.
(13)من الذين هاجروا إلى بغداد جناب، پدرجان القزويني، كان هذا الرجل الطاعن في السن عظيم الانجذاب لطلعة المحبوب بولهٍ زائد، وكالوردة المفتحة في بستان محبة الله. ومنذ حضوره إلى بغداد انشغل بالتبتّل والمناجاة ليل نهار. ولو أنه كان يسير على سطح الغبراء كان في الحقيقة يسير في أعلى العليين ممتثلاً بكل خلوص لأمر الله يباشر الكسب والعمل ولقلّة بضاعته كان يتأبط بعضًا من الجوارب ويحوم في الطرقات قصد بيعها، وكان النشالون يسرقونها منه، فاضطرّ إلى حملها فوق كفيّه والسير بها في الشوارع والأزقّة وهو غارق في بحر المناجاة فاقدًا شعوره. وذات يوم وهو في الحالة المذكورة، أخذ النشالون في سرقة الجوارب من فوق كفيه، على عينك يا تاجر، ولغيبوبته في عالم آخر لم يشعر بما يفعلون. كانت له أحوال غريبة، بمعنى أنه كان دائمًا كالسكران المدهوش.
وبالاختصار، إنه قد استمر على هذه الحال زمنًا بالعراق وكان يفوز بشرف اللقاء في أغلب الأيام. أما اسمه الحقيقي "عبدالله" ولقَّبه الأحباء ب پدرجان (الوالد الحنون؟). وحقًا، كان كالأب الشفيق للجميع، ورفّ في النهاية إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر. طيّب الله مضجعه بصيِّب رحمته وشمله بلحاظ أعين رحمانيته. وعليه التحية والثناء.
(14)كان بين الذين هاجروا إلى بغداد، الشيخ صادق اليزدي، وكان هذا الشيخ كالنخلة الباسقة في البستان الإلهي، وكالنجم البارق في أفق محبة الله. هاجر إلى العراق في ظل نيِّر الآفاق، أما انقطاعه وانجذابه فلا حد لهما. كان محبة مجسّمة، وعشقه بارزًا، ولم يتوان عند ذكر الحق طُرفة عين، ولم يدرِ شيئًا عن الدنيا وما فيها غارقًا في بحر التذكر والتبتّل والتضرّع والابتهال في جميع الأوقات، لا يجف دمعه في كثيرٍ من الأحيان. واختصه جمال القدم بعناياته وعطفه حتى أصبح الشيخ عناية مجسمة.
جاءني الخبر يومًا بأن الشيخ في سكرات الموت فأسرعت لعيادته فوجدته في النزع الأخير مما أصابه من شديد المغص المهلك، فتوّجهت إلى ساحة الأقدس (حضرة بهاءالله) وعرضت الأمر على حضرته فتفضل بقوله: "اذهب وضع يدك على موضع المغْص وقل: "يا شافي". فعدت إلى الشيخ مسرعًا وإذا بمكان المغص قد تورّم وبرز الورم كتفاحة صلبة كالحجر، وكان الشيخ يتقلّب ويتلوّى على الأرض كالحيّة دون هوادة. فوضعت يدي، في الحال، فوق ذلك الورم وتوجهت إلى الله متضرعًا وقلت: "يا شافي". فما لبث الشيخ أن انتفض قائمًا وقد زال عنه المغص وتحلّل الورم للتو ثم غاص.
وأيم الله، إن تلك الروح المجسّدة (الشيخ) أمضى أيامه في العراق مبتهجًا إلى أن تحرك الموكب المبارك من العراق. أما هو فقد بقي في العراق امتثالاً للأمر المبارك، وما لبث أن اشتعلت بين ضلوعه نيران محبة الله فجعلته لا يطيق الصبر على البقاء في بغداد بعد رحيل حضرة بهاءالله وما كاد الموكب يصل إلى الموصل حتى همّ الشيخ مسرعًا إثر الموكب المبارك حافي القدمين حاسر الرأس إلى أن أدركته المنيّة في الصحراء ودخل في جوار الرحمة الكبرى. سقاه الله كأسًا مزاجها كافورًا وأنزل على جدثه مطر من الماء الطهور وعطّر ترابه بالمسك الزكيّ في تلك الصحراء وأنزل عليه طبقات من النور.
(15)جناب محمد شاه الملقب بالأمين هو من قدماء أحباء الله عاش كالشارد التائه في بيداء الانجذاب. سمع النداء الإلهي وهو في عنفوان الشباب فتوجه إلى الملكوت الرباني وشق ستار الأوهام حتى وصل إلى مقصود القلب والروح. لم تمنعه شبهات القوم ولا شديد اللوم ولم يحل دون مقصود قلبه من حائل ولم تزلزله عواصف المصائب المتراكمة بل كان في كمال الثبوت والاستقامة. قاوم المعرضين والمعترضين يوم ظهور نور الحقيقة وكلما جدّ هؤلاء في إلقاء الشبهات ازداد هو ثبوتًا واستقامة وكلما أظهروا الشدة في مناوأته وأذاه ثبتت قدماه حتى أصبح مفتون جمال الكبرياء، ومجنون الجمال الأبهى، وفائرة محبة الله، وفوارة معرفة الله، وتملّكت منه شعلة نار العشق حتى أضاعت منه الصبر والاستقرار ولم يعد يتحمل ألم الفراق فبارح ولاية يزد (موطنه) وطوى الفيافي والقفار غير عابئ بوعثاء الطريق والتلال والرمضاء والصحارى من شدة شوقه لاستنشاق نسيم الصبا إلى أن وضع قدمه في رحاب محبوب الأرواح وتخلّص من ألم الفراق وفاز بشرف اللقاء في العراق. ولمّا وجد محبوب الآفاق وحظي بمشاهدة طلعته أخذ بعد ذلك في ترك جميع الأفكار وتخلّص من كل قيد حتى أصبح مظهر
العناية غير المتناهية وآقام عدة أيام بالعراق ثم صدر له الأمر بالعودة إلى إيران حيث أمضى عدة أيام كان إبّانها خير أنيس وجليس للأحباء وأشعلت نفسه الطاهرة نار الحب والانجذاب في قلوب الأحباء وخلق فيهم الوله والشوق اللذين لم يعهدوهما ثم ذهب إلى السجن الأعظم بصحبة جناب ميرزا أبو الحسن الأمين الثاني عليه بهاءالله الأبهى وذاق الأمرّين في تلك الرحلة واحتار في أمره إذ كان دخول السجن أمرًا عسيرًا. وفي النهاية فاز بشرف اللقاء في الحمام الذي كان الجمال المبارك يغتسل فيه. وما أن وقع نظر حضرة الأمين الثاني – ميرزا أبو الحسن- على مظهر الكبرياء في الحمام حتى تأثر واعترته الرعشة وارتعدت فرائصه حتى وقع على أرض الحمام فشجّت رأسه وسال دمه.
وعلى الجملة، إن حضرة أمين المذكور يعني شاه محمد قد فاز بلقب "الأمين" وأصبح مظهر الألطاف اللانهاية وحامل الألواح الإلهية. ثم سافر إلى إيران مرّة أخرى وهو في غاية الوله والانجذاب القلبي والروحي، وقام بما كُلّف به من الخدمات بكمال الأمانة وكانت خدماته ذات قيمة لأنها جلبت الراحة للأحباء. كانت همته لا نظير لها وكان في تأدية الخدمات عديم النظير وظلاً ظليلاً بين الخلق. وانتشر صيت عبوديته للعتبة المقدّسة في كل صقع واشتهر في محافل الأحباء. لم يهدأ دقيقة واحدة ولم يسترح في مضجعه ليلة كاملة وكان في أغلب لياليه لا يلتحف غير السماء وكان في نهاره كالطير الطائر أو كالظبي الشارد مسرعًا في طلب مقام الوحدانية فسُرّ منه جميع الأحباء كل السرور، إذ كان هو بشير السرور للجميع ومدينة الحب والعطف، تائهًا في بادية محبة المحبوب يقطع البراري والوديان والقفار كالريح العاصف لا يستقرّ حتى على أعلى التلال وشامخ الجبال. تراه يومًا في
إقليم بالنهار ويَتَنَوّح ليلاً في مملكة أخرى لا يستقرّ ولا يهدأ، قائمًا على الخدمة إلى أن وقع أسيرًا في يد الأشرار من الأكراد بين البحرين في أذربيجان وقتلوه ظلمًا وعدوانًا لظنّهم أنه أحد أعدائهم أتى من قبيلة معادية لهم. فقضى ذلك الحبيب نحبه شهيدًا مظلومًا. وما أن وصل خبر استشهاده إلى أرض السجن حتى عمّ الحزن الشديد وذرفت عيون المسجونين من الأحباء بدل الدمع دمًا على ذلك الشخص جليل القدر، وظهرت آثار الحزن لدى الساحة المقدّسة فجرى القلم الأعلى بالعناية في حق ذلك الشهيد، شهيد الفيافي والقفار عناية لا نهاية لها فضلاً عمّا بحقه من الألواح التي نزلت باسمه. والآن هو في جوار الرحمة الكبرى في جنة الأبهى مع طيور القدس في صحبة وابتهاج، غريقًا في محفل تجلّي الأنوار. عليه التحية والثناء وعليه البهاء الأبهى وعليه الرحمة الكبرى.
(16)جناب مشهدي فتّاح، عليه بهاءالله الأبهى، كان روحًا مجسّدة من الزهد ومثالاً للتقوى، كان هو وأخوه جناب الحاج عسكر لا يميّز أحدهما عن الآخر لتوافقهما في الشكل والأطوار وعلى اتفاق واحد في شريعة الله. كانا ملتحميْن ببعضهما كالجوزاء في نقطة واحدة، وقد استنارا معًا بنور الهداية، وفضلاً عن تشابههما في الأطوار كانا شريكيْن في الإيمان وشبيهيْن في الوجدان، كما كانا في مسيرهما من أذربيجان إلى أرض السّرّ كشخص واحد في جميع المراتب والشؤون متشابهيْن في المشارب والسلوك والمذهب والأخلاق والأطوار والإيمان والإيقان والعرفان والاطمئنان. وكانا ملازميْن لبعضهما في السجن الأعظم.
كان لمشهدي فتّاح مبلغ من المال قد عاد إليه من التجارة لا يملك غيره، ولما بارح أرض السر أودعه لدى بعضهم بصفة أمانة. وبعد مدة وجيزة، نهب بعض من عديمي الإنصاف هذا المبلغ وضاع بالكليّة، فأصبح صفر اليديْن، غير أنه كان محترمًا وفي سبيل الله محبوبًا للغاية، ورضي بالقناعة المتناهية إبان وجوده في السجن الأعظم، فانيًا نفسه، ولم تسمع منه كلمة تدلّ على أن له وجودًا بالمرة، وكان دائمًا منزويًا في ركن من أركان السجن لا تسمع له همسًا ولا لمسًا، عاكفًا
على ذكر الله مستمرًا على حالة التذكر والتضرع إلى أن وقعت المصيبة الكبرى فخارت قواه ووهن عظمه، ولم يعد يقوَى على تحمّل وطأة الفراق من شدّة حزنه وما ألمّ به من فراق المحبوب. إلى أن دنا حينه بعد الصعود المبارك فعرج إلى الملكوت الأبهى. طوبى له ثم طوبى! بشرى له ثم بشرى! وعليه البهاء الأبهى.
(17)جناب نبيل قائن (القائني)، هو الملا محمد علي، عليه بهاءالله الأبهى. كان هذا الشخص العظيم من المنجذبين إلى الجمال المبارك من قبل طلوع صبح الهدى أي من قبل ظهور النقطة الأولى، روحي له الفداء، وشرب صهباء العرفان من يد ساقي العناية؛ وتفصيل ذلك هو أن أحد الأمراء، نجل أمير قائن المدعو مير أسدالله خان، كان مقيمًا في طهران بصفة رهينة سياسية وأنيط بالمحافظة عليه وتهذيبه إلى جناب الملا محمد علي (نبيل قائن)، لأن هذا الأمير كان شابًا بعيدًا عن والده العطوف عليه. ولكونه أميرًا غريبًا في طهران، كان الجمال المبارك يبذل كمال العناية في حقه. وكان هذا الأمير ينزل في أغلب الأحايين ضيفًا على الجمال المبارك برفقة جناب ملا محمد علي الملقب بنبيل قائن وذلك قبل ظهور النقطة الأولى (الباب). وكان النبيل المذكور في مقدمة الثقات وسيّدهم وقد انجذب في ذلك الحين إلى الجمال المبارك كل الانجذاب. وكان في كل محفل أو مجلس لسانًا ناطقًا بمحامد الجمال المبارك مُظهرًا كمال محبته وولهه وتعشّقه لحضرته، وكان يروي على حسب العادة القديمة الكرامات العظيمة للجمال المبارك حتى أنه كان يقول أنه رآها بأمّ عينيه وسمعها بأذنه.
وبالاختصار كان شغفه وولهه لا حدّ لهما، محترقًا بنار العشق احترآقا لا يوصف. رجع وهو على هذه الحالة مع الأمير إلى قائن، وما لبث أن التقى بجناب الفاضل الجليل النبيل الأكبر، وهو جناب آقا محمد القائني، روح المخلصين له الفداء، الذي عاد إلى إيران بعد أن نال إجازة الاجتهاد من المرحوم الشيخ مرتضى، واشتعاله بنار محبة الله في بغداد. ولمّا شاهد نبيل قائن، أن النبيل الأكبر قد جمع العلماء ومشاهير المجتهدين وانساب لسانه بالتبليغ في قائن أمام الذين يقرّون بفضله وتمكّنه من مختلف الفنون والعلوم، وبمجرّد سماعه اسم حضرة الأعلى (الباب) انجذب إليه وقال، إنه قد فاز بلقاء الجمال المبارك في طهران وإنه اشتعل بنار محبته لأول وهلة.
وبالإجمال، كان لهذا الشخص المحترم مقام العلوية السماوية، والموهبة الربانية، وانساب من فمه سيل الهداية في قريته وهدى أفراد أسرته رافعًا علم التبليغ وهداية النفوس. وقد ورد على يديه جمّ غفير إلى شريعة محبة الله، وأعطى الناس نصيبهم من الهداية الكبرى. وكان المير علم خان، حاكم قائن، يُظهر له دائمًا كمال المحبة وقد قدّم له خدمات فائقة بكل أمانة واحترام، غير أنه انقلب في نهاية الأمر وقلب ظهر المجن بعد أن تأكد من إيمان نبيل قائن وإيقانه وقام بالإغارة على الأحباء ونهب أمتعتهم وسلب أموالهم لخوفه من ناصر الدين شاه وأخرج جناب النبيل الأكبر وأهان جناب نبيل قائن وآذاه وبعد سلب أمواله وأمتعته وحبسه دفع به إلى الصحراء يتخبط في الوهاد والفيافي والقفار.
أما هذا الشخص النوراني، فقد عدّ ما حاق به من البلايا سرورًا وبهجة واعتبر نهب أمتعته وسلب أمواله كأنه مَلَكَ الدنيا وما فيها (يعني
أنه فقد الفاني وتمسّك بالباقي) وعدّ حبسه راحة، ودَفْعه إلى بطن الصحراء بهجة وسرورًا وأعظم موهبة ربانية. ووصل إلى طهران حيث أمضى مدة في حيرة في الظاهر لا مال ولا متاع، ولكنه في الباطن كان في نهاية الروح والريحان. وهذا شأن كل نفس ثبتت على الميثاق. كان يزور محافل الأكابر والأعيان، ولما كان على بيّنة من أحوال الأمراء أخذ في مقابلتهم والتحدث إليهم ويلقي عليهم ما يناسب المقام، وكان يُسلّي الأحباء، وكان كالسيف المسلول في وجه كل من أراد بالجمال المبارك سوءًا. لقد كان حقًا مصداق قوله تعالى في القرآن الشريف: "لا تأخذه في الله لومة لائم". واستمرّ على نشر النفحات وانتشار الآيات البينات بكل ما أوتي من قوة، ثملاً من سلافة خمر محبة الله، زاخرًا كالخضمّ الموّاج، هاطلاً كالسحاب المدرار.
نسج على هذا المنوال إلى أن أتاه الإذن بالحضور إلى السجن الأعظم بعد أن اتّهمه أهل طهران بالجنون وخلع عذار الحياء حيث كان دائمًا قلقًا لا يعرف للصبر مسلكًا ولا للأناة موردًا ولا للمحاباة والمداراة محلاً، لهذا لم يدبّ في روعه خوف ولا هلع مع عظيم الخطر الذي كان فيه. وما أن وصل إلى السجن (عكاء) حتى أخرجه الأعداء من أولي الأمر وذهبت كل مساعيه للبقاء هناك أدراج الرياح، فأجبره الحال إلى الارتحال إلى بلدة الناصرة حيث آقام عدة أيام كالطائر الشريد هو وولداه، آقا غلام حسين وآقا علي أكبر، وقاسوا ما قاسوا دائبين على التضرّع والابتهال إلى العلي المتعال حتى تدبّروا أمر دخوله السجن (عكاء) وصدر له الإذن بالحضور. فما لبث أن هرع إلى السجن باشتياق بالغ، وفاز بشرف اللقاء. وما أن وصل إلى الساحة المقدّسة ووقع بصره على طلعة الجمال الأبهى حتى أخذته رعدة ووقع مغشيًّا
عليه وما وعى ونهض إلا بعد أن صدرت العناية المباركة في حقه.
آقام نبيل قائن في القلعة مخفيًا عدة أيام ثم عاد إلى الناصرة التي أخذ أهلها العجب والاندهاش من حالته وعزّة نفسه، فجزموا بأنه شخص جليل من ذوي البيوتات الأعزاء في أوطانهم، ومن الناس عديمي المثال، واستغربوا اختياره الآقامة بالناصرة ورضاءه بالمعيشة الضنكة والتقشّف الذي لا يحتمل.
وبالاختصار، إنه بعد أن تمّ ما وعد به الاسم الأعظم (جمال القدم) فتحت أبواب السجن وأصبح دخول الأحباء والمسافرين إلى داخل القلعة (المعتقل بها الجمال المبارك) والخروج منها متيّسرًا للغاية. أما جناب نبيل قائن فكان يحضر من الناصرة مرّة في الشهر ويفوز بشرف اللقاء. واستمرّت آقامته بالناصرة حسب الأمر المبارك وتمكّن من تبليغ نفر من المسيحيين من سكان الناصرة، وكانت دموعه لا تجف من البكاء على ما نزل بالجمال المبارك من ظلم الظالمين، وكان يدبّر أمر معيشته من الربح القليل الناتج من شركة تجارية بيني وبينه، فقد وضعتُ نصف رأس مال هذه الشركة؛ ثلاثة قرانات (عملة إيرانية تعادل كلها ما يقرب ال 150 مليما)، ووضع هو نفس المبلغ. واشترى برأس المال إبرًا للخياطة وجال بها في الطرقات، فكانت نساء الناصرة يشترين منه الإبر ويعطينه مقابل الثمن بيضًا؛ يعني يعطينه بيضة واحدة عن كل ثلاث إبر، ثم يبيع هو بدوره البيض ويشتري بالربح قوت يومه. وكلما فرغت الإبر، أرسل إلى جناب آقا رضا قناد التاجر في عكاء، ليشتري له إبرًا ويرسلها بواسطة القوافل التي كانت متواصلة الذهاب والإياب بين عكاء والناصرة.
سبحان الله! إن هذا الشخص كان يعيش من ربح رأس المال
الزهيد هذا مدة عامين كاملين حامدًا وشاكرًا لله عز وجل. فانظروا كيف كان قنوعًا بدرجة جعلت أهالي الناصرة يعتقدون أنه غير محتاج لأحد وظنّوا أنه من ذوي الثراء ويمارس القناعة والتقشّّف خوف نفاد ما لديه من المال وهو في الغربة ويخفي ثروته تحت ستار الاشتغال ببيع الإبر.
كان كلمّا تشرف بالحضور المبارك تَصْدُر في حقه عنايات جديدة، وقد اتّخذه هذا العبد (حضرة عبدالبهاء) مؤنسًا ونديمًا له في الغدوّ والرواح. وكلّما كانت تنهال عليّ الأحزان كنت أستحضره وبمجرد وقوع نظري عليه يتملّكني السرور. كان حلو الحديث لطيف المشرب هشًا بشًا فارغ القلب محررًا من كل قيد وعلى استعداد تام لمساعدة من يريد. وفي النهاية، سكن في السجن الأعظم (عكاء) فتيسّر له التشرّف بلقاء الجمال المبارك كل يوم حتى أنّه بينما هو سائر مع بعض الأحباء إذ التقى بالتُّرَبيّ المدعو الحاج أحمد وقال له: "اصحبني" فمشى وتبعه التُّرَبِي ومرافقوه إلى جبّانة النبي صالح (خارج عكاء) فالتفت إلى التُّرَبيّ بوجه مبتسم وهو في كمال الصحة والعافية وقال: "يا حاج أحمد، أريد منك شيئًا واحدًا وهو، حيث أنني سأنتقل من هذا العالم إلى العالم الآخر، أرجوك أن تجعل قبري في هذه النقطة (مشيرًا إلى جوار القبر الذي دفن فيه حضرة الغصن الأطهر) وهذا كل ما أريده منك"، ثم ناول التربي بعض الدراهم وانصرف. وما غربت شمس ذلك اليوم حتى أخبرني بعض الأحباء: إن نبيل قائن مريض. فذهب هذا العبد توًا إلى داره فوجدته جالسًا يتحدث مبتهجًا مسرورًا يقرأ ويمازح غير أن جبينه كان يتفصد عرقًا بشدة متناهية، ولم تظهر عليه علامات التوعّك بالمرة. وما زال العرق يتفصد من جبينه حتى خارت
قواه فاستلقى على الفراش حتى تنفّس الصبح ففاضت روحه الزكية إلى حيث تُعطَى الثواب، ولما وصل خبر وفاته إلى المحضر المبارك أظهر في حقه عنايات لا تحصى وقد أَنزل باسم هذا الشخص في أيام حياته ألواحًا شتّى. وكثيرًا ما ذكر الجمال المبارك اسم نبيل قائن بعد وفاته عند كل مناسبة وكان حضرته يذكر إيمانه وإيقانه وانجذابه بمعنى أن هذا الشخص كان منجذبًا بنفحات الله قبل ظهور حضرة الأعلى، روحي له الفداء. طوبى له وحسن مآب! بشرى له من هذه الموهبة الكبرى! ويختص الله بفضله من يشاء.
(18)وصل عَرف النّفحة الرحمانية إلى مشام حضرة السيد تقي المنشادي وهو في عنفوان شبابه في قرية منشاد، فأصبح روحانيًا صرفًا. كل أفكاره ربانية وقلبه نوراني وشملته التوفيقات السبحانية، وخلق فيه النداء السماوي عظيم الوله والطرب حتى ساقه ذلك إلى هجر مسقط رأسه وتَرْك أملاكه وأقربائه وأولاده وهام كالتائه في الصحارى وطوى القفار والفيافي إلى أن طوّحت به يد المسير إلى الساحل، فركب البحر إلى ميناء حيفا حيث نزل ومنها اتّجه إلى بلدة عكاء قَصْد التشرف باللقاء. ولما فاز بالتشرف عاد إلى حيفا وافتتح فيها حانوتًا صغيرًا ليبيع فيه بعض السلع، وكان يقنع بالربح القليل وقد شملته في ذلك البركة والنعمة وأصبح محطّ رحال الأحباء في تلك المدينة وبيته مأوى الزائرين الواردين من الأطراف. فكان يحتفي بهم ويهيّئ لهم الولائم مدّة آقامتهم في حيفا، وكان الكل يلهج بحمده وشكره على ما لآقاه منه من عظيم الحفاوة والإكرام والقِرَى وكان، فضلاً عن كل هذا، يسهّل للمسافرين أمور السفر حال عودتهم إلى أوطانهم مقدِّمًا لهم كل مساعدة ممكنة، بإخلاص تام واستقامة لا تضارع. وأنيط به إرسال الألواح المباركة إلى أربابها في مختلف الأصقاع، وجميع العرائض
الواردة من الجهات كانت تأتي بعنوانه ويقوم هو بإيصالها إلى الساحة المقدّسة بكل أمانة و دون تأخير. واستمرّ في أداء هذه المهمة زمنًا ليس بالقليل بحيث ارتاحت من عمله الضمائر إذ كان يؤدّي هذه المهمّة بطريقة محكمة وكان في هذا السبيل معتمدًا أمينًا واشتهر بذلك في جميع الأقطار وشملته ألطاف الجمال المبارك حتى أصبح معدن العدل والإنصاف مجردًا عن كل عُلقة دنيوية. وتعوّد خشونة العيش وعدم التقيّد في طعامه أو نومه. لم يركن إلى الراحة والمرح، يسكن منفردًا في غرفة مكتفيًا في أغلب وجبات طعامه برغيف من الخبز بلا إدام، وينام في ركن من أركان غرفته. غير أنه كان كالماء المعين للمسافرين من أهل البهاء ويهيّئ لمن أراد منهم أن ينام عنده فراشًا وثيرًا، ويقدّم لهم أنواع الطعام الشهيّ. كان طلق المحيّا باسم الشفتين حسن الأخلاق مملوءًا بالروح والريحان ودام، بعد صعود نيّر الآفاق إلى الملأ الأعلى، ثابتًا على العهد والميثاق بدرجة لا غبار عليها، وكالسيف القاطع في وجوه الناقضين الذين مارسوا جميع الحيل ليأخذوه إلى جانبهم أو يوجدوا ثُلْمَةً في ثبوته ورسوخه على العهد فلم يفلحوا وباءوا بالفشل العظيم، رغم ما قدموه لشخصه الكريم من الاحترام الزائد وإظهار المحبة له ومدّهم الموائد بأنواع الطعام الفاخر ومواجهته بوجوه باسمة. كل ذلك لم يغيّر من استقامته وأفكاره وتبرّأ من كل شيء عدا العهد والميثاق الإلهي. ولمّا يئسوا من محاولة تزلزله وأخذه إلى جانبهم قلبوا له ظهر المجن وأظهروا له الجفاء وعملوا على مناوأته وبلبلة أفكاره بلا جدوى لأنه كان جوهر الثبوت وحقيقة الاستقامة. وبتحريك من عديمي الوفاء، قام عبدالحميد خان (السلطان العثماني) على مناوأة هذا العبد والتعرض له. ولما كان السيد تقي المذكور مشهورًا بين الجمهور بأنه واسطة
إرسال المكاتيب الواردة من الساحة المقدّسة إلى أربابها في مختلف البقاع وإيصال العرائض الواردة من الخارج إلى المحضر المبارك، رأيت أن لا مناص إرساله إلى پورسعيد حيث قام بنفس المهمّة التي كان يؤديها، فقام بذلك خير قيام بطريقة تخفى على الأبصار والأوهام وبهذه الوسيلة خابت مساعي عديمي الوفاء ولم يقع في أيديهم شيء من المكاتيب فساقتهم الخيبة إلى دسّ الدسائس لدى الهيئة الحاكمة التي نسّبت مجيء هيئة من المفتشين من الآستانة إلى هذه الديار وكان ذلك في أواخر أيام عبدالحميد ولما حضرت الهيئة المذكورة لعب الناقضون والمعاندون دورهم معها وحملوهم على أن يشيعوا بأنهم سوف يقلعون الشجرة المباركة من جذورها. وصمّمت الهيئة على إلقاء هذا العبد في اليمّ أو نفيه إلى فزّان (من أعمال صحراء ليبيا بشمال إفريقيا) وهذا ما عقدوا عليه نواياهم بعد أن خاب مسعاهم في العثور على المكاتيب. ورغم التضييق الشديد وهجوم كل خبيث من أعضاء هيئة المفتشين وغيرهم على هذا العبد فكانت حركة المكاتبات جارية باستمرار على ما يرام وبغاية الإتقان وفق الخطة المرسومة.
والخلاصة، إن حضرة السيد تقي المنشادي قد قام بما كلّف به بكل همّة ونشاط عدة سنوات وكان جميع الأحباء في كمال السرور من أعماله، كما كان المسافرون ممنونين للغاية من خدماته الصادقة وكنت ترى المهاجرين في خجل عظيم من حسن معاملته. وأمضى مدة في پورسعيد لم يَرَ منه الأحباء هناك غير ما يجلب سرورهم وابتهاجهم غير أنه كان يكابد عناءً عظيمًا في تحمّل حرارة البلاد المصرية وأدّى ذلك إلى توعّكه وملازمته الفراش. ومن وطأة الحمّى الشديدة خلع ثيابه. ومن پورسعيد رفّت روحه إلى ملكوت الربّ المجيد وصعد إلى جوار ساحة الكبرياء.
كانت هذه الدرّة اليتيمة جوهرة العقل والنُّهَى وحقيقة التُّقى متحليًّا بالفضائل وجميل الخصال مما استوجب حيرة عقول الفحول من الرجال. ولم يفكّر في غير الحق ولم يطلب غير رضاء الربّ الواحد الأحد وكان مصداق البيان الآتي: "حتى أجعل أورادي وأذكاري وِردًا واحدًا وحالي في خدمتك سرمدًا". برّد الله لوعته بفيض الوصال، وشفى علّته بدرياق القرب في ملكوت الجمال. وعليه البهاء الأبهى.
(19)من جملة المهاجرين كان جناب آقا محمد علي صباغ اليزدي. إنّ هذا الشخص الغيور قد كشف الحجاب في العراق وهو في شرخ الشباب، وخرق ستار الارتياب وتحرر من الأوهام ثم هرع إلى ظل ربّ الأرباب. مع أنه كان شخصًا أميًّا في الظاهر غير أنّه كان على جانب عظيم من الذكاء وصداقة الوداد، وفاز بشرف اللقاء والمثول بين يدي جمال القدم بواسطة أحد الأحباء وهذا جعله معروفًا بين الأغيار بمعتقده، واتّخذ مأواه ومسكنه بجوار بيت المبارك فكان يتشرف بالحضور المبارك في كل صباح ومساء. وأمضى أيامًا كثيرة فرحًا منشرح الصدر ناعم البال. ولما حان تحرّك الموكب المبارك من بغداد قاصدًا اسلامبول لازم الموكب بشغف زائد مشتعلاً بنار محبّة الله إلى أن وصلنا مدينة القسطنطينية وألقينا بها العصا إلى أن كلّفتنا الحكومة بالذهاب إلى أدرنه، فتركنا آقا محمد علي المذكور في القسطنطينية ليباشر مسألة عبور الأحباء ومرورهم ويكفيهم مُؤْنَة الالتجاء إلى الغير وما إلى ذلك، وتكبّد بعد رحيلنا عظيم المتاعب والمشاق إذ كان فريدًا وحيدًا لا صاحب ولا مؤنس ولا جليس
ولا من يشاطره الأتعاب أو يرثي لحاله. آقام على هذا الحال عامين كاملين ثم حضر إلى أدرنه والتجأ إلى الجوار المبارك واشتغل بائعًا جوالاً يبيع بعض السلع حائمًا في أنحاء المدينة. ولمّا فار بحر الطغيان وضيّقت الحكومة على الأحباء المسالك وعمدت على نفينا إلى عكاء، كان الحبيب المذكور في معيّتنا وآقام مدة في السجن الأعظم إلى أن صدر له الإذن بالذهاب إلى صيدا قصد الآقامة بها واشتغل فيها بالتجارة، وصار يذهب إلى عكاء للتشرف كلّما سمحت له الظروف، وحلّ محلّ الاعتبار في نظر أهالي صيدا بدرجة يُغبط عليها وقدّره القوم حق قدر وعاش معزّزًا ومحترمًا وبالآخرة عاد إلى عكاء بعد وقوع المصيبة الكبرى (انتقال حضرة بهاءالله إلى عالم الأسرار) وقضى البقية الباقية من أيام حياته بجوار الروضة المطهّرة، روحي لتربتها الفداء، وكان الكل مسرورًا منه وراضيًا عنه وكان مقرّبًا من ساحة الكبرياء. وانتقل بعد استيفاء أيام حياته إلى أفق العزة الأبدية وترك عارفيه يصطلون بنار الحسرة على فراقه.
كان هذا الشخص طوال حياته مظهرًا للألفة، حميد الخصال، قنوعًا شكورًا، وقورًا صبورًا. عليه البهاء الأبهى. أنزل الله على قبره طبقات النور من السماء. أما قبره ففي عكاء.
(20)من جملة المهاجرين والمجاورين والمسجونين جناب آقا عبدالغفار من أهالي أصفهان. وقد أمضى هذا الرجل النبيل عدة سنوات مشتغلاً بالسياحة والتجارة في بلاد الروم وطوّحت به يد الترحال إلى بلاد العراق فهداه أحد مواطنيه، المدعو آقا محمد علي، من أهل الصاد، إلى الدخول في الساحة المقدّسة، ساحة حقيقة الموجود ومليك الوجود، فأزاح ستار الأوهام وطار بجناحيّ الفلاح والنجاح في فضاء محبة الله. ولمّا كان الحجاب الذي حجبه عن الحق رقيقًا تخلّص بمجرد إلقاء الكلمة عليه من عالم الموهوم والتجأ إلى حضرة المعلوم ثم سافر معنا من العراق إلى المدينة الكبرى (إسلامبول)، وكان في الطريق خير أنيس للجميع مطيعًا وأمينًا ممازجًا للجميع وكان ترجمانًا للأحباء، لأنه كان يتقن اللغة التركية كل الإتقان، وقطع الرحلة مرضيًّا عنه بكمال الرَوْحْ والريحان وكان يواسي الأحباء في الآستانة ويجالسهم، ونسج على هذا المنوال أيضًا في أرض السرّ (أدرنه) ثم أُخذ معنا مسجونًا إلى ميناء حيفا. فأبى مفتش الشرطة إنزاله من السفينة وأمر بإرساله إلى جزيرة قبرص، وشدّد في ذلك، وأراد إرساله بالقوة إلى قبرص، فلما رأى جناب آقا عبدالغفار ذلك ضاق ذرعًا وألقى
بنفسه من سطح السفينة إلى اليمّ، ولم يتنبّه المأمور، عديم الحياء، مما حدث وبالآخرة انتشلوه من البحر وسجنوه في الباخرة وأرسلوه بكل عنف وتجبّر إلى جزيرة قبرص وسجنوه بمقاطعة ماغوستا في أنحاء الجزيرة. أما هو فقد تمكّن، بأي وسيلة، من الفرار وذهب إلى عكاء وسمّى نفسه عبدالله بدلاً من عبدالغفار لينجو من شرّ الشرطة والعيون. وعاش عيشة طيّبة في ظل العناية المباركة هادئًا في روح وريحان إلى أن صعد النيّر الأعظم إلى الأفق الأعلى فتبلبل وارتبك وأحاطت به الأحزان من كل الجهات واستولى عليه القلق والحيرة وما لبث أن سافر إلى الشام وأمضى أيامًا هناك واقعًا في مخالب اليأس والأحزان وكأنه في مأتم ليل نهار، مهمومًا مغمومًا حتى وقع مريضًا فأرسلنا جناب الحاج عباس ليعوله ويواظب على معالجته ومواساته، فبذل هذا الأخير كل ما في وسعه في معالجته وكان يخبرنا يوميًا عن حالة ذلك المريض.
وبالإجمال، كان جناب آقا عبدالغفار يحادث الحاج عباس ويبدي له أن منتهى آماله أن يطير إلى عالم الأسرار إلى أن حان حينه ورحل إلى ساحة نيّر الآفاق غريبًا ومهاجرًا وفارق كل عارفيه. حقًا، إنه كان حلو الحديث ليّن العريكة حليمًا صبورًا سليم القلب وعلى خلق عظيم. عليه الثناء، وعليه البهاء الأبهى، وعليه الرحمة من ربّه العلي الأعلى. وقد تعطّرت أرض الشام بمواراته في تربتها.
(21)كان جناب، آقا علي نجف آبادي، في عداد المهاجرين والمجاورين. ما لبث هذا الشاب الروحاني أن سمع نداء الرب الغفور حتى ثمل من الجام الطّهور، وأبصر أنوار ظهور مكلّم الطور، وفاز بعلم اليقين، ووصل إلى أسمى مرتبة من رتب حق اليقين، وبعد أن هرع إلى السجن الأعظم شاهد أنوار عين اليقين. أمضى حينًا من الدهر متجوّلاً في ضواحي المدينة المقدّسة، مشتغلاً ببيع بعض السلع واشتهر باسم "الكاسب حبيب الله". كان ديدنه التوكّل، وشعاره التبتّل والتضرّع إلى الله بمظلوميّة متناهية، لا يعلو له صوت، كثير الصبر، حميد الأخلاق، مألوف الأطوار. واكتسب رضاء جميع الأحباء، وفاز بالرضاء والقبول من ساحة الأحدية. ولما شعر بدنوّ حينه ودبّ في رَوْعِهِ الإحساس بحسن الختام، ذهب إلى المدينة المقدّسة (مدينة السجن الأعظم) وهو في وهنٍ ومرضٍ شديد ولازم التضرّع للرب الجليل ليلاً نهارًا إلى أن لفظ النَفَس الأخير وانفتحت له أبواب الصعود إلى الملكوت الأعلى، فتخلّى عن هذا العالم الترابي وتوجّه إلى العالم الطّاهر.
كان آقا علي نجف آبادي رقيق الحاشية دائم التنبّه والتذكّر، وفي
أواخر أيامه، انقطع عما سوى الله وتنزّه عن كل دَنَسْ، وتَرك وهو على هذا الحال مأواه في هذا العالم، وضرب فسطاطه في العالم العلوي. عطّر الله مشامّه بنفحة قدسيّة من العفو والغفران، ونوّر بصره بمشاهدة الجمال في ملكوت الجلال، وروّح روحه بنسمات مسكيّة تعبق من ملكوت الأبهى. وعليه التحية والثناء. قبره الطيّب الطاهر في عكاء.
(22)المذكوران هما في عداد المهاجرين والمجاورين. هذان الشخصان المباركان من أحباء أذربيجان، وقد خطيا خطوة إلى الأمام وهما في موطنهما وابتعدا عن المعارف والآقارب، وأحكما أساس الثبوت والاستقامة وفرّا من حجبات الأوهام، وخرّا بعناية مليك الوجود وألطافه لله ساجديْن، وكانا حليفي الصدق التام والصفاء الخالص، وفي منتهى الفقر والتفاني، مظهرَيْ التسليم والرضاء، منجذبيْن بنور الهدى، مستبشريْن بالبشارات الكبرى. ثم شدّا رحالهما من أذربيجان إلى أرض السر وآقاما مدة في مدينة قرق كليسا وضواحيها مشتغليْن أثناء النهار بالتضرّع والتبتّل وفي أثناء الليل بالبكاء والعويل. ويبكون على مظلومية نيّر الآفاق بكل أنينٍ ونحيبٍ ولم يدخلا عكاء أيام السجن الشداد ولذا لم يعتقلا وعاشا في ضواحي عكاء بقلبيْن محترقيْن ولم يجفّ الدمع من آماقهما. والذي سبب مجيئهما إلى هذه البقعة وصول الخبر الصحيح من عكاء إلى تلك الجهات. إنهما في الحقيقة لشخصان نفيسان ومن عباد الجمال المبارك الصادقين. صفاء قلبيْهما يعجز عنه الوصف واستقامتهما لا تضارع.
أمضيا ردحًا من الزمن في بستان الفردوس خارج عكاء مشتغليْن بفلاحة الأرض وغرس الأشجار حامديْن شاكريْن لله على ما وفقهما لهذا العمل وكتب لهما الوصول إلى جوار العناية. ولمّا كانا متعوديْن على برودة الهواء في أذربيجان لم يقويا على تحمّل حرارة هذه البلاد وكان ذلك في أوائل أيام ورودنا إلى عكاء إذ كان الهواء وخيمًا والمياه ثقيلة غير صالحة للشرب وكل هذا سبّب مرضهما بالحمّى المحرقة والمطبقة فصبرا صبر الأبطال على ما انتابهما بكمال الانبساط والانشراح وكان تحمّلهما لشديد المرض أمرًا عجيبًا مع ارتفاع درجة حرارتهما فضلاً عن العطش وما كان في المدينة من اضطراب وانقلاب وكنت تراهما مستقرّيْن وفي سكون تام مستبشريْن ببشارة الله وبينما هما على هذا الحال من التعبّد والشكر للرحمن بكمال الرَّوْح والريحان إذ بهما يفرّان من هذا العالم إلى العالم الآخر وطارا من هذا القفص إلى جنّة الأوراد الباقية. عليهما الرحمة والرضوان وعليهما التحية والثناء، أدخلهما الله في عالم البقاء متمتعيْن باللقاء منشرحيْن في الملكوت الأبهى. أمّا قبراهما المنوّران ففي عكاء.
(23)ضمن المهاجرين والمجاورين، كان جناب الحاج عبد الرحيم اليزدي، هذا الشخص النفيس، من أهالي مدينة يزد واشتهر بالزهد والتقوى والتقديس والتعبّد وصالح الأعمال بدرجة لا يجاريه فيها p]أحد أحد واعتقد أهل بلدته بعظيم أحد
أحد وعرفه أهل بلدته بعظيم تمسّكه بالديانة الإسلامية ومواظبته على تأدية الفرائض وانكبابه على العبادات آناء الليل وأطراف النهار. لا يضارعه أحد في سلامة النيّة والحلم والرحمة والإخلاص. ولما كان عظيم الاستعداد قال: "لبيك" بمجرد استماعه للنداء من الملكوت الأعلى وصوت طبل، أَلَسْتُ (ألستُ بربّكم قالوا: بلى) وجذبه إشراق نيّر الآفاق بالكلّيّة فقام دون محاباة غير هيّاب ولا وجِل على هداية أفراد أسرته ومعارفه واشتهر بإيمانه بالظهور المبارك في مدينة يزد فنفر منه علماء السوء وحقّروه وأصبح مورد أذاهم مغضوبًا عليه من أهل النفس والهوى. ولما ثارت حفيظتهم ائتمروا به ليقتلوه وصبّ عليه أرباب الحكومة سياط الجور والجفاء وأذاقوا هذا الشخص سليم النيّه أنواع العذاب والأذى ما استطاعوا، طورًا بالضرب بالعصي وطورًا بالجلد وكانوا لا يفتئون يزجرونه ليل نهار فحمله ذلك على مبارحة مسقط رأسه وهام في البيداء وقطع الفيافي والقفار وطوى الوهاد والوديان إلى
أن وصل إلى الأراضي المقدّسة بعد أن أنهكه التعب وأضناه السغب حتى ظنّ كل من رآه أنه على وشك الموت لِما اعتراه من النّحول وشديد الوهن. ولما رآه، وهو على هذا الحال، جناب الملا محمد علي نبيل قائن سافر توًا من حيفا إلى عكاء وطلب إليّ أن أعمل على إحضار الحاج عبد الرحيم المذكور إلى عكاء لأنه لا يقدر على الحراك بل إنه يعالج سكرات الموت. فطلبت من نبيل قائن أن يمهلني حتى أذهب إلى القصر المبارك وأطلب الإذن بحضوره من الساحة المقدّسة. فرجاني أن يكون ذلك بسرعة مخافة موت الحاج عبد الرحيم قبل وصوله إلى عكاء لأن مراده أن يلفظ نَفَسَه الأخير في عكاء نفسها ويفوز بهذه الموهبة العظمى. فذهبت توًا والتمست له الإذن من الحضور المبارك ولما تمّ ذلك أحضرناه ورأيناه في حالة لا تمتاز عن حالة النزع يحملق بعينيه ولا يقوَ كلامًا. وما لَبِثَ أن دبّت فيه روح حياة جديدة من عبيق نفحات السجن الأعظم وسَرَت في بدنه، من شدّة شوقه للّقاء، روح حياة جديدة. وفي صبيحة اليوم التالي وجدته في كمال الروح والريحان وطلب مني المثول بين يدي نيّر الآفاق فأجبته أن ذلك موكول للإذن من الساحة المقدّسة وستحظى بهذه العناية إن شاء الله. وبعد أيام قلائل صدر له الإذن بالتشرف وما أن وصل إلى المحضر المبارك حتى انتعش وشعر بالحياة. ولما عاد من الزيارة كانت تلوح عليه علائم الصحة التامة والعافية وما كاد جناب نبيل قائن يراه حتى بهت وقال: "نعم إن هواء السجن (عكاء) يَهِب الأحباء الصميمين حياة جديدة".
وبالإجمال، إن الحاج عبد الرحيم قد أمضى أيامًا في جوار الساحة المقدّسة ناعم البال منشرح الصدر، مبتهجًا مسرورًا، صارفًا أوقاته في
التذكر وتلاوة الآيات بكل إمعان، مواظبًا على العبادات، قليل الاختلاط بالناس. وما انقطعتُ عن ملآقاته أبدًا وكنّا نأتيه بالطعام الخفيف على المعدة واستمر ذلك إلى أن وقع صعود حضرة المقصود، فاشتعلت بين ضلوعه نيران الحسرة، وعلا نحيبه وأنينه، ولم يجف الدمع من مآقيه، محترق الفؤاد يتحرك حركة المذبوح. واستمرّ أيامًا على هذا الحال، يسأل الله، في كل أنّاته، مفارقة هذا العالم الترابي لعدم مقدرته على تحمّل فراق المحبوب.
وفي النهاية انتقل إلى العالم الإلهي (عالم الأنوار) وتمتّع في محفل تجلّي العزيز الغفار. عليه التحية والثناء! وعليه الرحمة الكبرى ونوّر الله مضجعه بسطوع الأنوار من ملكوت الأسرار.
(24) جناب الحاج عبدالله النجف آباديحضر الحاج عبدالله النجف آبادي من بلاد إيران إلى الأرض المقدّسة بعد أن صدّق وآمن وأيقن بهذا الظهور العظيم، وسكن هادئ البال في ظل عناية حضرة المقصود، وعاش ساكن القرار في اطمئنان تام بألطاف حضرة الربّ المتعال. حسنة أخلاقه، ممدوحة طباعه، دائم التحدّث للأحباء ومذاكرتهم في الشؤون الأمرية. ثم رحل إلى غور طبريّة ومكث مدة مشتغلاً بالفلاحة والزراعة ولم يغفل آنًا عن التبتّل والتضرّع والتوسّل إلى العليّ المتعالي، والتشبّث بأذيال التعبّد بقلب سليم وخلق عظيم، ثم عاد من الغور وآقام في الجنينة في جوار حضرة المنّان، وكان يتمتّع بشرف الزيارة واللقاء مخلصًا وجهه إلى الملكوت الأبهى طورًا غارقًا في بحر البكاء، وطورًا في بحر السرور والحبور والفرح والمرح، منقطعًا عما سوى الله مشمولاً بعناية الحق، يسهر لياليه مناجيًا ربّه، حتى وافاه الأجل المحتوم وصعد وهو في ظلّ حضرة المقصود وذهب من عالم التراب إلى عالم الأفلاك طائرًا إلى ملكوت الأسرار. عليه التحية والثناء وعليه الرحمة في جوار ربّه الأعلى.
(25) جناب آقا محمد هادي الصحافمن جملة المهاجرين والمجاورين آقا محمد هادي الصحاف وهو من أهالي أصفهان. كان ماهرًا في تجليد الكتب ومتفوّقًا على الآخرين. متشبّثًا بذيل الكبرياء بدرجة فائقة، سريعًا في تأدية كل ما يتطلب منه عمله، شجاعًا قوي العارضة. بارح مسقط رأسه المحبوب وساح في البيداء واخترق السهول والوديان غير عابئ بوعثاء الطريق وما به من المخاوف، وجاس خلال الديار متحملاً ما هنالك من متاعب ومشاق، حتى وصل إلى البقعة المباركة وأصبح ضمن المسجونين. وعكف على العتبة المباركة، واشتغل بحراسة البيت المبارك وتنظيفه، وكنس الميدان الفسيح الواقع أمام الدار، وغسل أرضه المعبّدة بالأحجار حتى جعله في رونق يسرّ الناظرين. وكلما وقع نظر المبارك على هذا الميدان كان يبتسم ويتفضّل بقوله الأحلى: "إن آقا محمد هادي جعل ميدان السجن كالعروس ليلة زفافها". وكان جميع الجيران ممنونين مسرورين منه، وكان كلما فرغ من عملية الكنس والتنظيف يباشر في تذهيب الألواح وتجليد الكتب. ونسج على هذا المنوال حينًا من الدهر متمتّعًا بملآقاة محبوب قلوب أهل الآفاق، وفي الحقيقة كان هذا الشخص إنسانًا طاهر الذيل، صادق القول، مستحقًّا لموهبة
الوصال. ذات يوم، أتى إلى هذا العبد شاكيًا من استمرار مرضه الشديد، وقال، إنه قد صار له عامان وهو يعاني شدّة الحمّى والارتعاش وأن الأطباء لم يعطوه علاجًا سوى المسهلات وحبوب الكينا. وكانت الحمّى تنقطع أيامًا ثم تعاوده، وكلما استشار طبيبًا وصف له نفس العلاج، إلا أن المرض لم ينقطع بالكليّة فسئم الحياة وأصبح لا يقوى مباشرة أعماله إلا بشقّ الأنفس، وأراد تدبير أمره، فقلت له: "ماذا تأكل؟ وماذا تطلب من الطعام وتشتهي أكله؟" فقال: "يا مولاي لا أدري!"، فأخذت على سبيل الممازحة أسرد له أسماء الأطعمة إلى أن ذكرت له مطبوخ الكَشْك، فقال: "هذا طيّب بشرط أن يكون مع الثوم المقلي". فلما جهّزوه وأحضروه له تركتُه وانصرفت. إذا به قد حضر إليّ في اليوم التالي وقال: "يا مولاي تناولت صَحفةً من الكَشْك فنمت نومًا سباتًا حتى الصباح".
وبالإجمال، فقد قضى بعد ذلك عامين في صحة جيدة. وذات يوم حضر أحد الأحباء وأخبرني بأن آقا محمد هادي مصابًا بالحمّى المحرقة، فذهبت على التو لأعوده، فرأيت درجة حرارته بلغت الثانية والأربعين وكان لا يعي، فقلت للحاضرين: "ماذا فعل؟" فقالوا، إنه لما شعر بالحمّى وروى أنه قد جرب في مثل هذه الأحوال مطبوخ الكَشْك مع الثوم المقلي، فأحضرنا له ذلك، فتناول منه حتى امتلأ وما لبث حتى صارت حالته كما ترى. فتحيّرت من صنع القضاء والقدر، وأخيرًا قلت: "بما أنه قد أكثر من تناول المسهلات وغيرها طوال العامين المنصرمين وكانت معدته خالية وهو محموم وبه رعشة، وتناول الطعام كالكشك مثلاً، فلعب ذلك دوره فحلّ به ما حلّ إذ كان من باب أولى أن لا يتناول الكشك". فقال الحاضرون: "هكذا كانت
أحكام القدر، وقضاء الله لابد نافذ". فبالاختصار، قد سبق السيف العذل، وضاعت فرصة المعالجة وانتهى الأمر.
كان هذا الشخص قصير القامة، ولكنه عالي الهمّة سامي المقام، طاهر القلب نيّر الفؤاد، زكي الروح. وكان طوال المدّة التي آقامها لدى العتبة المباركة محبوبًا من جميع الأحباء مقربًا من ساحة الكبرياء، وكان الجمال المبارك يبتسم عندما يحادثه، كما كانت تفيض عليه العناية وهو بدوره كان عبدًا شكورًا لا يرضى غير رضاء الحق. طوبى له من هذا الرِفد المرفود! بشرى له من هذا الورد المورود! هنيئًا هذه الكأس مزاجها كافور! وتقبّل الله منه كل سعيٍ مشكور.
(26)جناب آقا ميرزا محمد قلي أحد أخوة الجمال المبارك الصادقين المخلصين لحضرته. اشتهر هذا الشخص رفيع المقام، بحريّته وعدم تقيّده منذ طفولته. توفى والده وهو في سن الرضاع فتربّى في حضن العناية. لم ينشغل بالاً بتوافه الأفكار متمسكًا بإطاعة الأوامر المباركة، وترعرع في مهد الألطاف في بلاد إيران مشمولاً بعناية نيّر الآفاق كل أيام وجوده في العراق. كان هو ساقي الشاي الوحيد في المحضر المبارك، وقد لازم الجمال المبارك في الحِلّ والترحال، دائم الصمت والسكوت، ثابتًا مستقيمًا على عهد "ألَسْتُ"، مشمولاً بالعواطف مصدرًا للّطائف. وكان ليل نهار متشرّفًا بالمثول بين يدي جمال القدم، موصوفًا بالصبر وتحمّل الشدائد في جميع الموارد، وما زال ناسجًا على هذا المنوال حتى وصل إلى أوج القبول ولازم الركب المبارك في الأسفار من إيران إلى العراق فإلى اسلامبول، وكان هو الوحيد الذي ينصب الصّيوان في الطريق لجمال القدم، والخادم الخاص لحضرته بكل إخلاص وهمّة ونشاط لا يدركه الملل. واستمر على هذا الحال في اسلامبول وفي أرض السرّ إلى أن ذهب في معيّة حضرة اللامثال إلى السجن الأعظم منفيًّا. ونصّ الفرمان الملكي على
أنه من المسجونين المؤبّدين. ولم يتغيّر حاله أبدًا سواء أكان في حال التعب الشاق أو الوهن والمرض أو في الصحة التامة، ولم ينطق بغير الشكر للألطاف الإلهية، فارغ القلب، منقطعًا عمّا سوى الحق، مشغولاً بالحمد والثناء على الله، متمتّعًا في عدوه ورواحه بالمثول بين يدي الجمال المبارك، محفوظًا فائزًا باللقاء. ودام، بعد صعود محبوب القلوب إلى عالم الإشراق، ثابتًا راسخًا على العهد والميثاق بعيدًا عن كل مكر ونفاق، مثابرًا على التبتّل والتضرّع لا يألو جهدًا في وعظ من أَلِفَ السمع ويُمْحِضه النّصح. وقد تأثّر كل التأثر بعد الصعود المبارك، ولم تبرح ذكرى أيام المبارك عن مخيّلته فزَهد في الدنيا ولم يذُق للراحة طعمًا ولم يعبأ بصحبة أي إنسان، والتزم الوحدة ثاويًا في محلّ عزلته ومأواه، متقلّبًا على جمر الاحتراق من ألم الفراق. واستولى عليه الضعف ووهن منه العظم إلى أن دنا حينه فطار إلى العالم الإلهي.
عليه السلام وعليه الثناء وعليه الرحمة في حديقة الرضوان. أما رمسه المنوّر ففي قرية النقيب في ضواحي بلدة طبريّا.
(27)كان في عداد المهاجرين أخوان نجاران هما جناب الأستاذ باقر والأستاذ أحمد. كان هذان الشقيقان طيبيّ الأصل وهما من أهالي كاشان، يشد الواحد منهما أزر أخيه منذ اعتنقا الأمر إذ آمنا بمجرد سماع النداء وخطاب –أَلَسْتُ- (أَلَسْتُ بربّكم) فقالا: "بلى" واشتغلا في بلدتهما زمنًا في التعبّد والابتهال حتى أصبح أمر اهتدائهما إلى سبيل البهاء أشهر من نار على علم. واحترمهما الأحباء والأغيار، واشتهرا بالأمانة والزهد والتقوى بين الجميع. ولمّا تطاول عليهما الأعداء، وضيّقوا المسالك، هاجرا إلى العراق واستظلاَّ في ظلال المبارك. حقًا، إنّهما شخصان مباركان، أمضيا أوقاتهما في العراق بالتبتّل والتضرّع والابتهال.
ذهب الأستاذ أحمد إلى أدرنه، أما أخوه فبقي في العراق مأسورًا في بلدة الموصل. بعد ذلك ذهب الأستاذ أحمد في معيّة الجمال المبارك إلى السجن الأعظم، وما لبث أخوه أن هاجر من الموصل إلى عكاء، فالتحق بأخيه والتجآ إلى ساحة الأقدس وتخلّصا من كل قيد، واشتغلا بالتجارة في عكاء، وابتعدا عن القاصي والداني، وعاشا في رحاب الرحمن ساكتيْن موقّريْن، على كمال الإيقان والاطمئنان، يعاشران
الكلّ بالروح والريحان في جميع الأحيان. ثم وقع صعود الأستاذ باقر وبعد قليل اختطفت المنون أخاه الأستاذ أحمد.
ومختصر القول، إن هذيْن الأخويْن كانا مؤمنيْن موقنيْن ثابتيْن راسخيْن صابريْن شاكريْن متضرّعيْن مبتهليْن متوجهيْن إلى حضرة الكبرياء في كل الأحيان. ولم يحصل منهما أدنى قصور أو فتور طوال مدة آقامتهما في السجن، وكانا في كمال الفرح والسرور، ثمليْن من الكأس الطهور. وقد بكاهما، بعد موتهما، جميع الأحباء وأدميت قلوبهم وازداد حزنهم عليهما، وما وسع الجميع إلا أن طلبوا لهما العفو والمغفرة من ألطاف الجمال المبارك، وكانا في أيام حياتهما مشمولين بالألطاف ومؤيدين بالإسعاف، وكان الجمال المبارك راضيًا عنهما فاكتفيا بهذه العناية زادًا لسفرهما الأخير إلى العالم الأبدي.
عليهما البهاء الأبهى وعليهما الرحمة من ألطاف الكبرياء ولهما مقعد صدق في ملكوت الأبهى. أما قبراهما ففي عكاء.
(28)من أصفهان الرجل الجليل جناب آقا محمد حناساب يعتبر من جملة المهاجرين ومن قدماء الأصحاب، وقد اشتهر من بداية الإشراق بمحبة نيّر الآفاق. أغمض بصره عن العالمين وأسرع إلى جمال محبوب الأرواح، دون صبر أو فتور، وتنسّم الحياة من النفحة المسكية. كان قلبه نورانيًا ومشامه معطرة، وبصره ثاقبًا، وأذنه واعيًا، واهتدى بواسطته الكثيرون، وكان صادقًا مخلصًا في هذا الأمر العظيم، وكثيرًا ما أوذي وتحمل المشاق، ولم يعتره فتور أو قصور. وأدّت الظروف إلى أن أصبح مقربًا لدى سلطان الشهداء ومحلّ الاعتماد لدى محبوب الشهداء الذي ائتمنه في جميع الأحوال، ودام موفقًا في خدماته أعوامًا طوالاً مؤيدًا بالعون والعناية الربانية. كثيرًا ما أظهر سلطان الشهداء رضاءه عنه إذ كان من النفوس المطمئنة بل الراضية المرضية، من الخلّص في دين الله، المخلصين في محبة حضرة الكبرياء، حسن الأخلاق، طيب المعاملة، عذب الحديث حلو المقال. بقي في أصفهان محترقًا بنيران الفراق بعد استشهاد سلطان الشهداء، وأخيرًا هاجر إلى سجن عكاء وفاز بشرف اللقاء، واشتغل بكنس العتبة المباركة مفتخرًا بذلك، وكان حليمًا سليم النفس، ورفيقًا
محبوبًا، ونديمًا لمعاشريه، لم يهدأ آنًا لاحتراقه بنار الفراق بعد وقوع المصيبة الكبرى لصعود الجمال الأبهى، روحي لأحبائه الفداء، وكان يقوم في الأسحار ويحوم في أنحاء البيت المبارك باكيًا منتحبًا، تجري دموعه كالسيل الجارف، مشتغلاً بتلاوة المناجاة. ولكم كان مقدسًا رفيع الجانب، لم يقو على تحمل الفراق من شدة الاحتراق. ترك جسمه الفاني وانتقل إلى عالم الأنوار، محفل تجلي الرحمن.
نوّر الله جدثه بأنوار ساطعة من ملكوت الغفران، وروّح الله روحه في بحبوحة الجنان، وأعلى الله درجاته في حديقة الرحمن. أما رمسه المنوّر ففي عكاء.
(29)جناب الحاج فرج الله التفرشي من المهاجرين والمجاورين. فقد انقطع هذا الرجل طيب النفس لعبودية الجمال المبارك منذ عنفوان شبابه، وهاجر من إيران إلى أرض السرّ بصحبة والده الجليل (آقا لطف الله) الذي كان مؤمنًا موقنًا ثابتًا راسخًا في محبة الجمال المبارك، حمولاً في الشدائد، صبورًا في الملمّات، بعيدًا عن حطام الدنيا وزخارف هذا العالم. أمضى أيامًا في جوار حضرة الأحدية، قنوعًا للغاية حتى طار، في نهاية المطاف، بجناحي التذلل والانكسار إلى الله من هذا العالم الفاني إلى العالم الأبدي ودفن بمدينة أدرنه.
أما الحاج فرج الله، فقد آقام بأدرنه حتى نفاه الأعداء مع الجمال المبارك إلى هذا السجن الأعظم (عكاء). ولما انفرجت أزمّة معيشته الضنكة، ساهم في شركة تجارية مع جناب آقا محمد علي الأصفهاني وعاش مرتاحًا في رغد من العيش زمنًا ليس باليسير، إلى أن أذن له الجمال المبارك بالسفر إلى بلاد الهند حيث آقام إلى أن حان حينه، فطار إلى حديقة الغفران بجوار رحمة ربه العزيز المنان. وقد شارك هذا العبد، عبد العتبة المباركة، جميع الأحباء فيما أصابهم من البلايا والرزايا، وكان طوال أيام حياته مشمولاً بألطاف الجمال المبارك
مسرورًا بالعناية الإلهية التي لا نهاية لها، معدودًا من الأصحاب، يعاشر الأحباء ويجالسهم بقلب سليم. وكان مع نحافة جسمه ووهن عظمه، شكورًا راضيًا على البلايا في سبيل الله.
عليه التحية والثناء، وله العطية والبركات من السماء، وعليه البهاء الأبهى. أما قبره الطاهر ففي مدينة بمباي في الهند.
(30)كان في عداد المهاجرين والمجاورين آقا إبراهيم الأصفهاني عليه التحية والثناء. كان يقيم مع أخوته الثلاثة، آقا محمد صادق وآقا حبيب الله وآقا محمد علي، في دار عمهم المفضال جناب آقا محمد رضا، الشهير بالعريض، يعيشون كطيور المحبة في عش واحد مثالاً للمحبة، وكالورد في اللطافة وفي لين العريكة لا مثيل لهم. ولما شرّف الجمال المبارك العراق سكن في دار مجاورة لدارهم، لذا كانوا يرونه عند عبوره ومروره وقد شُغِفوا بحبه وجذبهم السلوك المبارك رويدًا رويدًا وبهرتهم طلعة محبوب الآفاق، فأصبحوا متشوقين إلى زلال الهداية طالبين للألطاف والعناية. وما أن وصلوا إلى باب دار المبارك وهم كشقائق النعمان تتلألأ وجوههم من الأنوار الساطعة من الجبين المبارك، حتى أنهم جُنّوا بطلعة جمال المحبوب. وما لبثوا أن انكشف عنهم الحجاب دون أن يتبلّغوا الكلمة وفازوا بمقصود القلب والروح. وبعد ذلك أمر جمال القدم المدعو ميرزا جواد الترشيزي أن يذهب إلى دارهم قصد تبليغهم، فصدع المومى إليه بالأمر. وبمجرد إلقاء الكلمة عليهم أذعنوا للأمر دون تردد لاستعدادهم العجيب، مصدآقا لقوله تعالى في القرآن: "يكاد زيتها
يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور". يعني أن دهن الاستعداد لديهم اشتعل حين القرب والاقتراب من مقصود القلوب والأرواح ولو لم تصله النار؛ أي أن الاستعداد والقاتبلية للهداية تصل إلى درجة تسطع فيها نور الهداية دون إلقاء الكلمة. حقًا، أن هؤلاء النفوس الزكية كانوا في غاية الثبوت والاستقامة والتوجه لحضرة الأحدية.
أما الأخ الأكبر، جناب آقا محمد صادق، فقد سرى بجوار الركب المبارك من العراق إلى القسطنطينية فإلى أرض السرّ وقضى أيامًا في سرور وهناء ورَوْحٍ وريحان في جوار حضرة الرحمن. أما حِلمه وسلامة طويّته وصبره وشكره لله فحدّث عنها ولا حرجٍ، فكنت تراه دائمًا هشًا بشًا مسرور القلب والفؤاد بروح منجذبٌ إلى طلعة المحبوب. وبعد مدة، أذن له بالعودة إلى العراق، حيث تقيم عائلته، وصرف معظم أيامه في ذكر الله ولم يفكر في غير الحق سبحانه. ولما نشبت في الأحباء مخالب الامتحانات وشدة البلوى، دخل الأخوة الأربعة وعمهم الطاهر في عداد الأسرى وسيقوا بكل قسوة وظلم واعتساف إلى الحدباء (الموصل) حيث وقع عمهم آقا محمد رضا، ذلك الهرم النوراني ذو القلب الروحاني والفكر السبحاني والمخلص المحض، في براثن الاحتياج والفاقة والإعسار الشديد دون باقي الأسرى، بعد أن كان في العراق من ذوي اليسار هانئ العيش وفي رفاهية تامة. فعاش في الحدباء عيشة ضنكا غير أنه لبس جلباب الصبر شاكرًا لله راضيًا بقضائه، وعكف على حمد الله وشكره ليل نهار إلى أن سلّم روحه لباريها وتخلّص من قيود هذا العالم الفاني وطار إلى العالم اللامحدود. أغمسه الله في بحار العفو والغفران، وأدخله في جنة الرحمة والرضوان، وأدخله في فردوس الجنان.
أما جناب آقا محمد صادق، فقد عضّه الإعسار بنواجذه في سبيل الله في الحدباء أيضًا. غير أنه لم يركن إلى الهلع والجزع، بل عاش مطمئنًا بنفس راضية مرضية إلى أن لبّى دعوة رب العزة إذ ناداه بقوله تعالى: "يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي".
أما آقا محمد علي، فقد أتى إلى العتبة المباركة من الموصل بعد أن فكّ من الأسر، وبقي حتى الآن في سرور وابتهاج في البقعة المباركة ولو أنه كان في عسرة.
أما الأخ إبراهيم المومى إليه، فقد نزح من الحدباء إلى عكاء واشتغل بالتكسب في ضواحيها بكمال السكون والقناعة والصبر على مضض العيش والبلايا، ولكنه بعد صعود حضرة المقصود، أخذ يتقلب على نيران الفراق وأخذ منه الهمّ والغمّ كل مأخذ وهو لا يفتأ يذكر الحق بكمال التذلل والانكسار والتوجه إلى الله. ولما بلغ من الكبر عتيَّا ووهن منه العظم، جاء إلى حيفا ونزل في المسافر خانة وأمضى أناء ليله وأطراف نهاره في ذكر الله والتضرع والتبتل إليه وقد اعتراه الانحلال في الأعضاء من التوغل في الشيخوخة، وبالآخرة خلع قميص الجسم الفاني وطار عُريانًا إلى ملكوت الرحمن وانتقل من العالم الظلماني إلى الفضاء النوراني مستغرقًا في بحر الأنوار. نوّر الله رمسه بسطوع الأنوار، وروّح الله روحه بنفحات العفو والغفران، وعليه الرحمة والرضوان.
أما آقا حبيب الله، فقد كان ضمن الذين أسروا في العراق أيضًا وأُرسلوا إلى الموصل (الحدباء) وآقام بها زمنًا في خشونة من العيش وكمال القناعة. ولم يقلّل ذلك من قوة إيمانه مع وجود القحط والغلاء الفاحش في الحدباء خاصة على الغرباء. كانت قلوب
الأحباء مطمئنة بذكر الله، يسدّون رمقهم بالغذاء الروحاني الذي يشفي غلة الأرواح، ويأكلون من الطعام الرحماني الذي يشبع القلوب من السغب. ولهذا قد تردّى الجميع برداء الصبر والتحمل والجلد العجيب، حتى احتار أهل الحدباء في أمر هؤلاء الأحباء وكانوا يقولون، كيف أن هؤلاء الغرباء لم يعترهم الشتات أو الارتباك مما أصابهم من جراء القحط والغلاء وهم فقراء وتراهم ليل نهار حامدين الله شاكرين. وإن تعجب فَعُجْب ما هم عليه من الهدوء والاطمئنان.
وخلاصة القول، إن جناب آقا حبيب كان له نصيب موفور من التحمل والصبر على الشدائد، وكان قلبه في غاية البهجة والسرور أليف العزلة عظيم الشغف بالحق.
كان جميع أسرى الحدباء مذكورين في الحضور المبارك على الدوام، وكانوا مورد الألطاف التي لا تحصى. وبعد عدة سنين انتقل آقا حبيب إلى جوار الرحمة الكبرى، واتخذ له عشًا على أفنان سدرة المنتهى مشتغلاً بتسبيح الرب الكريم وتقديسه بالألحان البديعة في جنة النعيم.
(31) جناب آقا محمد إبراهيم الملقّب بمنصوركان في عداد المجاورين والمهاجرين جناب آقا محمد إبراهيم النحاس الملقب بمنصور. إن رجل الله هذا هو من أهل كاشان، وقد شاهد وهو في عنفوان شبابه تجلي الأنوار، وثمل من جام الظهور وسكر من الكأس التي مزاجها كافور. كانت حالته مرضية، رفيع الذوق، بشوش الوجه. ولما أُوقِدت نار الهداية في زجاجة قلبه وروحه، ظعن من كاشان إلى الزوراء وفاز بشرف اللقاء، وكانت طباعه مألوفة وقريحته وقّادة وفكره سيّالاً، ينظم الشعر كعقود الجمان، وفي بغداد عاش بين العارفين والأبعدين في صلح وسلام يقابل السيئات بالحسنات. وأتى بأخويه من إيران إلى بغداد وأخذ في مزاولة حرفته ورفاهية الغير، وأصبح ضمن الأسرى الذين أُخذوا من الزوراء إلى الحدباء (الموصل) فإلى حيفا، واشتغل آناء الليل وأطراف النهار بالتبتل والتضرع والتذكر والمناجاة مُوقفًا نفسه لخدمة الأحباء في حيفا الزمن الطويل مواظبًا على خدمة المسافرين بكل همة وخضوع وخشوع. تأهّل في حيفا ورزق سلالة طيبة وكان في تجدد روحي مستمر، باسم الثغر يصرف بكمال الرضاء كل أرباحه على الأحباء والمحتاجين. وقد رثى حضرة سلطان الشهداء بعد استشهاده بقصيدة عصماء وتلاها في
المحضر المبارك، وحقًا إنها كانت مؤثرة بدرجة أبكت السامعين حتى علا نحيبهم. لم تتغير طباعه المألوفة طوال أيام حياته مصيبًا في رأيه ولِهًا مخلصًا في عشقه للحق وعاش ضاحكًا كالوردة مفتحة الأكمام إلى أن لبّى دعوة داعي انتهاء الأجل وهو في حيفا، فعرج إلى العالم العلوي وسرع من البرزخ الأدنى إلى الرفيق الأعلى وصعد من عالم التراب إلى عالم الطهر والنقاء ونصب فيه خيمته وسرادقه.
طوبى له وحسن مآب، وتغمّده الله برحمته في ظل قباب الغفران وأدخله في روضة الرضوان.
(32) جناب آقا زين العابدين اليزديكان من جملة المهاجرين جناب آقا زين العابدين اليزدي الذي لبّى دعوة داعي الموت وهو في طريقه إلى الأرض المقدّسة. آمن هذا الشخص المخلص بمجرد سماعه نداء الحق في بلدة منشاد حيث اهتزّت روحه واشتعلت نائرة محبة الله في قلبه بالروح والريحان وأوقدت شموع الهداية في زجاجة روحه وفؤاده. أما العشق الإلهي فقد أوجد الفتنة والاضطراب في أركانه وانفكّ زمام الانجذاب بدرجة جعلت هذا الولهان يترك وطنه ويتوجه إلى أرض المقصود واتصل في طريقه بولديه اللذين رافقاه وكل أمله الوصول إلى ما يبهج قلبه ويسرّ خاطره وكان كلما دخل مدينة أو بلدة أو قرية أو قصبة يختلط بالأحباء غير أن بُعد الشُّقة وطي الوِهاد أغرقه في بحار التعب والمشقات، وأدت به وعثاء الطريق إلى الوهن والمرض، أما قلبه فكان منتعشًا مع كل ما لآقاه من المتاعب فلم يلحقه الكلل ولا الملل، وكان شديد العزم قوي الإرادة وما برح أن أخذ مرضه في الازدياد يومًا غُبّ يوم إلى أن أدركه الحُمّة وطار إلى جوار الرحمة الكبرى وسلّم روحه وهو في غاية من الحسرة على فراق محبوبه. ولو أنه لم يتيسّر له تجرّع كأس الوصال ومشاهدة الجمال المبارك عيانًا في هذه الدار غير أن روحه قد نالت في الحقيقة الروح
والريحان وأصبح محسوبًا من الفائزين وقدّر له حتمًا أجر اللقاء. كان هذا الشخص الطاهر غاية في الصدق والخلوص والإيمان والإيقان لم يخرج من فمه لفظ بغير الحق ولم يختر غير عبادة الحق ولم يسلك غير طريق المحبة الصرفة واشتهر بحسن النية والصداقة والثبوت على الأمر والاستقامة فيه.
سقاه الله كأس الوصال في ملكوت الجمال وأدخله في عالم البقاء وقرّت عيناه بمشاهدة الأنوار في عالم الأسرار.
(34) جناب الحاج ملا مهدي اليزديكان الحاج ملا مهدي اليزدي من زمرة المهاجرين. ولو أن هذا الشخص الفاضل الكامل لم يكن في الظاهر من أهل العلم، غير أنه كان ماهرًا في تتبّع الأحاديث والأخبار، مفوّهًا في تفسير الآيات بقوة بيان لا تُضارَع واشتهر بالتقديس والتنزيه والتهجّد، قلبه نوراني وروحه ربانيّة. يصرف معظم أوقاته في الصلوات وتلاوة الأدعية وإظهار العجز والابتهال إلى الغني المتعال كاشفًا للأسرار وحرمًا للأبرار فصيح اللسان بليغ العبارة في أمر التبليغ يهدي الناس بكل اشتياق يتدفق من فمه سيل الاستشهاد بالروايات والأحاديث المأثورة.
وعلى الجملة، إنه لما اشتهر في بلدته بالبهائية بين الكبير والصغير والأمير والحقير وأصبح متهمًا بهذا الاسم، رفع ستار الكتمان والتقيّة وافتضح أمره بمعتقده الجديد فقام عليه علماء السوء في مدينة يزد وأفتوا بقتله وشذّ من بينهم حضرة المجتهد المدعو ملا باقر الأردكاني ولم يوافق العلماء الظالمين على فتواهم حيث أجبره على مبارحة موطنه. فعزم على الرحيل إلى بلد المحبوب مصطحبًا ولديه وهما حضرة الشهيد المجيد (جناب ورقاء) وجناب (ميرزا حسين) وكان كلما دخل مدينة أو بلدة أو قرية حرّك لسانه عاجلاً بالتبليغ ونشر أمر الله بآقامة الحجج
والبراهين والأدلًة الواضحة ورواية الأحاديث والأخبار الدالة على هذا الظهور مع تفسير الآيات وتأويل البيانات ولم يضيع دقيقة واحدة في غير ذلك ولم يهدأ ساعة واحدة في نشر النفحات وتضويع عرف محبة الله وإيصال نفحات القدس إلى مشام العباد وكان يشوّق الأحباء ويحضّهم على نشر كلمة الله ليحرزوا قصب السبق في ميدان العرفان.
ومختصر القول، إن هذا الشخص كان رجلاً جليلاً دائم التوجه إلى الرب الجميل لا يعبأ بحياة النشأة الأولى في عالم الدنيا صارفًا كل همّه لبلوغ الموهبة في النشأة الأخرى بقلب نوراني وفكر روحاني وروح رباني وهمة سماوية، كابد في رحلته المشاق العديدة مما اعتراه في طريقه من طي للصحاري وتسلق للجبال الشامخات والانحدار من سفوحها، مع كل هذا، كان يلوح من جبينه نور الهداية وفي قلبه تشتعل نار الاشتياق. لهذا اجتاز الحدود والثغور وطوى الوِهاد والوديان مسرورًا كل السرور حتى وصل إلى بيروت وقد تمكّن منه المرض فآقام فيها عدة أيام وتأججت بين ضلوعه نيران الاشتياق وهاج قلبًا وقالبًا. ولما عيل صبره واصل سيره مع شدة مرضه لأنه لم يَقْوَ على الانتظار ببيروت متوجهًا إلى ساحة المقصود سائرًا على الأقدام. ولما كانت نعلاه لا يقيانه من شديد الرمضاء فقد انسلخ قدماه وانجرحت رجلاه واشتدّ عليه المرض الشديد حتى كاد لا يقوى على الحراك ولكنه واصل سيره قليلاً فقليلاً بكل عناء حتى أدرك المكان المعروف بالمزرعة بجوار قصر المزرعة وهناك تجرّع كأس المنون وصعد إلى ملكوت الله ورجعت روحه إلى بارئها بعد أن فرغ من طاقته الصبر وأصبح عبرة للعشاق وانجذب روحه إلى نيّر الآفاق.
جرّعه الله كأسًا دِهآقا في جنة البقاء وتلألأ وجهه نورًا وإشرآقا في الرفيق الأعلى وعليه بهاءالله. أما قبره المطهر ففي مزرعة عكاء.
(34)إن حضرة الكليم يعني جناب آقا ميرزا موسى عليه بهاءالله هو الأخ الشقيق للجمال المبارك نشأ من سن الطفولة ونما في حضن تربية جمال القدم – الاسم الأعظم – وامتزجت المحبة الإلهية بلبن الرضاع فكان متعلّقًا تعلّقًا شديدًا بالجمال المبارك وكان دائمًا مورد عناية حضرة الأحدية ومظهر الألطاف الربانية. تربّى بعد وفاة المرحوم والده في كنف الحضرة المباركة وترعرع، وما أن وصل درجة البلوغ حتى ازدادت طاعته وعبوديته للجمال المبارك. كان يمتثل للأوامر في جميع الموارد بعيدًا كل البعد عن التفكير في الدنيا وكان بين أفراد الأسرة المباركة كالسراج الوهاج لم يمل إلى الرتب والمناصب ولم يشغل قلبه بشتى المقاصد. خدمته للجمال المبارك كانت منتهى آماله وغاية مقصده ورجائه مما جعله لا ينفك عن الحضور المبارك آنًا بأية حال. وكلما أظهر بعض أفراد الأسرة جفاءً كان هو مظهر الوفاء، ثملاً من خمر الصفاء إلى أن ارتفع النداء من شيراز فاستنار قلبه بمجرد سماع بعض البيانات من الفم المطهر، وتعطرت مشامّه بنفحة من بستان أوراد الهداية وقام للتو على خدمة الأحباء والتفاني في محبتهم. وكان متعلّقًا بي (يعني بحضرة عبدالبهاء) تعلّقًا
غريبًا بمعنى أنه كان لا يفارق عبدالبهاء لحظة، واشتغل بترويج الأمر في طهران ليل نهار حتى اشتهر بذلك بين العموم ولا يأتلف في جميع الأحوال إلا مع النفوس المباركة. ولم يرافق جمال القدم أحد من إخوته في رحلة حضرته من طهران إلى العراق إلا حضرة الكليم وأخوه المدعو آقا ميرزا محمد قلي فتركا إيران وأهلها وأغمض عينيهما عن التمتع براحة نفسه وفضّلا البلايا في سبيل محبوب الأرواح دون تردد حتى وصل الركب المبارك أرض العراق. وفي أيام غياب الجمال المبارك في سفره (دون علم أحد) إلى كردستان هال ذلك حضرة الكليم واستولى عليه الخوف والاضطراب إذ أصبح في خطر عظيم وحياته مهددة وكان هذا الحال يتنقل من سيئ إلى أسوأ يومًا بعد يوم ولكنه لبس لكل حالٍ لبوسها ومارس الصبر والتحمل وطرح عوامل الخوف والفزع والهلع وراء ظهره إلى أن عاد جمال القدم من كردستان ولم تتغير أحوال ميرزا موسى وداوم على خدمته للعتبة المقدّسة بكل قواه واشتهر بذلك في الآفاق وذهب في معيّة جمال القدم أيضًا من دار السلام إلى اسلامبول فإلى أدرنه قائمًا بخدمة الجمال المبارك ما استطاع. ولما استشمّ رائحة الخلاف، وهو في أدرنه، من ميرزا يحي (الأزل) أخذ يمحضه النصح ليل نهار ويدله على طريق الصواب لعله يرعوِ، دون جدوى لأن وساوس المدعو السيد محمد قد أثّرت في ميرزا يحي تأثيرًا عجيبًا كتأثير السمّ في الجسد. وفي النهاية يئس حضرة الكليم ومع ذلك لم يهدأ وعمل ما في وسعه لعل ثائرة ذلك الغبار تهدأ ويتخلص ذلك الشخص المعهود (ميرزا يحي) من هذه الورطة المهلكة وتنقشع ضبابة الغمّ الشديد والهمّ الداهم وتنطفئ نار الأسف والأسى واستعمل جميع الوسائل في هذا الصدد ولكنه كان كالضارب في حديد بارد.
ولما يئس كل اليأس تنحى عن الميدان وقال لميرزا يحي: يا أخي إذا لم يصل الآخرون إلى الحقيقة فإن الأمر لدى كلينا واضح لا شبهة فيه. فهل نسيت ألطاف الجمال المبارك لما كنت أنا وإياك تحت رعاية تربيته؟ فكم كان حضرته يصرف أوقاته في التدريس لك وتعليمك تحسين الخط والإملاء والإنشاء تعليمًا صحيحًا ليل نهار حتى أنه كان يصحح لك الخط بأنامله المباركة ولا يخفى على أحد درجة ألطافه نحوك على الخصوص وكيف كان يربيك في حضن العناية. فهل فعلك هذا هو الشكر على مثل هذه الألطاف بمعنى أنك أصبحت أنت والسيد محمد يدًا واحدة وخرجتما عن ظل المبارك؟ أهذا شرط الوفاء؟ هل هذا جزاء النعمة اللانهاية؟ فلم يثمر كلام حضرة الكليم مع ميرزا يحي بل إن هذا الأخير أخذ يبرز ما يكنّه ضميره يومًا فيومًا بكل وضوح حتى حصل الانفصال.
ومختصر القول، إن حضرة الكليم سار في الركب المبارك من أرض السر إلى قلعة عكاء وقد حكم عليه، كما جاء في فرمان السلطان، بالسجن المؤبد أما هو فقد كرّس حياته في خدمة حضرة بهاءالله طوال أيام وجوده في السجن فائزًا باللقاء ليل نهار. وكانت تألفه جميع الأحباء إلى أن انتقل من هذا العالم الترابي إلى العالم العلوي الطاهر وهو في حالة التبتل والتضرع والابتهال.
وحدث، إبان وجود الجمال المبارك في بغداد، أن حضر إلى الساحة المقدّسة ذات يوم المدعو إيلخاني المشهور نجل موسى خان القزويني بصحبة جناب الحاج سيد جواد الطباطبائي الذي جاء ليلتمس الشفاعة لإيلخاني المسمى – علي قلي خان – من جمال القدم وقال: "يا مولاي، ولو أن علي قلي خان مذنب وكان طوال أيام حياته أسير
الشهوات غير أنه ندم على ما كان منه وجاء الآن إلى المحضر المبارك لإظهار التوبة والإقلاع عن الشهوات النفسانية وأنه بعد اليوم لا يتنفس نفسًا يخالف رضاء المبارك وإني ألتمس من مراحمكم قبول توبته وأن يكون بعد اليوم مشمولاً بألطاف الجمال المبارك". وما كاد يتم حديثه حتى تفضل جمال القدم بقوله: "بما أنك شفيعه لدينا فقد تغاضينا عن زلاّته وسأعمل على رفاهيته وراحته".
أما إيلخاني هذا فقد كان ذا ثروة طائلة غير أنه بددها على مشتهيات نفسه وهواه حتى بلغت به الحال إلى درجة أنه لم يجسر على مبارحة منزله مخافة أن يهجم عليه دائنوه. هذا، وقد أمره الجمال المبارك أن يذهب إلى والي الشام المدعو عمر باشا ويأخذ منه توصية إلى ذوي الشأن في إسلامبول ثم يذهب إليها. فصدع إيلخاني بأمر الجمال المبارك وتخلص من اليأس ودبّ في روعه عامل الأمل بعد القنوط ولقي من الوالي كل الرعاية وقصد الآستانه ولما وصل إلى مدينة دياربكر كتب إلى الجمال المبارك عريضة توصية بحق تاجرين من الأرامنة يقول فيها: "إن حاملَيّ هذه العريضة عازمان على السفر إلى بغداد وأنهما قد بذلا في حقي كل الرعاية وعملا على راحتي في دياربكر وقد طلبا مني توصية بحقهما لحضرتكم. فما رأيت من ملجأ سوى ألطاف المبارك، وإني ألتمس من ساحة الأقدس أن لا يحرما من عنايتكم". وكتب إيلخاني على المغلّف (الظرف) العنوان الآتي: "حضرة بهاءالله قدوة البابيين".
وقد سلّما هذه العريضة إلى الجمال المبارك فاستفسر حضرته عن حالهما، فقالا: "إن إيلخاني قد حدّثنا عن هذا الأمر بالتفصيل أثناء وجوده بدياربكر". ودعاهما حضرته إلى الدار المباركة ولما همّ حضرته
بالدخول إلى الحرم رأى جناب الكليم فقال له: "يا كليم، يا كليم، قد وصل صيت أمر الله إلى دياربكر" وكانت تلوح على طلعة المبارك علائم البشر والسرور المتناهي.
وخلاصة القول، إن حضرة الكليم كان الشقيق الصادق للجمال المبارك وكان مستقيمًا في جميع الأحوال. عليه التحية والثناء وعليه الروح والبهاء وعليه الرحمة والألطاف.
(35)الحاج محمد خان هو من أهالي سيستان (بشرق إيران) ومن عصبة المهاجرين والمجاورين وكانت هذه الذات المكرمة من أفراد الطائفة المعروفة بالبلوش وقد تلوّه وهو في عنفوان شبابه بمسلك العرفاء واندمج في سلكهم متفانيًا في الدروشة، ثم بارح مسقط رأسه طبقًا لقاعدة الدراويش للبحث عن المرشد الكامل. وكانوا يدعونه، على حسب مصطلح القلندرية، مشتاق پيرمغان (الإله الأكبر عند عبدة النيران). فساح في الأرض ونزل في شتى الأصقاع وجال في كثير من البقاع ولكنه لم يستشم رائحة محبة الله ممن لآقاه من العارفين والحكماء والشيوخ، يعني أنه لم ير في الدراويش غير لحىً مسترسلة ومذلة التكدّي والتسول. فطوى الأرض وهو في زي الدراويش وفي الحقيقة إنه لم يتقيد بما كانوا عليه، قانعًا بالقليل واختلط بالإشراقيين باحثًا عن ضالته فلم يعثر بينهم على شيء غير أقوال تافهة ومباحث غير مجدية وألفاظ مجوفة وعبارات مجازية غامضة. إن الحقيقة كانت مفقودة ودقائق المعاني معدومة لأن الحقيقة هي ما تحصل منها الفضائل أما الحكماء فأمْرهم بالعكس لأنهم عندما يصِلون إلى درجة الكمال يصبحون أسرى الرذائل ويتخبطون خبط عشواء جانحين إلى
ذميم الخصال عارين بالمرة عن المناقب الإنسانية. وطائفة الشيخية (التي أسسها الشيخ أحمد الأحسائي) قد تجردت عن جوهرها ونزلت إلى الحضيض وضاع من بينها اللباب ولم يبق غير القشور وركنوا إلى المسائل المحشوة بالترّهات.
لهذا ترى الحاج محمد خان، بمجرد استماعه للنداء الإلهي من الملكوت الأعلى، قال: "لبيك". ومر بنسيم البوادي وقطع المسافات البعيدة حتى طوحت به يد التسيار إلى سجن عكاء فوجد ضالته وفاز بشرف اللقاء وانجذب إلى الحضرة بمجرد مشاهدة الطلعة النوراء. وبعد ذلك عاد إلى إيران واجتمع بأرباب الطرق الصوفية وأصحابه السابقين من طالبي الحقيقة وأجرى بينهم ما فرضته عليه مقتضيات الوفاء والذمة.
والخلاصة، إنه صمم على أن لا ينفك عن رفاقه وعارفيه حتى يوصل إلى أسماعهم ترنمات الصُور السماوي ونغماته وما ألقى العصا ببلدته حتى هيأ أسباب الراحة والرفاهية لكل أقربائه حتى يعيشوا في كمال البهجة والفرح والسرور، وبعد مدة ودّع أولاده وزوجته وأهله وأقربائه وقال لهم لا تنتظروا عودتي ثم توكأ على عصاه وهام في الصحارى والوديان وأمضى زمنًا بين عارفيه الأقدمين من أهل مشربه. كان قد قابل بمدينة طهران إبّان سفرته الأولى، جناب ميرزا يوسف خان الملقب بستوفي الممالك، وبينما كانا يتحادثان في الأمر قال مستوفي الممالك المذكور: "إنني سأضع ميزانًا يفصل بين الحق والباطل كما يتخيل لي وهو أنني أطلب من صاحب الظهور أن أرزق بولد تفضّلاً منه، وإذا ما تمت هذه الموهبة أصير لا محالة مفتون الجمال المبارك وأسير حبه". فما كان من الحاج محمد خان إلا أن عرض ذلك في الساحة المقدّسة وسمع من الفم المبارك وعدًا صريحًا بإجابة ملتمسه. ولما عاد الحاج محمد خان وقابل مستوفي الممالك إبّان
سفرته الثانية وجد في حجر هذا الأخير طفلاً يداعبه فقال: "يا جناب الميرزا، الحمد لله قد تم الميزان الذي وضعته وأُعطيت مرسوم السعادة"، فقال المرحوم ميرزا يوسف خان: "إن البرهان قد اتضح لكل ذي عينين وحصل لنا الاطمئنان وإني أرجوك عندما تتشرف في بحر هذه السنة تطلب من عناية الحق أن يدوم هذا الطفل محفوظًا مصونًا في حمايته جلّ وعلا".
وبالاختصار، فقد ذهب الحاج محمد خان المذكور إلى سيد السعداء حضرة سلطان الشهداء والتمس منه أن يشفع له لدى الحضرة ليأذن له أن يكون حارس العتبة المباركة. فعرض سلطان الشهداء ذلك الملتمَس لدى الحضور المبارك وبالآخرة جاء صاحب الملتمَس إلى سجن عكاء ووفق إلى السكنى بجوار المحبوب الشفيق ردحًا من الزمن متشرفًا في أكثر الأوقات بالملآقاة كلما شرّف الجمال المبارك بستان المزرعة، واستمر ثابت القدم راسخًا على العهد والميثاق بعد صعود حضرة المقصود، روحي لتربته الفداء، بريئًا من أهل النفاق ثم انتقل من منزله إلى حظيرة القدس الموجودة في المسافر خانة أثناء غياب هذا العبد في الأقطار الأوروبية والأمريكانية إلى أن فاضت روحه وهو بجوار المقام الأعلى وطار إلى العالم العلوي. روّح الله روحه بنفحة مسكيّة من جنة الأبهى ورائحة ذكية من الفردوس الأعلى وعليه التحية والثناء. جدثه المنور بحيفا.
(36) جناب آقا محمد إبراهيم أميردخل في عداد المهاجرين والمجاورين جناب آقا محمد إبراهيم أمير وهذا الوجود المسعود من أهالي نيريز قد تملك منه حب محبوب القلوب العطوف، وهو شاب أمرد، ثم وقع بين أيدي المناوئين وأطبقوا عليه بعد حدوث الصدمات والحوادث المريعة في نيريز وعمد ثلاثة منهم على شد وثاقه بالقوة غير أنه تمكن من فك الوثاق واغتصب خنجر من أحدهم وتخلص من غائلهم وفرّ إلى العراق فتوفق إلى تحرير الآيات وخدمة العتبة المقدّسة، ولازم الحضور ليل نهار بكل ثبات واستقامة، وسار في المعيّة المباركة أثناء السفر من العراق إلى القسطنطينية ومنها إلى أدرنه فالسجن الأعظم. ثم تزوج من خادمة العتبة المباركة أمةالله – حبيبة – وزوّج ابنته – بديعة – للمرحوم آقا القهوجي وعاش في هناء ورفاه.
والخلاصة، إنه أمضى حياة طيبة ثابتًا على الوجه الأكمل، وبعد صعود مصباح الملأ الأعلى ألمّ به الضعف ووهن منه العظم وانتهى به الحال إلى ترك عالم التراب والانتقال إلى عالم الملكوت.
نوّر الله مضجعه بشعاع ساطع من الملكوت الأعلى. وعليه التحية والثناء. أما مزاره المنوّر العظيم فبعكاء.
(37) جناب آقا ميرزا مهدي الكاشانيإن جناب آقا ميرزا مهدي الكاشاني من عصبة المهاجرين والمجاورين. هذا الشخص المحترم من أهالي كاشان، درس في مستهل حياته على يد والده بعض العلوم والفنون حتى علا كعبه في قرض الشعر والإنشاء وحسن الخط المعروف عند الفرس ب الشكسته وامتاز بذلك بين أقرانه وكان مستثنىً بين الصبية. علم بظهور الحضرة منذ نعومة أظفاره واشتعل بنار محبة الله وأصبح من شراة يوسف الحقيقي وفي مقدمة طالبي الحق، واندمج في دائرة العاشقين وحرّك لسانه بالتبليغ ببيان بليغ في إثبات الظهور وهدى بعضهم إلى طريق مليك الهداية وعُرف في كاشان بأنه مفتون العشق الإلهي. وقد وجّه إليه عارفوه وغير عارفيه شديد اللوم والتأنيب وأصبح عرضة لشماتة عديمي الوفاء حتى قال بعضهم بأنه واله مجنون وقال آخرون بأنه سيئ الحظ وأخذ أهل الجفاء بمضغه بأفواههم والطعن فيه وصلّط عليه عمال السوء سوط العذاب. ولما أعيته حيلهم وضاق في وجهه الفضاء وقام المناوؤون على معاكسته ومحاربته هجر وطنه المألوف وسار إلى حيث مركز الإشراق بالعراق، وما أن وصل إلى ساحة المحبوب حتى اندمج في زمرة الأحباء ونقر على ناقور المحامد والنعوت بما استطاع من
نغمات حتى صدر له الإذن المبارك بالعودة إلى كاشان فذهب وآقام بها ردحًا من الزمن ثم هزّه عامل الشوق إلى المحبوب فلم يقوَ على طاقة الفراق فبارح بلده إلى العراق للمرة ثانية مصطحبًا أخته أمةالله المحترمة الحرم الثالث وآقام في بغداد في ظل العناية المباركة إلى أن تحرك الموكب المبارك من العراق إلى القسطنطينية فصدر له الأمر بالبقاء في بغداد للمحافظة على البيت. وكاد أن يحترق من نار الفراق، ولم يهدأ له بال ولم يذق للراحة طعمًا إلى أن استبعدته الحكومة إلى الموصل مع الأحباء بصفة أسرى منفيين ظلمًا وعدوانًا، فتراكمت عليه المِحن والبلايا ووقع أسير الأمراض والعلل ولكنه كان في منتهى الخضوع والتفاني لابسًا جلباب الصبر والتحمل، حامدًا شاكرًا وقورًا حتى عيل صبره ولم يعد في قوس تحمله من منزع. واشتد عليه ألم الفراق فطلب إذنًا بالحضور إلى الساحة المقدّسة فكان له ذلك، فتوجه إلى السجن الأعظم مأذونًا مأجورًا ووصله منهوك القوى، ضعيفًا نحيل الجسم من شدة ما لآقاه من وعثاء الطريق واقتحام المشاق. وكان الجمال المبارك في تلك الأثناء مسجونًا داخل القلعة ومعتقلاً في وسط القشلة (الثكنة) ومضى المذكور أيامًا في تعبٍ مضنٍ ولكنه كان في منتهى السرور، ناعم البال، واعتبر كل بلاءٍ عطاءً من ربه وعدّ التعب رحمة من عند الله، والنقمة عين النعمة لأن كل ما حدث له كان في سبيل الله وابتغاء مرضاته واستمر على ذلك أيامًا ثم اشتدّ عليه المرض وأخذ جسمه في الانحلال يومًا بعد يوم حتى التجأ إلى الله وطار إلى جوار الرحمة الكبرى.
أما هذا الشخص المكرم فقد كان محترمًا طوال أيام حياته ولم يركن في سبيل محبة الله إلى الظهور والافتخار، وتحمّل جميع ما
انتابه من بلايا ورزايا، ولم يجنح إلى الشكوى مما أصابه أبدًا وعاش راضيًا بقضاء الله سالكًا سبيل الرضاء والتسليم مشمولاً بنظر العناية والتقرّب من ساحة الكبرياء ولم يتغير حاله من بداية حياته إلى نهايتها إذ كان مستغرقًا في بحر الرضاء وكان دائمًا يقول: "ربِّ أدركني، أدركني" حتى أدركته المنيّة وصعدت روحه إلى جوار الحق.
عطّر الله مشامّه بنفحات القدس في الفردوس الأعلى، وسقاه شرابًا طهورًا في كأس كان مزاجها كافورا. وعليه التحية والثناء. أما رمسه المعطّر ففي عكاء.
(38)إن الخطاط الشهير – المير عماد الثاني حضرة مشكين قلم – هو من جملة المهاجرين والمجاورين والمسجونين. كان قلمه مسكيًا حقًا وجبينه منورًا بالنور المبين، يُعتبر في مقدمة العرفاء (العارفين بالله) والظرفاء، وقد بلغ صيت هذا العارف والسالك في سبيل الحق جميع الممالك، وكان في إيران بهجة الخطاطين ومحطّ سرورهم، معروفًا لدى الأكابر والأعيان، وله مكانة سامية لدى الوزراء والأمناء، وعمّت شهرته الفنية أنحاء بلاد الروم، وبهرت عقول الخطاطين مهارته في صناعة الخط وتحسينه إذ كان يتقن مختلف أنواعه، وكان في الكمالات نجمًا ساطعًا واعتنق الأمر بمجرد سماعه نداء الله في مدينة أصفهان، ومن ثمّ قصد مقام المحبوب وطوى الفيافي والقفار والتلال والوِهاد وركب متن البحار إلى أن وصل إلى أرض السرّ (أدرنه) قويًا في إيمانه متينًا في إيقانه فشرب صهباء الاطمئنان واستمع لنداء الرحمن وتمثّل بين يدي الجمال المحبوب ونال العروج إلى أوج القبول فثمل بنسيم العشق وهام من شدة الوله والشوق متيّمًا مفتونًا مضّى على هذا الحال زمنًا بجوار الساحة المقدّسة موْرِدًا للألطاف يومًا بعد يوم قائمًا بزخرفة اللوحات الخطية وتنميقها وكان يكتب الاسم الأعظم "يا بهاء الأبهى" على جملة أشكال وأوضاع وغاية في الإتقان ويبعث به إلى كل الأقطار. وبعد ردح من الزمن، صدر له الأمر بالسفر إلى اسلامبول
برفقة المدعو السياح، وما أن وصل إلى تلك المدينة العظمى حتى أخذ جميع أكابر الإيرانيين والعثمانيين في تقديم الاحترام الكلي له وأصبحوا مغرمين بخطه المسكي. أما هو فقد حرّك لسانه بالتبليغ غير هيابٍ ولا وجل، غير أن سفير دولة إيران كان له بالمرصاد وألصق به التهمة لدى الوزراء مؤكدًا لهم أن حضرة مشكين قلم شخص موفد من قبل حضرة بهاءالله ليبث روح الفساد في هذه المدينة فضلاً عن إيقاد الفتنة وإثارة الخواطر والضوضاء. وما فتئ السفير المذكور يسخّر أعوانه بهذا الصدد ويقول إن البهائيين يشتغلون خفية بدس الدسائس في الأقطار العثمانية وما جاءوا إلى هذه العاصمة إلا لهذا الغرض بعد أن جعلت حكومة إيران عشرين ألفًا منهم طعمة للسيف ليحطموا عوامل دسائسهم والآن فليكن معالي وزراء مملكة آل عثمان متيقظين وعلى بيّنة من أن نار الفساد ستشتعل عما قريب في هذه الديار وتأتي على الحرث والنسل وتصبح البلاد في حالة اضطراب لا ينادى وليدها، فالفرصة اليوم سانحة لإبادتهم.
والحال، أن ذلك المظلوم (مشكين قلم) كان يشتغل بفن الخط في عاصمة ملك الروم واشتهر بين القوم بالتقوى والتعبد والسعي في الإصلاح قدر الطاقة، مجتهدًا في تأليف القلوب بين أرباب الأديان المختلفة ورفع التنافر الموجود بين الغرباء عاملاً على تربية أبناء وطنه وكان ملجًا للمساكين والمحتاجين، كنزًا للمعوزين، مرشدًا للتائهين، هدفه وحدة العالم الإنساني، لم تتطرق إلى قلبه العداوة ولم يجنح إلى البغضاء.
أما سفير إيران بالآستانة فكان ذا نفوذ عظيم وعلاقته بالوزراء متينة، فأثّر على جمع غفير من البارزين في العاصمة التركية ليحضروا
المجالس والمحافل وينسبوا لأفراد الجامعة البهائية كل فِرْيَة مما أدى بالجواسيس ليحيطوا بجناب مشكين قلم من كل ناحية وبإشارة من السفير قدّم المناوؤون والمغرضون اللوائح البهتانية في حقه لأولي الشأن بإيحاء من سفير إيران المذكور بأن مشكين قلم يشتغل بإشعال نار الفتنة والفساد في البلاد وبأنه طاغية باغية عدوّ للدولة وعاصٍ عتيد. فسبب ذلك في اعتقال مشكين قلم وأدخلوه في عداد المسجونين واستبعدوه إلى غليبولي ومنها إلى جزيرة قبرص ثم إلى سجن عكاء بعد أن أمضى في الجزيرة في قلعة ماغوسا مدة من سنة 1285 إلى سنة 1294 هجرية، وبعد أن خرجت قبرص من يد الأتراك تخلّص من الأسر وآقام أيامًا في ظل عناية الجمال المبارك مشتغلاً بفنه الذي برع فيه في كتابة لوحاتٍ وتنميقها بكمال الإتقان وإرسالها إلى مختلف الأصقاع وعاش في هناء ورغد من العيش مشتعلاً كالشمعة بنار محبة الله سلوة لخواطر جميع الأحباء. واستمر بعد صعود المقصود ثابتًا راسخًا على العهد والميثاق بدرجة لا تضارع، وكان كالسيف المسلول على رقاب الناكثين، لم يجنح إلى المداراة ولا المواربة والمحاباة، صارفًا دقائق حياته في صادق الخدمات غير مقصّر في جميع الموارد بهذا الصدد. ثم سافر إلى بلاد الهند بعد الصعود المبارك بمدة واندمج في زمرة من كانوا على شاكلته في العبادة والانقطاع عما سوى الله حينًا من الدهر تتجدد همّته يوما بعد يوم إلى أن وصل إلى هذا العبد (حضرة عبدالبهاء) خبر ضعفه ووهنه فأرسلت إليه ليحضر. فعاد إلى هذا السجن الأعظم وسعدت بقدومه قلوب الأحباء، وابتهجت منهم الأفئدة، وكان للجميع رفيقًا أنيسًا في كل آناته، مترنمًا بالنغمات الشجية، منجذبًا إلى الحق كل الانجذاب، جامعًا للفضائل متحليًا بأحسن الخصال، مؤمنًا موقنًا مطمئن النفس،
زاهدًا في الدنيا، ذكي الطباع، لذيذ المشرب، حلو الحديث، وعلى خلق عظيم، يتضوّع عرف شذاه كأوراد الرياض الغناء، نديمًا لا يضارع، وقرينًا لا مثيل له في محبة الله. ترك كل نعيم وأغمض عينيه عن أسباب العزّة الدنيوية لم يركن إلى الراحة واللهو ولم يطلب الثراء ولم يتشبّث بشيء من الأشياء جاعلاً ديدنه حثّ ذويه على ترتيل الآيات والتضرع إلى ذي الجلال في جميع الأوقات وانجذابه جعله هيكلاً مجسمًا لمحبة الله، بشاشته لا تنقطع، وكان في الصداقة والمودة لا نظير له، صبورًا حمولاً للغاية فانيًا نفسه بالكلية وباقيًا بالنفس الرحمانية. ولو لم يكن مفتون الجمال المبارك وقلبه متعلّقًا بملكوت الجلال لتيسّر له كل رفاه، حيث كان رأس ماله العظيم تفننه في كثير من أنواع الخطوط مما لم يسبقه أو يجاريه في مضمارها أحد. والفضائل التي كان متحليًا بها سببت احترامه لدى الأمراء وغيرهم، وهيامه وانجذابه إلى المعشوق الحقيقي جعلاه ينزّه نفسه عن جميع القيود طائرًا في الأوج غير المتناهي وفي النهاية انتقل، أثناء تغيب هذا العبد (عبدالبهاء) من هذا العالم الضيق الظلماني إلى العالم الفسيح النوراني وتمتع بالفيض اللامتناهي بجوار الرحمة الكبرى. عليه التحية والثناء، وعليه الرحمة الكبرى من الرفيق الأعلى.
(39) جناب الأستاذ علي أكبر النجارالأستاذ علي أكبر النجار هو من زمرة المهاجرين والمجاورين، وكان السبّاق بين الأخيار ومن قدماء الأحباء في إيران ومن أجلّة الأصحاب، رفيقًا صدوقًا يترنّم بشجيّ الألحان على علم بالحجج والبراهين الأمرية متتبعًا لآيات النور المبين ومن سجاياه قرض الشعر، وقد جادت قريحته الوقادة وفكره السيال بعدة قصائد في محامد الجمال المبارك وكان في صناعة النجارة لا يجارى، وماهرًا فيها، وقد أبرز الكثير من مصنوعاته الدقيقة وشبّهوه بالصائغ الذي يحكم صنع الخواتيم، فضلاً عن ضلوعه في العلوم الرياضية وله فيها ملاحظات دقيقة.
وبالإجمال، كان هذا الشخص رفيع المقام من أهالي يزد وسافر إلى العراق وتشرّف بالمثول بين يدي الحضرة وفاز فوزًا عظيمًا وشمله الفيض المبين والعنايات الفائضة من ساحة الجمال المبارك بدرجة يغبط عليها وكان يحظى باللقاء في أكثر الأيام وهو من عصبة الذين تم نفيهم من الزوراء إلى الحدباء (الموصل) ولاقى من وعثاء الطريق ما لاقى وتحمل المتاعب والمشقات وساوره شظَفُ العيش زمنًا ليس بالقليل، وكان يمارس القناعة قدر المستطاع، دائم الشكر والتبتل والتضرع والابتهال. ثم انتقل من الموصل إلى السجن الأعظم واشتغل
بالتذكر وتلاوة الأنجية في جوار الروضة المقدّسة وكان يحي لياليه بالالتماس وطلب العفو والمغفرة من ساحة ذي الجلال بقلب مشتعل بنار الحب، وعين دامعة وكان منقطعًا عن عالم التراب يتمنى الصعود من هذا العالم راجيًا من الحق الأجر والثواب لأنه لم يطق فراق نيّر الآفاق. واشتاق إلى جنة اللقاء ومشاهدة أنوار الملكوت الأبهى فاستجاب الله دعاءه وصعدت روحه إلى العالم الأبهى – محفل تجلي رب الأرباب .
عليه صلوات الله وسلامه، وأدخله الله في دار السلام بقوله تعالى: "ولهم دار السلام عند ربهم والله رؤوف بالعباد".
(40) جناب آقا شيخ علي أكبر المازگانيفي عداد المهاجرين والمجاورين، كان جناب آقا شيخ علي أكبر المازگاني، وهذا الشخص يعتبر في مقدمة الأحرار وقائد عصبة العاشقين الهائمين. رضع لبن الأمر من ثدي العناية منذ نعومة أظفاره وهو نجل حضرة الفاضل الجليل الشيخ المازگاني الرجل الطاهر النزيه الذي هو من مشاهير مقاطعة كاشان ولا نظير له في الزهد والتقوى، جامع لمحاسن الأخلاق والأطوار المألوفة وخير الطباع ويشهد بذلك العموم واشتهر بحلاوة مشربه بين الناس. خلع العذار في محبة الله وكشف الأسرار فتحفّز عديمو الوفاء من معارفه وغيرهم على قتله. أما هو فقد اشتغل مدة بترويج الدين المبين وجذب قلوب العالم ولم يلقَ زائروه غير الحفاوة والكرم، وما زال ينسج على هذا المنوال حتى طرق صيت إيمانه وإيقانه أسماع أهل الحلّ والعقد فقام أعوانهم بالتطاول عليه حتى أسقوه كأس الشهادة ظلمًا وعدوانًا، فمات ذلك الرجل الجليل في سبيل الرب الجميل.
أما ابنه العزيز المحبوب لم يطق الآقامة في تلك الديار مخافة أن يصبح، بعد استشهاد والده المبرور، طعمة لسيوف الأعداء، فرحل إلى العراق حيث فاز بشرف اللقاء حينًا من الدهر ثم قفل راجعًا إلى إيران.
وما لبث أن عاوده الشوق واشتعلت فيه النار لمشاهدة المحبوب، فتأبّط جعبته واصطحب زوجته وطوى هو وحرمه الهضاب والوهاد، طورًا راكبين وطورًا سيرًا على الأقدام، حتى أكلت أقدامهما الرمضاء في الوعور والسهول والسواحل حتى ألقيا عصاهما في البقعة المباركة وحلاّ مكان الأمن والأمان في رحاب الحق في هناء وروح وريحان. وقد استمر ذلك الحبيب ثابتًا راسخًا على العهد والميثاق بعد صعود طلعة المقصود، روحي لأحبائه الفداء، مغمورًا بفيض رحمة الرحمن وكان من سجاياه نظم القريض فنظم من شدة اشتياقه وهيامه بالمحبوب عدة قصائد غراء ومقطّعات غزلية في حبه لمحبوب القلوب وكان لسان حاله يقول:
ولو أني عارٍ عن السجع والقوافي غير أن فكري دائمًا في حبيبي
واشتياقي لطلعة المحبوب عين زخري بل ومسكي وطيبيوعلى الجملة، فقد صعد هذا الشيخ إلى عالم الرب الغفور، فرحًا مسرورًا محترقًا بنار الشوق، ونصب خيمته الأبدية في العالم العلوي. أمطر الله على جدثه الوابل الهطال من ملكوت الغفران، ومتّعه بالفوز العظيم في فردوس الجنان، وأفاض عليه سجال الرحمة في جنة الرضوان.
(41) جناب آقا ميرزا محمد خادم المسافر خانةإن الشاب الإلهي، جناب آقا ميرزا محمد خادم المسافر خانة، هو من أهالي أصفهان ومن المهاجرين والمجاورين. وقد اشتهر وهو في ريعان شبابه بين العلماء بأنه حاضر الذهن، شديد الذكاء، وكان من ذوي البيوتات، محترمًا بين القوم، نجيبًا فطنًا مجدًا ومجتهدًا في تحصيل العلوم والمعارف وعلى قسط وافر من العلوم والفنون المتنوعة والمعقول والمنقول، وكان فضلاً عن كل هذا، متلهفًا إلى الارتواء من مَعين أسرار الحقيقة طالبًا لمعرفة الأحدية، ولم يطفئ زلال العلوم والفنون والمعارف، حرارة عطشه مع شدّة بحثه وتنقيبه في مجالس العلماء والفقهاء، إلى أن تحقق كل ذلك وظهر السرّ المكنون والرمز المصون لائحًا واضحًا فتعطرت مشامه من نفحة جنة أوراد الأبهى وتنور قلبه وروحه بسطوع أشعة شمس الحقيقة فوصل الحوت الظمآن إلى عين الحياة وعكفت الفراشة المشتاقة المتهافتة على الشمعة الموقدة فأحيت البشارة الكبرى روح ذلك الطالب الصادق واستنار قلبه بضياء نور صبح الهدى وأوقدت فيه نار المحبة بدرجة جعلته يعوف هذا العالم وما فيه من نعيم موفور وراحة كبرى وأخيرًا هرع إلى السجن الأعظم (عكاء).
كان هذا الشخص في أصفهان يعيش في هناء ورفاه ورخاء مسرورًا قرير العين غير أن شوقه للّقاء حفزه على التخلص من كل قيد وقطع
المسافات البعيدة غير عابئ بما لآقاه من وعثاء الطريق والمتاعب ومشقة الأسفار واستتب به الرحيل إلى الهدوء والسلام في السجن الأعظم، وقام على عبوديته للجمال الأبهى وداوم على خدمة الأحباء وبعد أن كان مخدومًا أصبح خادمًا، وأصبح عبدًا بعد أن كان سيّدًا، وأسيرًا بعد أن كان قائدًا، لم يذق للراحة طعمًا في كل آناته. وأصبح كهفًا لجميع المسافرين ومؤنسًا عديم النظير للمجاورين يعمل فوق طاقته جائش الحميّة في محبة الأحباء واكتسب محبة المسافرين والمجاورين ورضاهم ساكتًا صامتًا حال تأدية خدماته.
واستمر على هذا الحال إلى أن وقعت المصيبة الكبرى فانهار بنيان صبره واستقراره وأحرقت نار الفراق قلبه، فكان لا يهدأ ليلاً ولا نهارًا مضيئًا كالشمعة المشتعلة فأثرت فيه شدة الالتهاب ووصلت ناره إلى قلبه وكبده فخارت قواه ولم يعد يتحمل ما هو فيه فجنح إلى التضرع والتبتل ليل نهار متمنيًا أن يطير إلى عالم الأسرار ويقول: "رب أدركني، أدركني من هذا الفراق وجرعني كأس الوصال، وأجرني في جوار رحمتك يا رب الأرباب" إلى أن أدركه الحال فطار إلى العالم العلوي غير المحدود. هنيئًا له هذه الكأس الطافحة بموهبة الله، مريئًا له هذه المائدة التي هي حياة للقلوب والأرواح. متّعه الله بالورود على الورد المورود، ورزقه الحظ الموفور من الرفد المرفود.
(42)كان ضمن الأسرى الذين نفوا من الزوراء إلى الحدباء، جناب آقا ميرزا محمد الوكيل. وهذه النفس الزّكيّة تجرعت كأس التسليم والرضاء في دار السلام، ومكث في ظل شجرة الطوبى آمنًا مستريحًا وأمينًا كريمًا موصوفًا بالغيرة والهمة في تسيير الأمور بدرجة لا مثيل لها وذاع صيته بين القوم بالعراق، على الأخص بحسن التدبير. ولما دخل الإيمان والإيقان في قلبه لُقِّبَ بالوكيل الممتاز والسبب في منحه هذا اللقب هو أنه كان في بغداد شخص مشهور اسمه الحاج ميرزا هادي الجواهرجي وله ابن عزيز يدعى آقا ميرزا موسى، الذي لقبه القلم الأعلى بحرف البقاء، وهذا الأخير آمن بالأمر ثابتًا راسخًا في معتقده وكان أبوه شخصًا مهيبًا وفي عظمة الأمراء معروفًا في بلاد إيران وبلاد الهند بالجود والسخاء والبذل والعطاء والإنفاق عن سعة. أصله من وزراء إيران، ولكنه لما شاهد أن المرحوم فتح علي شاه ميالٌ لجمع الأموال واغتيال أموال الوزراء والاستيلاء على ما لديهم من حطام الدنيا طوعًا وكرهًا ويُعِدّ من أظهر عدم تنفيذ رغائبه من ذوي الجرائم التي لا تغتفر، بادرَ لخوفه من هذه الورطة إلى ترك الإمارة والوزارة وذهب إلى بغداد. فطلب فتح علي شاه من والي بغداد المدعو داود باشا أن يُعيده إلى إيران، أما الوالي المذكور فكان ذا شهامة وغيرة، فلم يلبِّ طلب شاه إيران، وعمل كل ما في وسعه لرعاية واحترام الحاج المذكور الذي اشتهر بحسن التدبير، واشتغل بتجارة المجوهرات
واشتهر بالجواهرجي ولكنه كان يعيش عيشة الملوك في قصورهم، وهذا الشخص كان من نوادر الدهر إذ كان يعيش في مقرّه بكل عزة ومكنة ولكنه ترك الخدم والحشم وآثر العمل بالتجارة وكسب المنافع الكلية وكان باب داره مفتوحًا على مصراعيه للزائرين والقاصدين من الغرباء والأقربين على السواء، غوثًا للمحتاجين حين يستقبل زائريه على اختلاف طبقاتهم بكل ترحاب وإعزاز، وكان أغلب أكابر الإيرانيين ينزلون ضيوفًا عليه عندما يأتون في مواسم حجهم لزيارة أضرحة الأئمة المكرمين وكان مصفوفًا على موائده ما تشتهيه الأنفس من فاخر الطعام المتنوعة وأصنافه، وكان القوم يقدّمون له عظيم الاحترام أكثر من الصدر الأعظم بمراحل، وفاق احتشامه جميع الوزراء وعلى الأخص في العطاء والقِرى والبذل والسخاء المتزايد يومًا إثر يوم حتى أصبح مفخرة الإيرانيين في العراق وعمّت إنعاماته مواطنيه بل وزراء آل عثمان والمشيرين في دولتهم حتى أكابر القوم في بغداد هذا فضلاً عن رجاحة عقله وعظم تدابيره للأمور مهما عظمت.
وعلى الرغم من أن تجارة الحاج المشار إليه قد أصبحت لكبر سنه في ارتباك، غير أنه لم يطرأ على معيشته أدنى تغيير أو تبديل أبدًا وعاش معزّزًا محتشمًا مع أن أمواله قد ذهبت ديونًا على أكابر القوم وعظماء أهل البلاد ولم يؤدّ واحد منهم ما عليه من الديون بالمرة. ومن جملة من استدانوا منه والدة آقا خان المحلاتي بمبلغ لا يقل عن المائة ألف تومان ولم تؤدِّ منها فلسًا لأن المنيّة وافتها بعد فترة قصيرة وماتت والدّيْن في ذمتها، وعدة أشخاص أُخر كقائد الجيوش المدعو علي قلي خان وسيف الدولة نجل فتح علي شاه والسيدة والية كريمة الشاه المذكور وغيرهم من الأكابر والأعيان والإيرانيين وأمراء آل عثمان وأعاظم أهل العراق. وبالاختصار، إن كل هذه الديون قد أُكِلت عن آخرها مع كل
هذا لم تتغير حال ذلك الأمير الكبير أكان ذلك في المعيشة أو البذل والسخاء والكرم. وتضاعفت محبته للجمال المبارك في أواخر أيام حياته بدرجة تسترعي الأنظار، وكان يحضر للتشرف في المحضر المبارك بكل خضوع وخشوع. ومما لا أنساه أنه قد حضر ذات يوم إلى الساحة المقدّسة وقال: "قد تصادف أنني بينما كنت في رحلة إلى زيارة العتبات المقدّسة (أضرحة الأئمة من آل بيت الرسول) بعد عام 1250 بقليل وإذا بالمنجّم المشهور ميرزا موكب يفاجئني بقوله: "يا جناب الميرزا، إنني أرى في النجوم قرآنًا عجيبًا لم يشاهد له نظير قبل اليوم، وهذا دليل على ظهور أمر عظيم ومما لا شك فيه أن هذا الأمر العظيم هو ظهور القائم (المهدي) الموعود".
وما عتم الحاج المذكور أن قضى نحبه تاركًا ولدًا وبنتين ورّاثًا له وظنّ الناس أن ثروته باقية على ما كانت عليه، ولم يشكّ أحد في ذلك لما شاهدوه منه طوال أيام حياته مما حرك ثائرة الطمع في أذهان القائم بأعمال القنصلية الإيرانية وزمرة مجتهدي آخر الزمان وقاضي الشرع عديم الإيمان، فألقوا العراقيل بين الوراث وأوجدوا بينهم روح العداء والخلاف والتنافر وتمكنوا بذلك من التدخل في أمورهم بالكلية وعملوا على تقويض دعائم ثروتهم لسد أطماعهم وأنشبوا مخالبهم في التركة حتى وقع الورثة في مخالب الفاقة والفقر المدقع حفاة عراة بعد أن استولى على أموالهم كل من القائم بأعمال القنصلية الإيرانية والمجتهدين والقاضي الشرعي.
أما ابن المرحوم المدعو حرف البقاء وهو ميرزا موسى كان شخصًا مؤمنًا وموقنًا ونفسًا مطمئنة غير أن أختيه كانتا لأبيه ولم تعلما عن الأمر شيئًا. ذات يوم ذهب هاتان الأختان مع المدعو ميرزا سيد رضا المرحوم وهو أحد أصهارهما إلى دار المبارك ودخلتا إلى الحرم وأبقتا الصهر المذكور خارج البيت في انتظارهما ثم عرضتا في الحضور
المبارك: "إن القنصل والمجتهدين وقاضي الشرع قد خرّبوا دارنا وبدّدوا أموالنا وأن والدنا المرحوم كان لا يعتمد في أواخر أيام حياته إلا المقام المقدّس (الجمال المبارك) ولو أننا قد غفلنا وتأخرنا عن الالتجاء إلى مقامكم المقدّس فها نحن الآن جئناكم لاجئين ملتمسين العفو عن قصورنا آملين أن لا تخيّبوا رجاءنا وتشملونا بعنايتكم وتصونونا في كهف حمايتكم وتنقذونا من هذا الخطر الشديد الداهم بأن تعيروا أمورنا ومطالبنا جانب النظر ولا تنظروا إلى قصورنا."
فأجابهم الجمال المبارك بشكل قاطع بأنه ينفر من التدّخل في مثل هذه الأمور. أما هما فقد تشبثا بذيل حضرته وألحّا في طلبهما ولم يتركا البيت المبارك مدة أسبوع كامل، تصيحان في كل صباح ومساء طالبتين الأمان في جنابه قائلتين: "إننا لا نبرح داركم أبدًا، لأنا عاكفتان على رحابكم مرتميتان على أعتابكم المقدّسة، واقفتان على عتبة الملائكة الحافظين حتى تنظروا في أمرنا وتخلّصونا من يد الأعداء الظالمين".
أما الجمال المبارك فكان يكرّر على مسامعهما نصحه بأن هذه الأمور ترجع إلى الحكام والمجتهدين، ولا دخل لحضرته بشأنها. أما هما فلم تكفّا عن الإلحاح في هذا الصدد بكل إصرار مستدعيتين نظر عنايته بشأن مطالبهما. ولما كان البيت المبارك خلوًّا من حطام الدنيا في ذلك الحين فقد قنعتا بالخبز والماء والطعام الذي كان يجهز بالدّيْن، وبالاختصار إن الأمور كانت معقدة من جميع الوجوه. وفي النهاية طلبني الجمال المبارك ذات يوم وتفضل بقوله: "إن هاتين المخدرتين قد أثقلتا علينا من كثرة إلحاحهما، ولا حيلة غير أنك تذهب وتنهي هذه المسألة المهمة في يوم واحد". فتوجهت، امتثالاً للأمر المبارك،
في صبيحة اليوم التالي مصطحبًا جناب الكليم إلى بيت المرحوم، وأحضرنا أرباب الخبرة وجمعوا جميع المجوهرات في غرفة على حدة ووضعوا دفاتر الأملاك في غرفة وبقية الأشياء ذات القيمة في غرفة ثالثة، وقام نفر من بائعي المجوهرات بتثمين الموجود منها وقام أرباب الخبرة بتثمين البيوت والحوانيت والبساتين والحمامات. أما أنا فقد تركت الخبراء والمثمّنين وتوسّدت من شدة التعب مضجعًا بعد أن وضعت في كل غرفة شخصًا ليراقب الأعمال بكل دقة، وما أن انتصف النهار حتى كان كل شيء قد انتهى. وبعد تناول طعام الغداء أبدى أرباب الخبرة رأيهم بتقسيم التركة إلى قسمين واحد منهما للبنتين والآخر لجناب حرف البقاء بطريقة الاقتراع. وبعد أن اضطجعت قليلاً وشربنا الشاي قرب العصر دخلت داخل الحرم فوجدت أن التركة قد قسمت إلى ثلاثة أقسام! فسألت عن السبب في ذلك التقسيم، وأبديت بأنني أُخبرت بتقسيم التركة إلى قسمين فقط فأجاب جميع الوراث والمتعلقين في نفس واحد قائلين: "لابد من ذلك إذ رأينا أن يُعطى الثلث لجناب حرف البقاء والثلث الثاني للبنتين والثلث الأخير يوضع تحت تصرف حضرتكم، إذ رأينا أن يكون ثلث مال الميت تحت تصرفكم على الوجه الذي ترونه. فأغضبني ذلك جدّ الغضب وقلت: "إن هذا لا يمكن أبدًا، ومن باب أولى أن تُغلقوا هذا الباب إذ يستحيل أن أجري ما تقولون وقسمًا بالجمال المبارك إنني لا أقبل فلسًا واحدًا. فأقسموا هم أيضًا بأنهم لا يرضون إلا بما أقروه ولا يقبلون غيره. فقال لهم هذا العبد (عبدالبهاء): "دعونا من ذلك، فهل لديكم شيء آخر؟" فقال جناب حرف البقاء: "أين النقود؟ وسأل عن مقدارها؟ فقيل إن النقود لا تقل عن ثلاثمائة ألف تومان. قالت الكريمتان: "إن النقود،
إما أن تكون داخل صندوق في نفس البيت وإما أن تكون مدفونة في الأرض أو في الخارج أمانة عند أحد، فنحن نسلّم الدار بأجمعها إلى جناب الميرزا ونخرج بعباءاتنا فقط فإذا عثر حضرته على شيء من النقود فهي هبة منا له وأما إذا كانت النقود مودعة بصفة ما عند بعضهم وإذا شعر المؤتمن على المال بما حدث فكيف يقرّ بالمبلغ المودع عنده أو يعيده إلينا وإنه لا شك أنه سيستولي عليه، وعلى جناب الميرزا توضيح هذه المسألة المعقّدة وغير المثبوتة. فقال جناب حرف البقاء إن جميع الأموال كانت مسلّمة للكريمتين ولم أعلم عنها شيئًا بالمرة ومجرد الادعاء لا يثبت الحق إذ ليس هناك دليل واضح يمكن الاستناد عليه وقال إن الحاج المرحوم ربما لم يكن لديه نقود بالمرة.
أخيرًا لاحظ هذا العبد (عبدالبهاء) أن ليس هناك برهان قاطع في هذه الدعوى وأن الإلحاح في الموضوع لا يسبب غير الأسف ولا ينتج شيئًا ولهذا رأيت أن تعمل قرعة بخصوص الثلث المنوه عنه وفي النهاية وضعناه في غرفة على حده وأغلقنا بابها وختمناه بالشمع الأحمر وأخذت المفتاح للحضور المبارك وعرضت على حضرته أن العمل قد انتهى وما ذلك إلا بتأييد الجمال المبارك وإلا كان الحال يستلزم حوْلاً كاملاً على الأقل وشرحت بتفصيل كل ما حدث من الإشكالات والادعاءات وفقدان البينات وبأن حضرة حرف البقاء أثقلت كاهله الديون وأن ما خصه من التركة لا يفي بأدائها ومن المستحسن، إذا وافقت الحضرة، قبول ملتمس الورثة في مسألة الثلث. فقبل حضرته ذلك بعد الإلحاح الزائد ثم وهبه لجناب حرف البقاء لعله يتمكن من التخلص مما عليه من الديون ويستعين بما يتبقى على عيشة وما يحتاج إليه.
وفي اليوم التالي، حضر جميع الورثة إلى الساحة المقدّسة ورجوا أن أقبل ذلك الثلث. فتفضل جمال القدم بأن ذلك من المحال فألحوا
أن يقبله حضرته ليصرفه بمعرفته في الأمور الخيرية. فقال حضرته: "أما أنا فأرى صرف هذا المبلغ في مورد واحد" فقالوا إنهم لا يعارضون في ذلك حتى ولو قذفه حضرته في اليم، ولا يرجون إلا قبول ملتمسهم. فقال حضرته: "إنني قبلت هذا الثلث ووهبته لحضرة حرف البقاء بشرط أن لا يدّعي شيئًا بعد ذلك". ثم قام جميع الورثة بأداء عظيم الشكر لحضرته وانتهت القضية في يوم واحد بكل راحة وهدوء ولم يبق هناك ادعاء ولا ملاحقة. بعد ذلك رأى حضرة حرف البقاء أن يقدّم للحضرة بعد المجوهرات بصفة هدية فلم يقبل حضرته ذلك، فالتمس من الجمال المبارك قبول خاتم ذي فصّ من الياقوت الرماني الحبابي نادر المثال خال من العيوب مرصعة أطرافه بالماس غالي الثمن فلم يقبل حضرته ذلك أيضًا مع أن حضرته في ذلك الحين كان لا يملك عباءة واحدة بل كان يرتدي قفطانًا مصنوعًا من القطن أكل عليه الدهر وشرب ولا يملك فلسًا واحدًا على حدّ قول حافظ الشيرازي (الشاعر المشهور) ما معناه:
الكنز في الكم لكن كيسي من الدراهم خالومجمل القول، إن جناب حرف البقاء قدّم كل ما يملك من عقار وبساتين وأملاك وأراض للجمال المبارك والتمس قبولها فلم يقبل حضرته، فتوسل حرف البقاء بعلماء بغداد لدى حضرته فحضر جميعهم إلى الساحة المقدّسة ورجوا قبول ذلك فأبا حضرته فألحّوا وألحَفُوا إن حضرة حرف البقاء سيبدّد كل ما يملك في قليل من الزمن ومن باب أولى أن لا يتصرّف هو في كل ما يملك وقدّموا للحضرة صك الهبة بخط حرف البقاء من نسختين بالفارسية والعربية طبقا للمذاهب الخمسة، وفي ذيل ذلك الصك تواقيع وأختام العلماء في مدينة بغداد بصفة شهود ومن جملة العلماء كان عبدالسلام
أفندي العالم النحرير والسيد داود أفندي الفاضل الشهير. أما الجمال المبارك فقد تفضل بقوله: "إننا قد جعلنا ميرزا موسى وكيلاً عنّا في هذا الأمر". وبعد أن شرف الجمال المبارك إلى الروملي (أدرنه) ألزمت الحكومة جناب حرف البقاء بدفع أعشار إقليم هندية الذي هو بالقرب من بغداد وهو من ممتلكاته وكان هو وقتئذ في حالة إعصار فحلت به من جراء ذلك خسائر فادحة تقدر بمائة ألف تومان حيث عجز عن دفعها. فوضعت الحكومة يدها على أملاكه وباعتها بأبخس الأثمان، وقد عرض هذا الأمر على الجمال المبارك فأمر حضرته أن يضعوا هذا الأمر في زوايا الكتمان وأن لا يأتي ذكر ما يحل بهذه الأملاك على لسان أحد. وفي تلك الأثناء، وقع حادث النفي من أدرنه إلى عكاء وقام جناب آقا ميرزا محمد بإخبار الحكومة أن حرف البقاء ليس بمالك وأنا الوكيل إذ الأملاك تتعلق بحضرة جمال القدم فكيف تضع الحكومة يدها عليها وحيث أنه لم يكن في يده صك الهبة بأنه كان في عكاء فرفضت الدعوى، واشتهر باسم ميرزا محمد الوكيل وهذا سبب تلقيبه بالوكيل.
أما الخاتم الذي فصّه من الياقوت فقد أرسله إلينا حضرة حرف البقاء ونحن في أدرنه بواسطة المدعو سيد علي أكبر، فأمر الجمال المبارك بقبوله. وعندما وصلنا إلى عكاء مرض من كان معنا من الأحباء بدرجة أعيتهم عن الحراك من شدة المرض، فأرسل هذا العبد (عبدالبهاء) الخاتم المذكور إلى أحد الأحباء في بلاد الهند ليبيعه ويوافينا بثمنه بكل سرعة ممكنة لكي نصرفه على المرضى. أما الحبيب المذكور، فلم يوافِنا بفلس واحد من ثمن الخاتم ثم كتب لنا بعد عامين كاملين أنه قد باع الخاتم بمبلغ خمسة وعشرين جنيها، وصرفها
على الزائرين مع العلم أن الخاتم يقدّر بأكثر من ذلك بكثير وأما هذا العبد (عبدالبهاء) فلم يلجأ إلى الشكوى بل شكر الباري على ما وقع حيث لم يتلوث ذيلنا بغبار تلك الأموال. وبعد كل هذا، وقع جناب ميرزا محمد الوكيل أسيرًا ونفوه إلى الحدباء (الموصل) فوقع في المتاعب الشديدة من شدة الفاقة إذ كان غنيًا فأصبح فقيرًا وكل ذلك في سبيل الله، وكان في أتم الراحة فوقع في الشقاء في سبيل الله أيضا، ومضى بقية أيامه في بلدة الموصل بغاية التذلل والتبتل إلى أن صعد من هذا العالم الظلماني إلى العالم النوراني وهو في كمال الانقطاع عما سوى الله، وفي نهاية الانجذاب بنفحات الله.
عليه التحية والثناء وفتح الله على ترابه أبواب السماء بماء منهمر من العفو والغفران.
(43)جناب الحاج محمد رضى الشيرازي، هو أحد المهاجرين والمجاورين وهذا الشخص الرباني من أهالي مدينة شيراز. وكان مظهرًا للإيمان والإيقان بعجز وانكسار متناهيين، وبغاية الاطمئنان سرع إلى ظل العناية الربانية بمجرد ارتفاع النداء وهو ألسْت (بربكم) إذ قال – بَلَى – فأصبح مشكاة مصباح الهدى وفي غاية التبتل والابتهال ووُفق لخدمة أحد أفنان السدرة المباركة المدعو الحاج ميرزا محمد علي مدة طويلة وكان أنيسًا ومجلسه لا يمل ولا يرجو غير الخير للجميع. ثم طوّحت به يد الأسفار إلى مختلف الأقطار إلى أن ألقى عصاه في الأرض المقدّسة ووصل إلى الساحة المقدّسة وفاز بشرف اللقاء بكمال الخضوع والخشوع وانتهل من بحر الألطاف غير المحدود وآقام بجوار العتبة العليا زمنًا ليس باليسير متمتعًا بالمثول بين يدي الحضرة في أغلب الأوقات مشمولاً بنظر العناية والفضل والموهبة الكاملة. أما في حسن الأخلاق فقد بزّ الكثير من أقرانه عاملاً بالتعاليم الإلهية، ساكنًا صبورًا على الشدائد، متفانيًا في تنفيذ إرادة من لا شبيه له، زاهدًا في الدنيا، غاية أمله الوحيد رضاء الله ولم يتحول عن ذلك أيام حياته. وسافر بعد ردح من الزمن إلى مدينة بيروت وقام على خدمة حضرة الأفنان المذكور عليه بهاءالله بكل إخلاص مدة طال أمدها، ولم ينقطع عن زيارة العتبة المقدّسة والتشرف بالمثول بين يدي المنظر الأكبر. ثم
ألمّ به مرض وهو في مدينة صيدا وأعياه عن الذهاب إلى عكاء ثم أدركته المنون فانتقل بكمال التسليم والرضاء إلى الملكوت الأبهى، واستغرق في بحر الأنوار وقد جرى من القلم الأعلى عنايات لا حدّ لها في ذكره.
في الحقيقة، إن هذا الشخص يعدّ من الثابتين الراسخين في الأمر وركنًا ركينًا في العبودية للجمال المبارك ولطالما سمعت ذكره بالخير من الفم المطهر.
عليه التحية والثناء، وعليه البهاء الأبهى، وعليه الرحمة الكبرى، وله المغفرة العظمى من رب السموات العلى. أما قبره المنور ففي مدينة صيدا بجوار المقام المشهور بمقام سيدنا يحيى.
(44)كان من جملة المهاجرين والمجاورين حسين أفندي التبريزي وهو ممن شربوا من الكأس الطافحة بصهباء محبة الله. سافر إلى بلاد اليونان وهو في عنفوان الشباب ومكث فيها مدة مشتغلاً بالكسب هانئ العيش حيث ظهرت بوارق الظهور فرحل إلى أزمير واستمع للنداء الجديد فاشتعلت في قلبه نار محبة الحق وزاد هيامه فهام في بيداء العشق الإلهي، والشوق لمشاهدة المحبوب، فساعدته الظروف ووصل إلى العتبة المقدّسة وفاز باللقاء، ولازم التشرف زمنًا ليس بالقليل وكان من المقربين. وأخيرا، أمره النيّر الأعظم بالذهاب إلى حيفا للآقامة فيها، فصدع بما أمر وأوقف حياته على خدمة الأحباء محطًا لرحال المسافرين من الأحباء. وكان على جانب عظيم من مكارم الأخلاق، ليّن العريكة، حسن الطباع والنوايا، محبوبًا لدى الجميع من أحباب وأغيار، محبًّا للخير، ودام على استقامته بعد صعود الجمال المبارك إلى الملأ الأعلى، راسخًا في العبودية لجمال القدم ولم يتحول عن ذلك طرفة عين، مؤنسًا للأحباء نديمًا للأصفياء. ونسج على هذا المنوال السنين الطوال عزيزًا في نفسه يرى كأنه أعز من سلاطين الأرض وملوكها بقوة إيمانه، وقد صاهر جناب آقا محمد قلي أحد أخوة الجمال المبارك وكان حسن المعاملة بعيدًا عن المداهنة، دائم الخوف من الامتحانات والافتتانات، حذرًا من تدفق طوفان
الامتحانات الإلهية على الأكوان مخافة أن يقذف موجه بالنفوس في هوة لا قرار لها، لا يفتأ يئن من شدة الخوف حتى أدركته المنون وتخلص من هذه الدار الفانية وبيده خلع ثوب حياته.
عليه التحية والثناء، وعليه الرحمة والرضوان، وغفر عنه وأدخله الله في الجنة العليا وفردوسه الأعلى. أما قبره المعطر ففي حيفا.
(45)كان المذكور من جملة المهاجرين والمجاورين. ولد هذا الرجل الرشيد في مقاطعة كرجستان (من إقليم القوقاز) وترعرع واشتد في مدينة كاشان، ونشأ محبًا للصداقة والأمانة والديانة والعزة. ولما بلغ سمعه نداء البُشرى بطلوع صبح الهدى وارتفع ذلك النداء شمس الحقيقة من أفق إيران، اشتعل في فؤاده نار الشغف والوله وأوقد في قلبه نار محبة الله. فخلع عذار الشبهة والارتياب عند سطوع أنوار شمس الحقيقة وأوقدت في وجوده شموع الهداية وسكن إيران مدة من الزمن ثم غادر إلى الروملي (في البلاد العثمانية) ومَثُلَ بين يديّ جمال القدم في أرض السرّ وفاز بشرف اللقاء وهو في غاية الانجذاب منشرح الصدر ومسرورًا للغاية حتى صدر له الأمر المبارك بالسفر مع كل جناب آقا محمد باقر وجناب آقا عبدالغفار إلى إسلامبول حيث وقع في مخالب الأعداء هدفًا للسلاسل والأغلال هو وجناب الأسطى محمد على الدلاّك واعتبروا جناب جمشيد من الوحوش الكاسرة وجناب الأسطى محمد علي الدلاك من السباع الشاردة ثم دفعوا بهذين الشخصين المحترمين، بعد أن عذبوهما في السجون، إلى حدود إيران بصفة أسرى ليسلّما إلى الحكومة لصلبهما أو لشنقهما محذرين بكل شدة من تركهما مخافة أن يفلتا لذا كانوا يحبسونهما في أماكن صعبة للغاية حتى إنهم ألقوهما في غيابة جب عميق قاسيَا فيه أنواع العذاب
طوال الليل حتى الصباح وعند ذلك صاح آقا جمشيد قائلاً: "أيها الحراس هل نحن يوسف الصديق حتى تلقونا في غيابة الجب! أما سيدنا يوسف فقد ارتفع من غيابة الجب إلى أوج قمر السماء. ولما كان إلقاؤنا في غيابة الجُبِّ هو في سبيل الله فلا شك ولا شبهة في أن هذا البئر العميق هو لنا عين الرفيق الأعلى".
ومختصر القول، إن الحراس قد سلموهما لرؤساء الأكراد على حدود إيران ليبعثوا بهما إلى طهران غير أن هؤلاء الرؤساء لما تأكدوا أن هذين المظلومين من محبي الخير لجميع العباد وأنهما قد سطت عليهما يد التطاول دون ذنب اقترفاه أطلقوا سراحهما ولم يرسلوهما إلى طهران.
وبمجرد إطلاق سراحهما قصدا محبوب العالمين سيرًا على الأقدام حتى وصلا إلى السجن الأعظم وألقيا عصاهما في جوار جمال القدم وآويا إلى رحابه. وقضى آقا جمشيد زمنًا طويلاً في غاية السرور والبهجة والفرح هانئ العيش في ظل ألطاف الرحمن فائزًا باللقاء في أكثر الأوقات ساكنًا مستقرًا وكان جميع الأحباء راضين عنه وهو راضٍ بما قسم له واستمر على هذا الحال حتى سمع نداء "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية"، فأجاب بقوله: "بلى!" وانتقل من السجن الأعظم إلى الأوج الأعلى طائرًا من عالم التراب إلى العالم الطهور. أغاثه الله في الرفيق الأعلى وأدخله في فردوس الأبهى وأخلده في جنة المأوى وعليه التحية والثناء. أما قبره المعنبر ففي عكاء.
(46)كان للحاج جعفر التبريزي، الذي كان من جملة المهاجرين والمجاورين، أخوان هما الحاج حسن والحاج تقي، وكان هؤلاء الثلاثة كالنسور الطائرة أو كالنجوم البازغة المضيئة بنور محبة الله وأشعة أنوارهم بادية من أفق إيمانهم وإيقانهم.
أما الحاج حسن فكان من المؤمنين السالفين استضاء ولمع بأنوار فجر الظهور منذ بزوغه، وكان فطنًا شديد الوله والانجذاب. سافر وانتقل بعد إيمانه إلى كل بلدة وقصبة في إيران تؤثر أنفاسه في قلوب المشتاقين حتى وضع الرحال في العراق. وفاز بشرف المثول بين يدي حضرة المحبوب وبمجرد مشاهدة أنوار الجمال انجذب إلى ملكوت الجلال فهام ووله واستنار وأنار ثم أُمر بالرجوع إلى إيران. ولما كان بائعًا جوالاً حمل سلعه متنقلاً من بلدة إلى أخرى ثم عاد إلى العراق للمرة الثانية فازدادت شعلة اشتياقه للجمال الأبهى حتى أصبح، وهو في دار السلام، في غاية الانجذاب ثملاً بصهباء الوصال واستمرّ على سفراته بين دار السلام وإيران لا يفكر إلا في ترويج الأمر وإعلاء كلمة الله ولم يكن يعبأ بأمور تجارته، ثم وقع في مخالب اللصوص وجردوه من سلعه وأصبح صفر يدين وكان يردد قوله: "إن حملي أصبح خفيفا". فانقطع عن كل علقة بهذه الدنيا ووصل انجذابه إلى حد
الجنون وغدا مفتون جمال محبوب العالمين واشتُهر بين الخلق بالمجذوب إذ كانت تصدر منه حالات غريبة. مثلاً تراه أحيانًا يجالس الناس ويحادثهم في مسائل التبليغ ببيان فصيح مستشهدًا بالآيات والأحاديث المناسبة للمقام مع الأدلة العقلية والحجج الدامغة حتى إن سامعيه كانوا يقرّون برجاحة عقله ورزانته وسعة اطّلاعه. وكنت طورًا تراه من فرط انجذابه قد عيل صبره فيقوم ويرقص من شدة طربه، وكان طورًا يغني بصوت مرتفع ويترنم بالأشعار بأبدع الألحان وطورًا تراه يبتدع أنواعًا من الأغاني. وفي أواخر حياته، اقتصر على مصاحبة المدعو – جناب منيب – وصار يجالسه ويؤانسه وكان يجمعهما تناغم الأفكار والألحان في الروح والجنان.
ومختصر القول، إنه بعد أن سافر الأحباء من بغداد رحل إلى أذربيجان وأخذ في نشر النفحات بنعرة – يا بهاء الأبهى – غير هيّابٍ ولا وجِل فتصدّى له جماعة من الملحدين الذين اتحدوا مع بعض آقاربه وأخذوه إلى حديقة هناك وبدءوا يستدرجونه في الحديث وكان يجيب عن أسئلتهم دون تستّر كاشفًا لهم الحجاب عن كل ما يتعلق بالظهور الأعظم ببراهين قاطعة بأفصح العبارات مستشهدًا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والمأثورة عن الأئمة الأطهار عليهم السلام برهانًا على ما يقول. وكان كلما أتم حديثه أخذه عامل الشوق والوله فيأخذ من شدة انجذابه في الغناء بألحان شجية أمام الحاضرين، وينشد الأشعار بخصوص هذا الظهور دون تلعثم أو انتظار، مما أثار حفيظة الملحدين من الأعداء فتجمعوا عليه وأوسعوه ضربًا حتى فارق الحياة ثم قطعوا جسده إربًا إربًا وطمروه في التراب.
كان هذا الشخص الطاهر عديم النظير، قد جذب أخاه الحاج
محمد جعفر إلى أنوار الجمال وقد فاز هذا الأخ بالتشرف بلقاء نيّر الآفاق في العراق واشتعل بنار محبة الله وكان بائعًا جوالاً مثل أخيه المرحوم واتفق أنه كان في إيران حال رحيل الجمال المبارك من بغداد إلى عاصمة مملكة الإسلام (إسلامبول) وما أن بلغ حضرته أرض السر حتى جاء ذلك الأخ مع أخيه الأخير – الحاج تقي – إلى أدرنه من أذربيجان واستأجرا بيتًا وسكناه إلى أن كانت نتيجة أعمال الأعداء إرسال الجمال المبارك إلى السجن الأعظم – عكاء – ومنعت الحكومة الأحباء عن مرافقة حضرته وقصدت بذلك أن يسافر الجمال المبارك ولا يكون في معيته غير أفراد أسرته وذويه، فلما شعر بذلك الحاج حسن المذكور لم يستطع صبرًا وجزّ حلقومه بموسى حاد ففزع القوم وهالهم هذا العمل بدرجة لا حدّ لها. ولما شاهدت الحكومة ذلك (يعني أن أهل البهاء لا يستطيعون الحياة بعد سفر محبوبهم) أجازة سفر الجميع في معيّة الجمال المبارك وكل هذا كان ببركة الحركة التي أبداها الحبيب الذي جُزّ حلقومه. ثم خاطوا الجرح ولم يكن هناك أمل في التئامه ونقلوا الجريح إلى المستشفى بأمر الجمال المبارك مؤكدين له بأنه سيحضر إلى عكاء بعد شفائه فاطمأن قلبه ثم سافر جمال القدم ومن معه إلى السجن الأعظم ولم يمض أكثر من شهرين إذ جاء جناب الحاج المذكور مع أخيه إلى قلعة عكاء وانضمّا إلى المسجونين من أهل البهاء فأخذت شعلة اشتياقه في الازدياد آنا غُبّ آن حتى إنه كان يسهر ليله حتى السحر يتلو الأنجية وعيناه تذرفان الدمع من شدة البكاء حتى سقط ذات ليلة عن سطح الثكنة فكانت القاضية وصعدت روحه إلى ملكوت الآيات.
أما أخوه النوراني – الحاج تقي – فكانت أحواله وأطواره تتشابه
مع ما كان لأخيه المرحوم جعفر بالضبط غير أنه كان أكثر سكونًا وعاش بعد أخيه منفردًا صامتًا في غرفته. وكان يجلس في كمال الأدب واتفق أنه بينما كان على سطح بيته مشغولاً بتلاوة الآيات إذ به يسقط خلف الدار وبالبحث عنه وجدوه فاقد الوعي. أما سبب وقوعه فلم يُعلم، أكان عمدًا أم سهوًا. ولما أفاق من غشيته قال: "إنني كرهت البقاء ولذا رجوت الفناء لأني لا أحب البقاء في هذا العالم ولو دقيقة واحدة وأرجوكم أن تدعوا الله أن يكون لي ذلك حتى أفارق هذه الدار."
هذا شرح حال الأخوة الثلاثة الذين كان كل منهم نفسًا مطمئنة راضية مرضية مشتعلة منجذبة طاهرة مقدسة ولذا فارقوا هذا العالم وهم في غاية الانقطاع إلى الله والتوجه إليه والإيقان به ودخلوا الملكوت الأعلى. ألبسهم الله خِلع الفضل والإحسان في ملكوت الغفران وأغرقهم في بحار رحمته إلى أبد الآباد وعليهم التحية والثناء.
(47)كان حضرة الحاج ميرزا محمد تقي أفنان، الملقب بوكيل الدولة، من النفوس الزكية والحقيقة النورانية والجلوه الرحمانية.
هذا الفرع الجليل هو من أفنان السدرة المباركة. اجتمع فيه شرف الأعراق مع حسن الأخلاق أما حسبه ونسبه فكان حقيقيًا وهو من الذين انجذبوا بنفحات الله بمجرد قراءة كتاب الإيقان وانشرحت صدورهم بترتيل الآيات فطغى عليه الوجد والوله بحيث ترك إيران قاصدًا العراق، ملبيًا النداء بالروح والريحان فقام من شدة الاشتياق وطوى الفيافي والقفار بكل روح وريحان إلى أن وصل إلى العراق وهو فائر لم يهدأ له بال ثم ذهب وهو في دار السلام إلى الساحة المقدّسة وفاز بشرف المثول بين يدي الجمال المبارك واعتلى ذروة القبول، فوله وانجذب وانقطع عما سوى الحق بدرجة تفوق الوصف. كان صبيح الوجه، نوراني الطلعة حتى إن جميع الأحباء في العراق سمّوه "أفنان المليح" وكان في الحقيقة نفسًا مباركة، ومحترمًا للغاية. لم يقصّر في خدماته طوال حياته، انجذب بنفحات الله من فاتحة أيام حياته وتوجت خاتمة مطافه بأعظم خدمة لأمر الله. كان حسن المعاملة، شهي الحديث، لم يفتر عن عبوديته للحق لحظة واحدة، يؤدي أعماله فرحًا مسرورًا، وكان كل ذلك مع ما كان عليه من حسن السلوك ينم
عن مقدرة في تبليغ أمر الله وتنبيه الكثيرين. وبعد أن فاز بشرف اللقاء في بغداد، عاد إلى إيران وباشر أمر التبليغ بلسان فصيح، إذ هكذا يجب أن يكون التبليغ بلسان فصيح وقلم بليغ مشموليْن بحسن الأخلاق وحلاوة القول وطيب الأعمال والاستقامة في السير والسلوك حتى شهد الأعداء والخصماء بعلوه وروحانيته وأقرّوا بأن هذا الشخص لا نظير له في العمل والقول والتقوى والأمانة والديانة وهو فريد ووحيد في جميع الشؤون ولكنه للأسف بهائي أي أنه ليس مثلنا متهورًا غير مبالٍ ومرتكبًا للسيئات ومنهمكًا في الشهوات ومطيعًا للنفس والهوى.
سبحان الله! فقد لاحظوا أن هذا الشخص الذي لا مِراء في أنه مطلع الهدى قد انقلبت أطواره العتيقة وأصبح بمجرد وصول نفحات الأبهى إلى سمعه، مشكاة شعاع شمس الحقيقة.
لم يتنبه للأمر أيام كان تاجرًا في يزد، وبعد ذلك أصبح سبب انتشار نور الهداية حقًا. ولم يكن له مقصد سوى إعلاء كلمة الله، جل أمله نشر النفحات فكره محصور في التقرب من ساحة الكبرياء مطمئن القلب بترتيل آيات الله، مظهر رضاء الجمال المبارك ومطلع عطاء الاسم الأعظم، وكثيرًا ما تكررت على لسان جمال القدم عبارات الرضاء في حقه حتى إن الجميع تأكدوا أنه سيكون هذا الشخص مصدرًا لأمر عظيم. أما ثبوته ورسوخه على الأمر بعد الصعود المبارك فكان لا ينكره أحد ولم يكن ليتأخر عن الخدمة مهما كانت الحال رغم ما كان هناك من موانع وعقبات كأداء ومشاغل لا حصر لها. ولما عاف تشتت أفكاره ترك الراحة والتجارة والأملاك والأراضي والعقار ورحل إلى عشق آباد وشرع في بناء مشرق
الأذكار هناك ولا مِراء في أن هذه الخدمة عظيمة للغاية لأنه كان أول شخص قام ببناء مشرق الأذكار (في مدينة العشق) وأصبح الباني الأول لبيت توحيد العالم الإنساني ووفق إلى ذلك بمعونة أحباء (عشق آباد) واعتبر السبّاق في هذا الميدان حيث لم يسبقه أحد في آقامة مشرق للأذكار. آقام في عشق آباد زمنًا طويلاً لم يذق للراحة طعمًا يحث الأحباء ويشوّقهم إلى ما هو قائم بعمله وهم بدورهم أيضًا قد بذلوا ما وسعهم في هذا السبيل مضحين بكل مرتخصٍ وغالٍ إلى أن تم البناء المذكور وعم صيته الشرق والغرب. أما هو فقد أنفق كل ماله، إلا القلة، في هذا السبيل. هكذا يكون الإنفاق وهذا هو شرط الوفاء.
ثم توجه بعد ذلك إلى الأرض المقدّسة وآقام بجوار مطاف الملأ الأبهى ملتجئًا إلى المقام الأعلى (مقام حضرة الباب) بنهاية التضرع والابتهال وفي غاية التنزيه والتقديس، مشتغلاً بذكر الله على الدوام يناجي الحق بقلبه ولسانه.
كانت روحانيته عظيمة ونورانيته لا مثيل لها، وكان من الذين قالوا في قلوبهم "بلى" قبل أن يُقرع طبل "ألسْت". وقد اشتعل في العراق بنار محبة نيّر الآفاق بين سنة السبعين والثمانين بعد المائتين للهجرة، وشاهد الإشراق من الأفق الأبهى، ولاحظ ببصيرته قوله: "إنني حي في الأفق الأبهى".
أما بشاشتة فحدّث عنها ولا حرج. كان إذا ألمّ بي حزن ولاقيته استبدل حزني بالفرح والسرور في الحال. وكانت عاقبته، والحمد لله، ساطعة الأنوار للغاية وانتقل إلى الملكوت الأبهى بجوار المقام الأعلى فأثرت مصيبة انتقاله في عبدالبهاء أيما تأثير.
أما مرقده المنور في حيفا بجوار حظيرة القدس قرب مقام سيدنا الخضر ويجب أن يشاد له قبر بكل إتقان. نوّر الله مضجعه بأنوار ساطعة من ملكوت الأبهى وطيب الله جدثه المطهر بصيّب مدرار من الرفيق الأعلى. عليه البهاء الأبهى.
(48)كان من زمرة المهاجرين والمجاورين، جناب آقا عبدالله البغدادي الذي اشتهر بين الخلق في أول أدوار شبابه أنه من أهل اللهو والهوى المنهمكين في اللذائذ، وشهد الكل أنه من أسرى الشهوات المستغرقين في بحور المشتهيات الجسمانية، ولكنه بمجرد إيمانه وإيقانه وانجذابه بنفحات الرحمن أصبح خلقًا جديدًا في حالة تستوجب الاستغراب إذ انقلب فجأة بالكلية وأصبح سماويًا بعد أن كان أرضيًا، وروحانيًا بعد أن كان جسمانيًا، ونورانيًا بعد أن كان ظلمانيًا، ورحمانيًا بعد أن كان شيطانيًا، ولؤلؤ صدف لامع بعد أن كان خزفًا، وجوهرًا وضّاءًا بعد أن كان حجرًا أسودًا، وقد احتار الأغيار في أمره وقالوا: "ما هذا الانقلاب الذي حصل لهذا الشاب الذي أصبح منقطعًا عن الدنيا، منجذبًا إلى الحق، طاهرًا بعد أن كان دنسًا، لابسًا ثياب الزهد والتقوى بعد ما كان منهمكًا في اللهو والهوى. نراه اليوم قد زهد في الدنيا وطوى بساط اللذات والمرح وقنع من الدنيا بالوله والانجذاب إلى الحق".
وخلاصة القول، إنه قد عاف الهناء ولذة العيش وتوجه راجلاً إلى عكاء بوجه مستبشر، كان بهي الطلعة نورانيًا وروحانيًا بدرجة أن قَلْبَ كل من رآه كان يمتلئ سرورًا وبهجة.
سألته مرّة: "آقا عبدالله كيف حالك؟"، فأجابني: "كنت، يا
مولاي، مظلمًا أصبحت بعناية الجمال المبارك وفضله منيرًا، كنت بلقعًا أصبحت روضة أوراد غناّء، كنت معذّبًا أصبحت في نعيم، كنت مكبلاً بالقيود الدنسة أصبحت حرًا منزهًا طاهرًا، كنت متعلّقًا بعالم الناسوت أصبحت متعلّقًا بعالم الملكوت، كنت كطائر في قفص أصبحت طليقًا أفترش الأرض في الصحاري الغبراء وألتحف السماء مسرورًا مبتهجًا. ولو أن فراشي كان قبل اليوم من الخزّ الناعم غير أن روحي كانت في عذاب أليم، ولو أني الساعة خالي الوفاض ولكنني في غاية الروح والريحان.
وعلى الجملة، إن هذا الشخص المنجذب بالنفحات قد ذاب قلبه أسى لما شاهد مظلومية نيّر الآفاق وتمنى أن يفدي حضرته بالروح حتى حان حينه واستجيب دعاؤه وانتقل من هذا العالم الظلماني إلى العالم النوراني.
أما قبره المنور ففي عكاء. عليه البهاء الأبهى وعليه الرحمة من فيض الكبرياء.
(49)كان حضرة آقا محمد مصطفى البغدادي في عداد المهاجرين والمجاورين. هذا السراج الوهاج، النجل الخليل للعالم النحرير الشيخ محمد شبل، من أهل العراق العربي. اشتهر حضرة محمد مصطفى البغدادي بتفرده في جميع الآفاق بالشجاعة، والشهامة، والوفاق من فجر شبيبته. اهتدى إلى فجر الظهور منذ كان طفلاً على يد والده، فاستنار قلبه وأحرق ستر الوهم وفتح حديد بصره، فشاهد الآيات الكبرى وأعلى نعرة "قد أشرقت الأرض بنور ربّها" غير هيّاب ولا وجل.
كنت ترى هذا الشخص الكريم، رغم التعرض الشديد للمؤمنين وسوط عذاب أولي الشأن وانزواء الأحباء خلف ستار التقية (عدم إظهار المعتقد) من شدة الخوف من الأعداء، غاديًا ورائحًا في دار السلام بكل شجاعة وجسارة يقاوم كل ظالم بعزم ثابت وقوة خارقة، واشتهر في سنة السبعين في العراق بمحبة نيّر الآفاق. وأما الذين اتخذوا الحيطة والكتمان أصبحوا في زوايا النسيان.
وأيم الحق، إن هذا الهزبر الذي لا يضارع، كان يمرّ في أسواق بغداد يهابه كل من رآه، وتخشى الأشرار بأسه ولم يتعرضوا له مخافة بطشه. وقد ظهرت، على الأخص رجولة هذا الرجل الرشيد بأجلى
معانيها للقاصي والداني، بعد رجوع جمال القدم من كردستان (السليمانية) إذ كان يتشرف بالحضور المبارك كلما صدر له الإذن بذلك، وكان يمتع سمعه بما يخرج من فم المبارك من البيانات ويفوز بالعنايات وهو أول محبّ ظهر في العراق جاهرًا بمعتقده واستمر بعد أن تحرك الموكب المبارك من دار السلام إلى المدينة الكبرى (اسلامبول) على مقاومة الأعداء وخدمة الأمر بكل همة ونشاط، يبلّغ الناس علانية ولما ذاع في الآفاق إعلان من يظهره الله كان من الذين أذعنوا لظهوره مع أنه كان متأكدًا من ذلك ومؤمنًا قبل الإعلان حتى إنه قال: "إنّا آمنا قبل أن يرتفع النداء، لأنه قد رفع الستار عن الإشراق بين الآفاق قبل ارتفاع النداء وشاهد الأنوار كل ذي بصر حديد ورأى الجمال المطلوب كل طالب بصير".
وعلى الجملة، إن هذا الشخص قام على خدمة الأمر بكل ما أوتي من قوة، ولم يهدأ لحظة في هذا السبيل. وبعد حركة جمال القدم إلى السجن الأعظم لاقى هذا المحب من الأعداء ما لاقى، فبعد أسر الأحباء ونفيهم من الزوراء إلى الحدباء (الموصل)، وخصومة الأعداء وتعرّض أهل دار السلام، لم يفتر عن مقاومة الأعداء واستمر على ذلك زمنًا ليس بالقليل حتى تأججت نار الشوق للقاء المحبوب بين ضلوعه فترك الأوطان والأهل والخلاّن وتوجه منفردًا إلى السجن الأعظم (عكاء) فوطئ المدينة في أيام الشدة والضيق وفاز بشرف اللقاء وطلب السماح له بالسكنى حوالي عكاء. فصدر له الإذن بالآقامة في بيروت، فصدع بالأمر وآقام في تلك المدينة خادمًا للأمر بكل إخلاص، محطّ رحال جميع الأحباء الذاهبين للتشرف والآيبين من أرض المقصود. وكان يرحب بالجميع بكل حفاوة، يعاونهم ويسهل لهم الطريق بكل مودّة،
مضحّيًا بكل مرتخصٍ وغالٍ في سبيل راحة الأحباء الذاهبين إلى عكاء والعائدين منها، والكل يشهد بذلك. وعمّت شهرته في هذا الصدد كل صوب وحدب. واستمر بعد أفول شمس الحقيقة وصعود نيّر الملأ الأعلى، ثابتًا مستقيمًا على العهد والميثاق الإلهي بدرجة زلزلت فرائص المتزلزلين الناقضين ولم يجرؤ أحد منهم أن يحرك لسانه بكلمة أمامه لأنه كان كالشهاب الثاقب يرجم الشياطين، وكالسيف القاطع على أعناق الناكثين، ولم يجرؤ أحد منهم أن يمرّ من الحي الذي هو فيه، وإذا تصادف أن مرّ به أحد الناقضين، في الطريق مثلاً، مرّ هذا الأخير مرّ الكرام وكأنه من الصم البكم العمي الذين لا يرجعون.
حقًا، إنه كان بين القوم مصداق "لا تأخذه في الله لومة لائم، ولا تزعزعه صولة شاتم".
ومختصر القول، إنه لم يتزعزع عن أسلوبه، من قلب فارغ ونيّة صادقة وإخلاص في خدمة الأحباء قاصدي الروضة المطهرة، الطائفين حول مطاف الملأ الأعلى. ثم انتقل في أخر الأمر إلى بلدة الاسكندرونة وعاش فيها زمنًا منجذبًا إلى الله منقطعًا عما سواه مستبشرًا ببشارات الله متشبثًا بالعروة الوثقى مشهورًا بالتقديس، إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى.
رفعه الله إلى الأوج الأعلى والرفيق الأبهى، وأدخله في عالم الأنوار، ملكوت الأسرار، محفل تجلي ربه العزيز المختار. وعليه البهاء الأبهى.
(50)كان من جملة المهاجرين والمجاورين جناب سليمان خان التنكاباني الملقب ب جمال الدين. ولد في مدينة تنكابان وهو من العائلات القديمة في ذلك الإقليم. نشأ ونما ورضع من ثدي الراحة والعزّة، وتربّى في أحضان الرفاهية والثروة، وكان ذا همّة عالية منذ طفولته، مقاصده نبيلة، ذا غيرة مجسمة ونشاط ملحوظ، كان يفكّر في التربع في دسوت المناصب، طالبًا التفوق على أقرانه وأترابه. ولذا بارح موطنه الأصلي إلى مقر سرير السلطنة يعني مدينة طهران أملاً في علو اسمه ورفعة مكانته وعظمة قدرته وتفوقه على أقرانه. غير أنه في طهران وصلت إلى مشامه نفحات الرحمن، وطرق سمعه نداء المحبوب العطوف، فخلّص نفسه من ارتباكات الفكر الناشئة من طلب الجاه وغلغلة العظمة والأبّهة الفانية وعزة هذا العالم الترابي وما به من غرور، وتحرر من القيود فعمّ قلبه الفرح والسرور بالموهبة الإلهية وتأكد أن صدر الجلال هو صفّ النعال وأن المناصب والدسوت سريعة الزوال فترك الدنيا ووطّد العزم على الراحة وعدم انشغال البال وتخلص من أغلال قيود البشرية وسلاسل التعلق بالدنيا فلبس إحرام حرم الكبرياء وعزم على التوجه إلى حيث المحبوب فقطع الفيافي والقفار إلى أن وصل إلى سجن عكاء وفاز باللقاء ومضى مدة في رحاب جمال القدم مستمعًا للنغمات الخارجة من الفم المبارك صاغيًا لجوامع الكلام
وفصل الخطاب. وبعد أن تعطرت مشامه وتنورت بصيرته وتمتع بالعطاء الموفور وثمل من رحيق الرب الجليل وفاز من كل ذلك بنصيب موفور، صدر له الإذن المبارك بالسفر إلى بلاد الهند مأمورًا بتبليغ كل طالبٍ صادق، فصدع بالأمر وذهب إلى بلاد الهند. متوكلاً على الله منجذبًا بنفحات الله مشتعلاً بنار محبة الله وهام في تلك الأقطار وجاس خلال تلك الديار مدنها وبلدانها وقراها يضرب ناقوس الملكوت عاليًا مبشرًا بظهور مكلم الطور سالكًا سبيل رجال الله العاملين وغرس بذور التعاليم الطاهرة في تلك الأصقاع فنبتت نباتًا حسنًا ونمت وأينعت وانقاد الكثيرون إلى سفينة النجاة واهتدوا بنور الهدى وتنورت بصائرهم من مشاهدة الآيات الكبرى وكان هو الشمعة المضيئة للجميع في تلك الآقاليم واستمرت آثاره واضحة في بلاد الهند كل الوضوح وقام أغلب الذين آمنوا على تبليغ الأمر واشتغلوا بهداية الخلق مقتفين أثره.
وخلاصة القول، فقد عاد بعد سياحته في بلاد الهند إلى الساحة المقدّسة وكان وصوله بعد الصعود المبارك فاتقدت في صدره نيران الحسرة وأصبح باكي العين مكلوم الفؤاد يفور قلبه كالأتون ولكنه كان ثابتًا على العهد والميثاق نابتًا في روضة الرضوان.
وحدث أن تفضل جمال القدم قبل الصعود بقوله تعالى: "إذا توجه أحد إلى إيران، فليوصل من قِبَلي لأمين السلطان الرسالة الآتية: أن يا أمين السلطان، إذا بذلت الهمة في حق الأسرى وقمت بمعونة المحتاجين والمظلومين (من أهل البهاء) فخدمتك هذه لا تنسى وكن على يقين من أن هذا العمل سيكون لكم سبب العزة والبركة في جميع الشؤون. يا أمين السلطان اعلم أن كل بنيان في هذا العالم يؤول إلى الانهيار عدا البنيان الإلهي وهو الذي تزداد متانته وأحكامه يومًا فيومًا.
إذًا، فاعمل كل ما في مكنتك في خدمة الديوان الإلهي حتى تهتدي إلى الإيوان الرحماني وابن بناء لا يؤول إلى الزوال".
وبعد الصعود المبارك، أوصلنا هذه الرسالة إلى أمين السلطان وكان وقتذاك قد أصاب جناب آقا سيد أسدالله إهانة من فقهاء الترك بمدينة أردبيل وأظهروا له عوامل الجفاء والغلظة وعزموا على قتله. أما الحكومة هناك فقد عملت ما في وسعها حتى نجته من مخالب الفقهاء وحالت دون قتلهم إياه ثم أرسلوه مصفدًا إلى تبريز ومنها إلى طهران حيث قام أمين السلطان ببذل كل رعاية في حق آقا سيد أسدالله وأسكنه في ديوانه الخاص وآواه فيه واتفق في تلك الأثناء أن أصاب أمين السلطان مرض وأتى ناصر الدين شاه لعيادته فما كان من أمين السلطان إلا أن قصّ للشاه كل ما حدث لآقا سيد أسدالله ومدحه وأطراه أمام الشاه بدرجة جعلت هذا الأخير يعرب لآقا سيد أسدالله عن تألمه واستيائه مما حصل وأظهر له عطفه وكان من طبع الشاه في مثل هذه الأحوال أن يأمر بصلب من هو بمثل آقا سيد أسدالله ويجعله هدف نيران القنابل. ولكن، حال دون ذلك ما سمعه من أمين السلطان، وما لبث هذا الأخير أن حل عليه غضب الشاه وأصبح مبغوضًا وأرسل أسيرًا منكوبًا مستبعدًا إلى مدينة "قم" فما كان من هذا العبد إلا أن أرسل إليه (بإيران) الرسالة التي تفضل بها جمال القدم مصحوبة بمناجاة وخطاب منيّ بخط يدي وطلبت له في المناجاة العون والعناية من الله ورجوت الله أن يصونه ويحميه وينقذه من زاوية الخمول ويرفعه إلى أوج القبول وقلت له صراحة في رسالتي: إنك سيحظى بالتأييد الإلهي في القريب العاجل وتسطع أنوار العناية وستستقر في دست الصدارة (الوزارة) بنهاية الاستقلال مكافأة لك على
خدمتك والهمة التي بذلتها في حق المظلومين (من أحباء البهاء). ورسالتي هذه مع المناجاة لا يزالان في حيازة أسرة أمين السلطان.
أما سليمان خان، فقد بارح مدينة طهران بعد ردح من الزمن إلى مدينة قم. وبينما هو في غرفته إذ حضر أحد معارف أمين السلطان لزيارته فسأله سليمان خان عن أحوال أمين السلطان وروى أنه في أشد الحاجة لمقابلته. وما أن وصل هذا الخبر إلى أمين السلطان حتى طلب حضور سليمان خان، فذهب هذا الأخير إلى داره متوكلاً على الله واختلا به وسلّمه الرسالة المرسلة من قبلي، فتقبّلها بكل احترام وفضّها بعد أن صافحها جبينه، ثم قال لسليمان خان بعد قراءتها: "إنني لفي يأسٍ عظيم وإنني دون شك سأستمرّ مشمّرًا ساعد الجد في الخدمة وصيانة أحباء الله وحمايتهم إذا ما تيسر حصول ما جاء في الرسالة المباركة". ثم أظهر امتنانه الزائد وعظيم السرور والابتهاج وقال: "الحمد لله، قد تم المراد ومن المؤكد أني سأكون، بعون الله وعنايته، من الناجحين".
وبالاختصار، إن أمين السلطان قد تعهد بالقيام بالخدمات، ثم ودع سليمان خان بعد أن عرض عليه بعض النقود بحجة مصروف الطريق فأبى سليمان خان قبول شيء من هذا القبيل رغم إلحاح أمين السلطان.
وبينما كان سليمان خان في الطريق إلى البقعة المباركة (عكاء) إذا بصدور أمر الشاه بإطلاق سراح أمين السلطان وإحضاره إلى طهران وإسناد صدارة الوزارة إليه رأسًا. فقام بأعباء الوزارة مستقلاً في عمله كل الاستقلال. وقام في أول الأمر على حماية الأحباء غير أنه قصّر في ذلك أثناء حادثة شهداء يزد، إذ تمنّع عن حماية الأحباء وصيانتهم بالمرّة، وكان كلما رفع إليه الأحباء شكايتهم كان يقابلهم بأُذن صماء
فكانت النتيجة أن تجرّع جميع أهل البهاء كأس الشهادة ولهذا عُزل أمين السلطان ونكس علمه المرفوع ويأس قلبًا وروحًا من خيبة الأمل.
ومختصر القول، إن جناب سليمان خان وصل إلى البقعة المباركة وأمضى بقية أيام حياته بجوار مطاف الملأ الأعلى منشرح الصدر، بكمال الروح والريحان، وقد ألفه جميع الأحباء واستأنسوا به إلى أن وافاه الأجل المحتوم فلبى دعوة الحي القيوم، وترك الأهل والخلاّن ورحل إلى عالم الأنوار، وتخلص من قفص الإمكان طائرًا إلى الفضاء اللامكان غير المتناهي. أغرقه الله في غمار رحمته وأنزل عليه شآبيب مغفرته وأسبغ عليه جلائل نعمته ورزقه جزيل موهبته. وعليه التحية والثناء.
(51)كان في عداد المهاجرين والمجاورين جناب آقا عبدالرحيم مِسگر، الذي اجتمعت فيه صفتا الصبر والحلم، وهو من أهالي كاشان ومن الأحباء الأقدمين. شرب من صهباء محبة الله قبل أن يَطِرّ شاربه، وتناول من المائدة السماوية التي كانت مهيأة وممدودة، ونال نصيبًا من الهداية الكبرى والموهبة العظمى، ثم بارح موطنه بعد إيمانه بقليل وهرع إلى روضة أوراد الزوراء وفاز بشرف لقاء حضرة المقصود، وأمضى أيامًا بجوار الحضرة في العراق، ولبس من ألطاف اللايزال تاجًا وهاجًا إذ كان يتمتع بشرف اللقاء في أغلب الأوقات، ثم سار راجلاً بجوار الركب المبارك إلى الكاظمين عليهما السلام، وكان حظه موفورًا. وكان أيضًا من جملة الأسرى في الموصل (الحدباء) وما لبث أن رحل إلى عكاء حيث أمضى أيامًا بجوار الألطاف المباركة، مسرورًا مبتهجًا، وكان يعمل كتاجر قليل البضاعة غير أنه كان، على الدوام، قانعًا مسرورًا وراضيًا بما قسم له، سالكًا سبيل الرشاد حتى ناهز الثمانين من عمره، صابرًا ساكنًا حتى وافاه الأجل المحتوم، وصعدت روحه إلى عالم الأسرار.
تغمده الله بفضله ورحمته وألبسه حلل الغفران في جنة الرضوان. أما قبره ففي عكاء.
(52)كان جناب آقا محمد إبراهيم التبريزي من جملة المهاجرين والمجاورين، وكان هذا الرجل الكريم ذا خُلق عظيم، وأسرع إلى سجن عكاء بمجرد علمه بأن والده جناب مشهدي عبدالفتاح مقيمٌ بها قصد مساعدة أبيه رفيع الشأن، أما عقله فكان راجحا،ً ونشاطه عظيمًا، ثملاً من نسيم محبة الله مشتعلاً بنارها، غريب السكون، عجيب الرزانة، مقتفيًا آثار والده في الطباع والأخلاق (الولد سرّ أبيه). أمضى زمنًا ليس باليسير بجوار حضرة المقصود، متمتعًا بالرفاه والحظ العظيم، يبيع في النهار بعض السلع ويقابل الأحباء ليلاً في داره ويؤانسهم، ثابتًا على الأمر راسخًا في إيمانه، غيورًا وشكورًا، طاهرًا وحصورًا، مطمئنًا بفضل الرب الغفور وعنايته. أضاء شمعة وجود والده (مشهدي عبدالفتاح) محافظًا على سمعة أسرته، وخلّف ذريّة حسنة وكان دائمًا سبب سرور الأحباء وباعث الروح والريحان بينهم، عظيم الفطنة، حاد الذكاء، قوي العارضة رزينًا. عاش متمسكًا بالإيمان مطمئنًا بفضل العزيز المنان، إلى أن لفظ النفس الأخير وصعدت روحه إلى حيث تلقى الثواب.
سقاه الله كأس العفو والغفران، وجرّعه من عين العناية والرضوان، ورفعه إلى أوج الفضل والإحسان. أما قبره المعطر ففي عكاء.
(53)كان جناب محمد علي أردكاني من جملة المهاجرين والمجاورين. سمع النداء الرباني وهو في حداثة سنّه وغضاضة شبابه، فتعلق قلبه بالفيض السماوي، وقام على خدمة أفنان الشجرة الإلهية، وعاش عيشة ملؤها الروح والريحان. وبينما هو قائم بخدمته المذكورة إذ سافر إلى عكاء وتشرف بخدمة العتبة المقدّسة زمنًا ليس باليسير هائمًا في بحبوحة الموهبة الكبرى، مشاهدًا لطلعة العزة العظمى باستحقاق ملحوظ بنظر العناية، قائمًا بالخدمة بصادق النيّة. وكان حسن الطباع وسيم المحيّا صادق الإيمان لم يخل من الامتحانات منقّبًا عن الحقائق.
كان في أيام نيّر الآفاق، ثابت القدم في معتقده، واستمرّ راسخاّ في الأمر أيضًا بعد الصعود ونزول الرزية العظمى ولم يتزعزع قلبه، ثملاً من هبوب نسيم العهد والميثاق، متشبّثًا بألطاف الحي اللامثال. وبالآخرة انتقل إلى حيفا وآقام البقية الباقية من أيام حياته في جوار حظيرة القدس بجانب المقام الأعلى غاية في الثبوت والاستقامة، إلى أن حان حينه وحلّت خاتمة مطافه، فطوى بساط حياته ولفظ النفس الأخير.
نعم. إن هذا الشخص، كان خادمًا صادقًا للعتبة المباركة، خدينًا
لجميع الأحباء والكل راضٍ عنه ومسرورًا منه، لأن مشربه كان مألوفًا وعريكته لينة.
أغاثه الله في ملكوته الأعلى وأسكنه في ملكوته الأبهى، وأفاض عليه فيضًا مدرارًا في جنة الفردوس مقام المشاهدة واللقاء. أما ترابه المعنبر ففي حيفا.
(54)كان الحاج آقاي التبريزي في عداد المهاجرين والمجاورين. هذا الشخص الرباني من أهالي تبريز، وقد تعطّرت مشامه من عبيق النفحات الهابة من حديقة أوراد العرفان، تلك النفحات مسكيّة الشذا، وتجرّع من الجام الرباني صهباء الإيمان وهو في عنفوان الشباب. وكان ثابت القدم في الأمر كل الثبوت، وعاش زمنًا في أذربيجان واستمرّ هائمًا في حب محبوب الأرواح. ولما اشتهر بمعتقده قام القوم على معاندته فضاق به المُقام بعدما كان القوم يوجهون إليه التهم الباطلة، فبارح تلك الديار بعد أن باع كل ما يمتلك هرِعًا إلى أرض السرّ مع بعض المتعلقين بالأمر، فوصلها في الأيام الأخيرة، وما لبث أن وقع أسيرًا في يد الأعداء. غير أنه أخيرًا وصل إلى السجن الأعظم مع المنفيين وكان شريكًا في البلايا والمصائب وصبورًا وسليمًا. وبعد أن حصلنا على بعض الحرية حتى اشتغل بالتجارة، ونسج على هذا المنوال ردحًا من الزمن متمتعًا بالراحة والرفاه في ظل الألطاف المباركة. ومن المصائب والبلايا الأولى أصبح جسمه عليلاً، وحفّ به المرض وانتابه ضعف القوى، فاشتد مرضه وانحل جسمه حتى فاجأته المنون وهو في الجوار المبارك وفي ظل سدرة المنتهى، وصعدت روحه من هذا العالم الأدنى إلى الفردوس الأعلى، فتخلص من هذا العالم الظلماني طائرًا إلى العالم
النوراني. أغرقه الله في بحار الغفران وأدخله في جنة الرضوان وأخلده في فردوس الجنان. أما ترابه المطهر ففي عكاء.
(55)كان جناب الأستاذ (المعلم) غلام علي النجار ضمن المهاجرين والمجاورين، وأستاذًا ماهرًا في صناعته، وفي الإيمان والإيقان كالسيف المسلول، واشتهر لدى القاصي والداني من أهل بلدته بالتديّن، وكان الكل يقرّ بأمانته وعدم خيانته، وبأنه غيور وطاهر وحصور للغاية. ولما استضاء بصره بنور الهداية، اشتعلت في فؤاده نار الاشتياق إلى لقاء المحبوب، فظَعنَ، بكمال الوجد والطرب والانجذاب والوله، من أرض الكاف (كاشان) إلى العراق. وحظي بمشاهدة أنوار الإشراق مهاجرًا مظلومًا في نهاية الصبر والسكون. ومارس النجارة في دار السلام وقد ألفه جميع الأحباء وفاز بشرف الحضور بين يدي الحضرة، وقضى ردحًا من الزمن متمتعًا بمنتهى الراحة والسرور حتى استبعد ضمن الأسرى إلى الحدباء (الموصل). وكان من المظلومين المغضوب عليهم لدى أولي الحِلّ والعِقْد، واستمر على هذا الحال مدة طويلة. وبعد أن فُك أسره وأصبح طليقًا، أتى إلى عكاء ودخل في عداد المسجونين وزاول صناعته، وكان ميالاً إلى العزلة والانفراد، متباعدًا قدر الإمكان عن الأغيار والأحباء لميله إلى الوحدة، وكانمنويًا في أغلب الأحيان حتى حلت المصيبة الكبرى، ووقعت الرزية العظمى، فتعهد بالقيام بجميع أعمال النجارة اللازمة لبناء التربة المطهرة. وقد أدّى كل ذلك بكمال الدقة والإتقان،
وشاهدنا اليوم أعمال النجارة من صنع يده في سقف بهو الحجرة المقدّسة المحلاة بالزجاج.
عاش هذا الشخص صافي الضمير، طلق المحيّا، ثابتًا على حال واحد، لم يتلون ولم يتزلزل، متمسكًا بالمحبة في دينه السنوات الطوال بجوار الرحمة الكبرى، حتى وافاه الأجل المحتوم، فطار من هذا العالم ورافق أهل الجنة العليا وفاز بشرف اللقاء في عالم الأسرار كما فاز به في هذه الدار. هذه هي الموهبة العظمى، هذه هي العطية الكبرى. وعليه التحية والثناء. أما جدثه المنور ففي عكاء.
(56)كان اسم هذه الروح المجسمة الميرزا آقا من أهالي كاشان. انجذب بالنفحات في أيام حضرة الأعلى (الباب) واشتعل بنار محبة الله. كان في أيام شبابه في نهاية العظمة والأبهة بادي الملاحة صبيح المحّيا وفي إتقان علم الخط لا يضارع، حسن الطباع شجي الألحان فهيمًا موهوبًا ثابتًا في الأمر مستقيمًا في معتقده وكان شعلة من نار المحبة منقطعًا عما سوى الله. وقد بارح مدينة كاشان إلى العراق حيث كان يشرفّها بوجوده الجمال المبارك وحظى بالتشرف بالساحة المقدّسة واتّخذ في الجوار منزلاً وضيعًا وعاش عيشة ضنكًا إذ كان في حالة إعسار شديدة ثم اشتغل بتحرير الآيات والبيانات الإلهية وكان يلوح على جبينه نور الموهبة المبين واضحًا ملموسًا واشتغل بخدمة أمر الله بينما ترك ابنته الوحيدة في إيران قبل وروده إلى دار السلام – بغداد.
وعندما تحرك موكب جمال القدم بكمال العزة والعظمة من بغداد قاصدًا إسلامبول سار جناب منيب بجوار الركب المبارك راجلاً مع أنه عاش في إيران طوال مدة آقامته بها حياة ملؤها الرفاهية والهناء، وذلك معلوم للعموم، وكان لدى أهل بلاده معروفًا بالدلال والحرية ومن كل ذلك يُعلم مقدار ما عاناه من المشاق أثناء سفره راجلاً بجسمه الرقيق من بغداد إلى إسلامبول ومقدار ما لقيه من وعثاء الطريق ولكنه كان
يطوي البيداء بنهاية الروح والريحان مشتغلاً ليل نهار بالتضرع والابتهال وتلاوة الأنجية. وكان هذا العبد (عبدالبهاء) مؤنس قلبه وروحه إذ كنا نسير الواحد منا على اليمين والآخر على اليسار بمحاذاة الركب المبارك أثناء الطريق وكنت أنا وإياه في حالة روحانية يكل عنها الوصف أما هو فكان أثناء الليل مترنم ببعض الأشعار الغزلية من نظم حافظ الشيرازي وكان يقول قبل تغنيه بها: دعونا نرقص ونثمل من خمر المعاني ونتغزل بما قاله الشيرازي. ثم أخذ ينشِد بما معناه:
ولو أنّا للسلطان عبيد ركّع فنحن سلاطين الملك عليه الصبح يطلع
فينا حقيقة الألوان لا تزويرها أسود حمر نحن وفينا التنين الأسود وبالإجمال، إن الجمال المبارك، روحي لأحبائه الفداء، أذن لجناب منيب بالعودة إلى إيران في نفس الوقت الذي تحرك فيه الموكب المبارك من إسلامبول إلى أرض السر (أدرنه) وأمره بالاشتغال بالتبليغ. فصدع جناب منيب بالأمر المبارك وذهب إلى إيران حيث قام بخدمات فائقة على الأخص في مدينة طهران ثم عاد بعد مدة إلى أرض السر وتشرف بالساحة المقدّسة ومكث مدة فائزًا بشرف اللقاء، وعندما وقعت البلية الكبرى يعني حادثة النفي إلى عكاء سار راجلاً بمحاذاة الركب المبارك مع ضعف بنيته وشدة مرضه وعدم قدرته على السفر راجلاً فاشتد عليه المرض غير أنه كان راضيًا كل الرضاء ولم يقبل البقاء في أدرنه ليعالج وكان يود أن يموت تحت قدمي الجمال المبارك. وما أن وصلنا إلى البحر حتى خارت قواه فحمله ثلاثة أنفار وصعدوا به إلى أعلى السفينة التي سارت بنا نحو إزمير، وأراد الربان
إنزاله من السفينة لأنه كان يعاني من شدة المرض وقد أصرّ ربان السفينة على إخراجه، يعني طرحه في اليم، وبعد أخذ ورد صبر القبطان حتى رست السفينة بميناء إزمير وهنا قال الربان للمسؤول الحكومي، الميرالآي عمر بك، إن لم يبارح جناب منيب السفينة فسوف يضطر إلى إخراجه بالقوة لأن السفينة لا تستقبل المرضى بهذا الشكل قانونًا.
ولذا أجبرنا على حمله إلى المستشفى بإزمير وهو في حالة يرثى لها غير قادر حتى على الكلام، وقبل المسير به إلى المستشفى وقع على قدمي الجمال المبارك وبكى بكاءً مُرًا فلاح الحزن على طلعة المبارك من جراء ذلك. وصلنا به إلى المستشفى وعدنا مسرعين إلى السفينة لأن الربان لم يأذن لها بالانتظار أكثر من ساعة واحدة. وكنا قد وجدنا لذلك الوجود المبارك سريرًا خاصًا فوسدناه إياه وقبلناه من رأسه إلى قدميه قبل مبارحتنا المستشفى وعدنا أدراجنا إلى السفينة لأن الحراس لم يمنحونا وقتًا بالمرة، ولم نعلم بعد ذلك عنه شيئًا.
إننا كلما تذكرناه وما انتابه فاضت عيوننا بالدموع وزادت قلوبنا حرقة تحسرًا عليه. كان ذلك الوجود ذا فطنة فائقة ورزانة مثالية لا يضارعه أحد في قوة إيمانه وإيقانه وقد اجتمعت فيه أنواع الكمالات المعنوية والصورية ولهذا كان مورد الألطاف التي لا حد لها.
أما قبره المنور، ففي إزمير ولكنه مهجور، وإذا سنحت الفرص للأحباء فليبحثوا عن ذلك القبر المهجور ويجعلوه بيتًا معمورًا حتى تتعطر مشام زائري ذلك القبر برائحته الطيبة.
(57)كان جناب آقا ميرزا مصطفى النراقي من النفوس الطيبة الطاهرة ذا شخصية محترمة بين كبراء مدينة نراق ومن قدماء أحباء الله مستنير الفؤاد مسبّحًا لله قلبه بستان أوراد نابتة فيه شقائق حقائق المعاني وثمل من صهباء الظهور في أيام حضرة الأعلى (الباب)، روحي له الفداء، وشرب الكأس الطافحة بالنفحات الإلهية، فانجذب انجذابًا عظيمًا وعجيبًا واشتعلت في قلبه نار الشوق الشديد وكان دأبه التضحية في سبيل الله حتى إنه ترك وطنه العزيز وأقرباءه وذويه وكذلك راحته الجسمانية والروحية وفر فرار الحيتان العطاشى إلى البحر الإلهي ووصل إلى العراق واختلط بالأحباء الروحانيين وفاز بشرف اللقاء وعاش زمنًا طويلاً في جوار الألطاف اللاحدّ لها بكمال الروح والريحان إلى أن صدر له الأمر المبارك بالذهاب إلى إيران، وما أن وصل إلى تلك الأقطار حتى قام على خدمة الأمر بكل ما في مكّنته. فقد كان إنسانًا كاملاً ثابتًا وراسخًا في الأمر لا يتزعزع كالجبل الراسي موصوفًا بالرزانة والأمانة، وكان يعتبر نباح الكلاب (الأعداء) كطنين الذباب رغم شدة الانقلاب وعظيم الاضطراب وسببت له البراهين الدامغة على حقيقة الأمر عظيم الراحة وأصبح في نار الافتتان كالذهب الإبريز لا تزعزعه الحوادث.
وبالإجمال، إن هذا الشخص النبيل حضر من إيران إلىالقسطنطينية في نفس اليوم الذي كان فيه موكب الجمال المبارك متوجهًا إلى أدرنه ولم يستطع التشرف باللقاء غير مرة واحدة وأمر في حينها بالعودة إلى إيران قصد نشر النفحات فصدع بما أمر، وما أن وضع قدمه في أذربيجان حتى أخذ في التبليغ وكان لا يفتأ يتلو الأنجية ليل نهار ولعبت في رأسه صهباء الإيمان وهو في مدينة تبريز فهام من شدة الوله الروحي وانكب على التبليغ بكل ما أوتي من قوة وما لبث أن حضر إلى أذربيجان جناب الفاضل الكامل والعالم النحرير الشيخ أحمد الخراساني فاتصل به، وقاما معًا يدًا واحدة على خدمة الأمر يرميان إلى هدف واحد، بكل اشتياق ووله وهيام. ولم يتورعا عن التبليغ جهارًا بين القوم فأدى الحال إلى قيام أهالي تبريز ضدهما ومعاداتهما.
قام الحرس بإلقاء القبض على آقا ميرزا مصطفى لأنهم عرفوه في أول الأمر من خصل شعره التي كانت غير ظاهرة لهم حال إلقاء القبض عليه فما كان من المذكور إلا أنه حسر رأسه وقال ها هو شعري المجعد فلا يعتريكم شك في أنني ذلك الشخص الذي أنتم وراءه فأخذوه هو وذلك الشيخ العظيم بكل عنف وأذاقوهما من العذاب ألوانًا وفي آخر الأمر أسقوهما الكأس الطافحة بصهباء الشهادة في مدينة تبريز فانتقلا إلى الأفق الأعلى. وحدث أن قال آقا ميرزا مصطفى للجلاد: "أرجوك أن تقتلني أولاً حتى لا أشاهد قتل جناب الشيخ رفيع المقام". هذا، وقد رقم القلم الأعلى عدة ألواح مباركة لكل منهما مما يخلد ذكرهما إلى الأبد. ورقم القلم الأعلى ذكر مصيبتهما بعد استشهادهما.
إن ميرزا مصطفى صاحب الشخصية البارزة قام على خدمة الأمر منذ صباه إلى أن بلغ من الكبر عتيّا ووهن منه العظم في سبيل رب
الأرباب. أما اليوم فهو في الملكوت الأبهى في جوار الرحمة الكبرى فرحًا مسرورًا مطمئنًا ومبتهجًا مشتغلاً بتسبيح وتقديس حضرة الكبرياء. طوبى له وحسن مآب بشرى له من رب الأرباب جعل الله له مقامًا عليًّا في الرفيق الأعلى.
(58)كان حضرة زين المقربين من المهاجرين والمجاورين ومن أجلّة أصحاب حضرة الأعلى (الباب) ومن أعاظم أحباب الجمال الأبهى، اشتهر في دورة الفرقان (أيام كان مسلمًا) بالتنزيه والتقديس والتزهّد. وقد مهر مهارة تامة في فنون شتّى، وكان قدوة جميع أهالي – نجف آباد – محترمًا لدى أكابر القوم وعظماء البلاد احترامًا كليًا، قوله القول الفصْل وحكمه جار ونافذ إذ كان العموم يأخذون برأيه، وكان المرجع الخاص والعام. وبمجرد أن بلَغ سمعه خبر ظهور حضرة الأعلى صاح قائلا: "ربنا إنا سمعنا مناديًا يناجي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا". ولم يعبأ بالحياة الدنيا وشقّ جميع الحجبات وكشف السبحات ودفع الشبهات وقام على تسبيح جمال الموعود وتقديسه مشتغلاً بتبليغ ظهور حضرة المقصود واشتهر بذلك في وطنه أصفهان وذاع صيته في الآفاق حتى أصبح مورد الطعن واللعن والأذى من أهل النفاق. وبعد أن كان العوام الذين هم كالهوام يحترمونه بدرجة العبادة قاموا بالتعدي عليه، وكان يلاقي كل يوم من أهل الاعتساف جفاء وأذى وعذابًا من المناوئين له ورغم كل هذا لم يفتر عزمه عن التبليغ بكل ما أوتي من قوة بيان وفصاحة ملجمة وقاوم الأعداء بقلب ثابت ومتانة لا تضارع، وكان غضب الظالمين عليه في ازدياد يومًا بعد يوم وهو يحمل في يده الكأس الطافحة بالبشارات الإلهية ليجعل الكل ثملين من نفحات
معرفة الله غير هيّاب ولا وجل ولم يتطرق إليه عامل الجبن أبدًا مكافحًا في سبيل الله ولكنه قد ضاقت به المسالك بعد حادثة الشاه وأصبح مورد الأذى الشديد صباح مساء. ولما رأى أن وجوده في نجف آباد فيه خطر على الأحباء، سافر إلى العراق.
وبينما كان الجمال المبارك غائبًا في كردستان (السليمانية) مختليًا في مغارة بجبل سمي – سرجلو – وصل جناب زين المقربين إلى بغداد الذي تأثر ولازمه اليأس أولاً لغياب الجمال المبارك وثانيًا عندما رأى أن حالة الأمر في ركود ولا جمع ولا اجتماع للأحباء وأن صيت الأمر ليس في ازدهار ورأى يحيى (الأزل) منكمشًا في ركن من شدة خوفه وخموله آفلاً في زاوية الخمود والخسوف وكلما تحرى عن الأحباء كان نصيبه الخيبة غير أنه التقى ذات يوم فجأة بحضرة الكليم. ولما كانت التقية (عدم إظهار العقيدة) ضاربة أطنابها سافر إلى كربلاء واشتغل بتحرير الآيات والبيانات مدة من الزمن ثم عاد إلى – نجف آباد – ولم يستقر بها لهجوم الأعداء وتعدي الظالمين عليه. وما لبث، عندما نفخ في الصور مرة أخرى أن هبّت فيه روح الحياة الجديدة واستمع بأذن روحه لبشارة ظهور الجمال المبارك وأجاب بقول بلى عندما قرع أذنين رنين طبل – ألست – (بربكم) وحرك لسانه بتبليغ الأمر المبارك بعبارات فصيحة وأدلة عقلية ونقلية قاطعة في إثبات ظهور من يظهره الله وكان حديثه كالماء الزلال لكل عطشان بالبراهين الساطعة من الملأ الأعلى وبزّ الجميع في التقرير والتحرير وكان آية كبرى في التفسير والتوضيح.
ومختصر القول، إنه كان في إيران تحت الخطر العظيم وكان وجوده في – نجف آباد – جالبًا لضوضاء أهل العناد ولهذا، ذهب ذلك الملبّي
للنداء إلى أرض السر (أدرنه) وقصد حرم الكبرياء لابسًا إحرام المحبوب حتى وصل إلى مشعر المقصود ومقامه.
أمضى أوقاتًا في الحضور المبارك ثم صدر له الأمر ومعه حضرة ميرزا جعفر اليزدي بالاشتغال بالتبليغ. فعاد إلى إيران وأخذ في التبليغ وأوصل البشارة بظهور مليك الوجود إلى أعلى علّيّين ثم جاس خلال الديار مدنها وبلداتها وقراها وصحاريها ووديانها صحبة رفيقه جناب ميرزا جعفر المذكور مبشرًا بظهور الجمال المبارك. ثم عاد ثانية إلى العراق وكان كالشمعة التي استضاء بنورها الجميع وسبب الروح والريحان للعموم لا يفتأ يبث الناس النصائح والمواعظ متفانيًا في محبة الله.
ولما وقع الأحباء كأسرى في يد الحكومة ونفتهم ظلمًا وعدوانًا إلى الموصل مشتتين كان على رأسهم جناب زين المقربين يسليهم ويواسيهم ويحل ما ينشأ بينهم من المشكلات ويؤلف بين قلوبهم ويخلق فيهم روح المودة، وأخيرًا طلب من الحضرة الإذن بالإجازة له بالتشرف فحاز طلبه شرف القبول، فسافر إلى السجن (عكاء) وفاز بالمثول بين يدي الجمال المبارك واشتغل بتحرير الآيات وبث روح التشويق بين الأحباء والتأليف بين قلوب المهاجرين حتى أشعل نار المحبة في قلوب الجميع ولم يتوانَ لحظة في الخدمة وكان مورد العناية المباركة ليل نهار وهو يدوّن الكتب والألواح بكل دقة ودون خطأ.
وعلى الجملة، إن هذا الشخص الجليل لم يعتره فتور أو قصور في خدمة النور المبين من بدء حياته إلى أن لفظ النفس الأخير. وبعد الصعود المبارك اشتعلت في قلبه نار الحسرة الشديدة وغلبت عليه دموع الألم فأخذ جسمه في النحول يومًا بعد يوم ولكنه كان ثابتًا مستقيمًا على العهد
والميثاق. وكان أنيسي الوحيد ومؤنسي الفريد يترقب الموت في كل آن ويتمنى الانتقال من هذا العالم حتى وافاه الأجل المحتوم فطارت روحه إلى ملكوت الرحمن بنهاية الروح والريحان فارغًا من الهموم مستغرقًا في محفل أنوار التجلّي. عليه التحية والثناء من ملكوت الأنوار وعليه البهاء الأبهى من الملأ الأعلى وله السرور والحبور في عالم البقاء وجعل الله له في جنة الأبهى مقامًا عليا.
(59)جناب عظيم التّفريشي، هو من المهاجرين والمجاورين وكأن هذا الرجل الإلهي من مقاطعة تفريش لم تأسره القيود ولم يستولِ عليه تشويش الفكر، حرًا بين عارفيه وعشيرته، ومن قدماء الأحباء، ومن سلالة أهل الوفاء. فاز بشرف الإيمان في إيران واشتغل بخدمة كل عبدٍ آمن بالله، وعلى الأخص المسافرين، خدمة صادقة. أتى إلى العراق في معيّة المدعو جناب آقا ميرزا موسى القمي، عليه بهاءالله وعليه التحية والثناء، وفاز بنصيب وافر من ألطاف نيّر الآفاق حاضرًا في محضر الكبرياء في كل حين فائزًا بشرف اللقاء ومظهرًا للألطاف مشمولاً بالعناية والإسعاف. مكث زمنًا طويلاً على هذا الحال ثم عاد إلى إيران في معيّة نفس الشخص الذي صحبه إلى العراق. كان لا يدّخر وسعًا في خدمة أهل البهاء حبًا لله. وقام على خدمة المدعو ميرزا نصرالله التفريشي عدة سنوات دون جُعل أو أجر، وكان إيمانه يزداد يومًا بعد يوم. ثم حضر إلى أرض السرّ (أدرنه) في معيّة هذا الأخير وفاز بشرف اللقاء وداوم على خدمة الأحباء بنهاية المحبة والصداقة وفاز بمرافقة الموكب المبارك من أدرنه إلى عكاء وجاء إلى السجن الأعظم.
وفي السجن أختير لخدمة العائلة المباركة مشتغلاً بالسقاية وحمل الماء داخل السجن وخارجه، وتحمّل داخل القشلة (الثكنة) عظيم المتاعب
والمشاق ولم يهدأ ليلاً أو نهارًا وكان على خلق عظيم وحِلم لا يضارع سليم النيّة يحمل أعباء الأحباء بكل همّة وتجرّد، ويسّر له حمل الماء إلى البيت المبارك الفوز بشرف الحضور يوميًا، وكان يجالس الأحباء ويؤانسهم ويسلّي خاطرهم ويضفي على الجميع كمال السرور والبهجة. وكثيرًا ما قرع مسمعي من الفم المبارك كلمة الرضاء في حقه وكان دائمًا على حال واحد بشوشًا لا يتغير ولا يتبدل ولا يعرف للأذى سبيلا، لا يمل ولا يتكدر يلبي دعوة من دعاه إلى خدمة دون تردد، ثابتًا في إيمانه وإيقانه شجرة نابتة في بستان محبة الله. وبعد أن أدّى السنوات الطوال في خدمة العتبة المقدّسة انتقل من دار الفناء إلى دار البقاء بكمال السكون والاطمئنان مستبشرًا بملكوت الله. فأورث جميع الأحباء حسرة وتأثرًا عليه حتى إن الجمال المبارك كان يواسي الجميع، وكانت عنايات حضرته في شأنه لا تحصى. عليه الرحمة من ملكوت الغفران وعليه بهاءالله في كل عشي وإشراق.
(60)كان ضمن المهاجرين والمجاورين جناب آقا ميرزا جعفر اليزدي، وكان رجل الميدان هذا من طلاب العلوم، وعلى معرفة تامة بشتى الفنون، صرف من أيام حياته مدة في المدارس سبّآقا في ميادين الفقه وعلم الأصول، واسع الاطلاع في المعقول والمنقول. ولما رأى آثار النخوة والتكبّر فاشية بين القوم نَفَرَ أشد النفور وما عتم أن قرع سمعه، وهو على هذا الحال، النداء من الملأ الأعلى حتى قال، على فوره: بلى، و"ربنا إنا سمعنا مناديًا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا".
ولما استفحل أمر القلاقل والاضطرابات والازدحام العجيب في مدينة يزد، سافر من وطنه المألوف إلى النجف الأشرف واندمج مع طلاب العلوم فظهرت قيمته واشتهر بين الطلاب بالعلم والفضل. ولما ارتفع صيت الأمر في دار السلام ذهب إلى بغداد وغيّر زيّه بمعنى أنه استبدل العمامة بالكلاه (الطربوش)، واحترف النجارة لكسب معاشه بعرق جبينه، ثم سافر إلى طهران لمدة يسيرة ثم عاد إلى بغداد واستمر في ظل العناية لابسًا رداء التقشف بالصبر الجميل وسعيدًا رغم فقره.
ورغم ما كان عليه من التضلع في العلوم وعظيم الفضل، كنت تراه في نهاية الخضوع والخشوع فانيًا نفسه، دائم الصمت والسكون. ثم التحق بموكب نيّر الآفاق أثناء السفر من العراق إلى اسلامبول، وكان
شريكًا لهذا العبد (عبدالبهاء) في خدمة الأحباء، فكنا كلما توقف الركب في الطريق وطلب الراحة من شدة التعب من المسير نذهب سويًا إلى القرى المجاورة لابتياع ما يلزم لأفراد القافلة من غذاء وعلف للخيل، وكنا في بعض الأحيان يجبرنا الحال إلى التأخر في القرى إلى منتصف الليل لأن القحط كان عامًا والغلاء فاحشًا في كل مكان. وعلى كل حال كنا لا نعود بخُفيّ حُنَيْن.
وعلى الجملة، فقد كان هذا الشخص الحليم النشط، سليم النيّة لا يبارح العتبة المقدّسة، منكبًا على خدمة الأحباء نهارًا وعلى التعبد ليلاً، دون أن يُسمع له صوت متوكلاً على الله في جميع الأحوال، وداوم على الخدمة في ارض السرّ (أدرنه) حتى حان وقت الرحيل إلى معتقل النفي بعكاء، فكان في عداد المساجين بكمال الرضاء فرحًا مستبشرًا دائم الشكر لله، وكان يقول: "الحمد لله الذي جعلنا في الفلك المشحون". وكان يعتبر المعتقل بستان أوراد، وساحته حديقة غنّاء. وأخيرا، أصابه وهو في المعتقل مرض شديد حتى يئس الطبيب من شفائه فطرحوه أرضًا خارج الثكنة وهو يعالج سكرات الموت. فذهب في الحين المدعو ميرزا آقا جان إلى الساحة المقدّسة وعرض خبر وفاة الميرزا جعفر وأن محبيه يبكون وينتحبون عليه، فتفضل الجمال المبارك لميرزا آقا جان بقوله: "اذهب إليه واقرأ مناجاة (يا شافي) فيعود ميرزا إلى الحياة". فأسرعت أنا (عبدالبهاء) والميرزا آقا جان إلى حيث المريض (أو الميت) فوجدناه بارد الجسم وآثار الموت ظاهرة عليه ثم تلونا المناجاة المشار إليها فما لبث أن تحرك الجسم الهامد رويدًا رويدًا وعاد إلى حالته الأولى. وبعد مضي ساعة واحدة استوى ميرزا جعفر جالسًا وأخذ يمازح ويطايب من حوله.
ومختصر القول، إنه قد عاش بعد ذلك مدة مديدة وهو يوالي خدماته للأحباء ويفتخر بذلك كل الفخر، مؤديًا خدمته للجميع وهو في منتهى التبتل والتذكر قوي الإيمان شديد الإيقان والاطمئنان. وفي آخر الأمر انتقل، وهو في السجن الأعظم، من عالم الناسوت وصعدت روحه إلى عالم اللاهوت.
عليه التحية والثناء، وعليه البهاء الأبهى، وعليه نظر العناية من حضرة الكبرياء. أما قبره المنور ففي عكاء.
(61)جناب حسين آقا التبريزي، كان من جملة المهاجرين والمجاورين. وهذا الشخص المقرب من باب الكبرياء هو النجل العزيز لجناب آقا عسكر التبريزي، وقد بارح مدينة تبريز في معيّة والده بكل شوق ووله إلى أرض السر (أدرنه) ومنها إلى السجن الأعظم بمحض اختياره وميله. وبمجرد وصوله إلى السجن عهد إليه بعمل القهوة للزائرين في نفس المعتقل قائمًا لدى العتبة المباركة بخدمة الأحباء. كان هذا الرجل الأديب حليمًا وسليم النية بدرجة أنه كان يقوم بخدمة كل وافد سواء أكان من الأحباء أو من الأغيار، وكان يظهر العبودية للجميع واستمر على هذا الحال أربعين عامًا لم يتأفف منه أحد خلال هذه المدة ولم يشكَّ أحد منه بالمرة وإن هذا لمن المعجزات حقًا، وإن غيره لم يقوَ على القيام بالخدمات التي أوكلت إليه.
كان على الدوام بشوشًا مسرورًا مواظبًا على القيام بما عهد به إليه من الخدمات بكل إتقان. وكان مخلصًا غيورًا ثابتًا ووقورًا راسخًا في أمر الله حمولاً صبورًا على البلايا. ورغم اشتعال نيران الامتحانات وهبوب أرياح الافتتان التي هدمت كل بنيان بعد الصعود المبارك، فقد دام هذا الشخص الموقن مستقيمًا مع أنه كان يمتّ لبعض أفراد بيت الناقضين بصلة المصاهرة، وأصبح مصداق "لا تأخذه في الله
لومة لائم". ولم يعتره أدنى تزلزل ولم يتوقف في معتقده، بل كان بمثابة الجبل الراسخ لا يتزعزع رزينًا كالحصن الحصين. أما الناقضون فقد أخذوا أمةالله المقدّسة والدته إلى دارهم، حيث توجد ابنتها، وبذلوا ما في وسعهم ليزلزلوها فلم يفلحوا رغم إظهارهم كمال المودّة لها بدرجة تفوق الوصف، وكانوا يخفون عنها نقضهم للعهد.
وما لبثت أن اشتمت منهم رائحة النقض حتى بادرت تلك الأمة المحترمة، بمبارحة القصر إلى عكاء وهي تقول: "إنني إحدى خدّام الجمال المبارك، وليس هناك ما يزعزع ثبوتي ورسوخي على العهد والميثاق. لو كان زوج ابنتي أمير البلاد فليس هناك من فائدة تعود عليّ، ولا تعنيني قرابتي لأحد، ولا تؤثر أمومتي في معتقدي، وإنني لمنصرفة عن جميع المظاهر النفسية، مع ثبوتي على العهد وتمسكي بالميثاق". ومن ثم لم ترض مشاهدة الناقضين، وتبرّأت منهم وارتبطت مع الحق ليتولاها.
ومختصر القول، إن جناب حسين آقا المذكور لم ينفكّ عن عبدالبهاء لحظة، مواظبًا على مؤانستي ولذا كان تعلقي به شديدًا واعتبرت صعوده مصيبة عظمى، وإني أتأثر جدًا كلما تذكرته وتستولي عليّ الحسرة. ولكني أشكر الله، على أن هذا الرجل الإلهي عاش في جوار البيت المبارك مظهرًا للرضاء وكثيرًا ما سمعت من لسان العظمة قوله تعالى: "إن حسين آقا قد خلق لهذه الخدمة".
وأيم الله، إن هذا المؤمن النوراني قد ترك هذا العالم الفاني بعد أن قام بالخدمة أربعين عامًا، وطار إلى العالم الإلهي.
عليه التحية والثناء، وعليه الرحمة من فيض الكبرياء، وحفف جدثه بأنوار ساطعة من الرفيق الأعلى.
أما قبره النوراني ففي حيفا.كان هذا الرجل الجليل من أهالي تبريز، مشتغلاً بالتجارة في أذربيجان، محترمًا بين القوم مشهورًا بتدينه وأمانته وزهده وورعه وتقواه. وجميع أهالي تبريز يقرون له بذلك، ويقدرون مقامه ومكارم أخلاقه وحسن طويته، وينعتونه بعظيم المناقب. هو من قدماء الأحباء وأجلّة المؤمنين.
انصعق منذ النفخة الأولى في الصور، وانجذب إبان النفخة الثانية ونال حياة جديدة، وأصبح شمعة محبة الله، وشجرة مباركة في جنة الأبهى، وآمن على يديه كل أهل بيته وآقاربه وعارفيه، وتوفق إلى عظيم الخدمات. ولمّا وقع في الضيق الشديد وتوالي البلايا من ظلم الأشرار في مدينة تبريز لم يضجر بل تحمل كل ذلك وكان إيمانه وإيقانه يزداد يومًا فيومًا مضحيًا بكل مرتخصٍ وغالٍ في سبيل الله. وأخيرًا ملّ الآقامة في وطنه فسافر هو وأهل بيته إلى أرض السرّ (أدرنه) وأمضى أوقاته بها في حالة إعسار شديد، وعاش بمنتهى القناعة صابرًا وقورًا وراضيًا وشكورًا، وكان يبيع ما تأبطه معه من السلع في الأسواق التي كانت تقام أيام الجمع في أدرنه للحصول على ما يسد رمقه هو وذويه. ولما كانت بضاعته مزجاة، سطت عليها يد النشالين حتى أصبحت في خبر كان. ولما علم قنصل إيران بما حدث قدّم للحكومة
التركية تقريرًا بالحادث وقدّر المسروقات بمبلغ باهظ، فما كان من الحكومة إلا أن ألقت القبض على اللصوص، ولما تبين أنهم من أهل الثراء، استغل القنصل الفرصة واحضر جناب الحاج المذكور وأخبره أن الذين سرقوا سلعه هم من أهل الثراء العظيم، وأنه (القنصل) قد قدّر مبلغًا باهظًا ثمنًا للمسروقات في تقريره للحكومة. وعليه يرى من الواجب على الحاج عسكر في هذا الحال أن يوافق، عندما يدعى للتحقيق، على ما جاء في تقرير القنصل، وذلك ليحصل على مبلغ وافر يتقاسماه معًا، فأجابه الحاج بقوله: "يا جناب القنصل، إن ما سرق مني هو شيء زهيد فكيف أن أقرر خلاف الواقع، وهذا ما سيكون مني إذا دعيت للاستنطاق. وإني لن أعمل بما تقول مهما كان الحال". فقال القنصل: "يا جناب الحاجي، إن الفرصة الآن سانحة لك للحصول على المال الذي سيستفيد منه كلانا فائدة لا بأس بها، فلا تضيّع هذه الفرصة". فقال له ذلك الحبيب: "يا جناب الخان (القنصل)، ماذا يكون جوابي بين يدي الله؟ أرجوك أن تتركني وشأني، وتأكد أنني لا أقول غير الواقع". فاشمأزّ القنصل وهدده وتوعده ثم قال: "أتريد تكذيبي وفضيحتي. لا سبيل من سجنك ونفيك وإيصال الأذى إليك. والآن سأسلمك للشرطة بدعوى أنك من المغضوب عليهم من دولة إيران ويجب أن يقيّدوا يديك بالأصفاد ويسوقوك إلى حدود إيران". فتبسّم ذلك الرجل عظيم الشأن وقال: "يا جناب الخان (القنصل)، إننا قد جعلنا أرواحنا فداء الصدق والأمانة وتركنا كل شيء، وحضرتك الآن تحرضنا على استعمال الكذب والافتراء، فافعل ما بدا لك، ثم اعلم أننا لا نحيد عن عبادة الحق والصدق". فسكت القنصل، ثم التفت إلى ذلك الشخص الجليل وقال له بعبارة ملؤها الرجاء: "من
باب أولى أن تسافر من هنا حتى أكتب للحكومة أن صاحب المال المسروق ليس موجودًا، وإن لم تفعل ذلك فتتضح فضيحتي". فعاد جناب الحاج علي عسكر إلى أدرنه ولم يذكر شيئًا عن أمواله التي سرقت. ولما ذاع صيت هذه المسألة اندهش القوم كل الاندهاش.
وأيم الله، إن هذا الشخص الطاعن في السن، والذي لا نظير له، قد آقام في أدرنه وأصبح في عداد الأسرى كباقي الأحباء، وسار في الموكب المبارك إلى السجن الأعظم الذي هو من أحط السجون. وصبر على السجن مدة طويلة هو وأفراد أسرته حامدًا شاكرًا على أنه قد سجن في سبيل الله، وازداد من جرّاء سجنه بهجة وسرورًا وشغفًا وحبورًا، واعتبر السجن إيوانًا ولم يفُه بكلمة غير الحمد والشكر. وكلما اشتد عليه ظلم الأعداء ازداد سرورًا، وكثيرًا ما جرى من فم المبارك المطهر عبارات العنايات في حقه حيث كان يتفضل بقوله: "إنني راضٍ عنه".
وعلى الجملة، إن هذا الشخص الذي كان روحًا مجسمة قد انتقل من عالم التراب إلى العالم الطهور بعد أن أفنى السنوات الطوال، كان إبّانها مثال الثبوت والاستقامة والفرح والسرور، وخلّف بعده أثرًا عظيمًا، كان أنيس هذا العبد (عبدالبهاء) ونديمه. ومما يجدر بالذكر أنني ذهبت ذات يوم من أيامنا الأولى في السجن إلى الغرفة المتواضعة التي كان يسكنها، فرأيته محمومًا بدرجة لا توصف، وملقى كالسكران مدهوشًا، وزوجته المحترمة عن يمينه وقد اعترتها رعشة شديدة، وعن يساره ابنته المحترمة المسماة فاطمة، وقد أصابتها الحمّى الشديدة، وأمام رأسه ولده حسين آقا مريضًا بالحصبة، وترى أن ذلك الشخص كأنه قد نسي اللغة الفارسية وأصبح يلهج بلغة أهالي أذربيجان ويقول،
(ياندى يوره كم) يعني أن قلبي لفي احتراق، وكانت إزاء قدميه إحدى بناته منكمشة في زاوية من شدة المرض أيضًا، وكان أخوه المرحوم المدعو مشهدي فتاح، يهذي من شدة الحمّى، وهو على هذه الحال، كان لا ينطق إلا بالشكر لله وتلوح عليه إمارات البشاشة والسرور والحمد لله تعالى. ثم صعدت روحه وهو في السجن الأعظم صابرًا شاكرًا ثابتًا ووقورًا إلى جوار الرب الغفور.
عليه البهاء الأبهى، وعليه التحية والثناء، وعليه الرحمة والغفران إلى أبد الآباد.
(63)جناب آقا علي القزويني هو من زمرة المهاجرين والمجاورين، وهو من ذوي الهمم العالية العلوية، عظيم الثبوت والاستقامة، محكم ومتين في قوة الإيمان، ومن الأحباء الأقدمين، ومن أجلّة الأصحاب. انجذب إلى حضرة الأعلى، روحي له الفداء، من أول طلوع صبح الهدى، وقام على هداية الناس. يشتغل في محله بصناعته، وفي الليل يهيئ الموائد والولائم للأحباء الروحانيين الذين كان يدعوهم مع غيرهم، وبهذه الوسيلة كان يتوصل لهداية الخلق، وكان يترنم بنغمات شجية تدل على انجذابه وعشقه الإلهي، همته لا تضارع، وثبوته ورسوخه حدّث عنهما ولا حرج. ولما انتشرت نفحات بستان الأوراد الإلهية، وعطرت مشامه، أشعل النار الموقدة وحرق أستار الأوهام، وأخذ في نشر الأمر المبارك، وكان في الليالي يرتل الآيات والأنجية في المجامع والمحافل بألحان تطرب القلوب وتسترعي الأسماع بدرجة تغبطه عليها الرياض والأوراد مبشرًا بالظهور الأعظم، مُظهرًا كمال المحبة للأحباء والأغيار، ألِفًا وفيًا للجميع، كريمًا، واسع الصدر، ونسج على هذا المنوال إلى أن ضرب ناقوس الرحيل إلى السجن الأعظم (عكاء) فتوجه إليها ومعه أهل بيته وكابد مشاق وعثاء الطريق، ولم يعبأ بما لآقاه من البلايا لشدّة شوقه للقاء المحبوب، ولم تُثْنِ همته الحوادث عن المسير في الوديان
والصحارى حتى ألقى عصاه بعكاء، وآوى في جوار الرحاب المبارك، وعاش في أول الأمر عيشة ناعمة في راحة وهناء، وبعد ردح من الزمن وقع في مخالب الفاقة والإعسار الشديد حتى بلغ به الحال أنه كان في أغلب الأحايين يطوي الضلوع على الجوع حيث لم تصل إلى يده كسرة من الخبز ليسدّ بها رمقه، واستبدل شرب الشاي بالماء القراح.
ورغم كل هذا فكان قانعًا مسرورًا وراضيا بما قسم له، وكان شرف الحضور بالساحة المقدّسة يفيض عليه غيث السرور والحبور، ويعدُّ لقاء المحبوب نعمة موفورة. غذاؤه كان مشاهدة الجمال وشرابه نسمة الوصال، كان دائم البشاشة، قليل الحركة ساكنًا، أما قلبه وروحه ففي نهاية الاشتعال والوله، وكان ألِفًا وفيًا لهذا العبد (عبدالبهاء) بل رفيقًا مسرّا وجليسا محبوبا وأنيسا لا يمل، مقربا لدى الساحة المقدّسة، محترما بين الأحباء والأصحاب، زاهدًا كل الزهد في الدنيا، متوكلاً على حضرة الواحد الأحد، لا يتلوّن ولا يتغير بالمرة ثابتا مستقيما كالجبل الراسخ في الأمر.
إنني كلما تذكّرت صبر هذا الشخص وسكونه وقناعته وثبوته اندفعت، دون تكلّف، إلى طلب الألطاف له من حضرة الأحدية. كان هذا الشخص يشكو باستمرار من الأمراض والعلل والنوازل التي استولت عليه مما كان يكابده من المتاعب والمشاق التي لا تحصى. ولما كان في قزوين وقع فريسة أهل النفاق الذين كانوا يصفعونه على أم رأسه المباركة بالأكف وغيرها، وآثار ذلك ظاهرة حتى الساعة في سمت رأسه ولم تختف حتى لفظ النفس الأخير. ولكم أذاقه الظالمون من العذاب ألوانا، ولكم توالى عليه الأذى من أهل النفاق ولا ذنب له
إلا الإيمان والإيقان، ولا جرم اقترفه سوى محبته لله، على حدّ قول الشاعر:
أزالوا الشعر من رأسي جزافًا بصفعاتٍ شدادٍ لا بموسَى
وكل تعرض لاقيت منهم ولم أر بينهم شخصًا أنيسَافيوسف ما الذي قد كان منه من الإجرام يوم غدا حبيسَا
وهذا مصداق حال جناب آقا علي.وبالاختصار، إن هذا الشخص الجليل مضى كل أوقاته وهو في السجن الأعظم، مشتغلاً بالتبتل والتضرع والتقرب إلى الله، وكان مورد عناية الرب الغفور مشمولاً بالألطاف بدرجة لا حدّ لها، وكان يفوز بشرف اللقاء في أغلب الأحيان، وفي ذلك كان سروره وانشراح صدره وبهجته وارتياحه، حتى وافاه الأجل المحتوم وصعدت روحه إلى العالم اللامتناهي، وطار إلى ملكوت الأسرار واستظل في ظل الجمال.
عليه التحية والثناء، وعليه الرحمة من رب الآخرة والأولى، نوّر الله مضجعه بأنوار ساطعة من الرفيق الأعلى.
(64)إن جناب آقا محمد باقر وآقا محمد إسماعيل، هما من الذين زُج بهم في سجن عكاء في سبيل الله، وهما أخوا المرحوم پهلوي رضا، ويشتغلا بمهنة الخياطة. هاجرا من إيران إلى أرض السرّ (أدرنه) واستظلا في ظل العناية الرحمانية، ثم سافرا إلى عكاء صحبة الجمال المبارك.
أما أخوهما المرحوم پهلوان رضا، عليه الرحمة والرضوان وعليه البهاء الأبهى وعليه التحية والثناء، فكان شخصًا عاريًا عن رداء العلم، مشتغلاً بالتكسب لوقوعه في الفاقة كسائر أهل العشق الإلهي، وأخيرًا خلع رداء الحياة وطار إلى أوج العرفان الأعظم. إنه كان من المؤمنين السابقين. ومع قلة بضاعته قد أدهش أهالي كاشان بما كان يتدفق من فيهِ من البيانات حتى بُهتوا وتملكتهم الحيرة. وقد ذهب ذلك الشخص الأمي، في الظاهر، ذات يوم إلى المدعو الحاج كريم خان، في مدينة كاشان، وسأله قائلاً: "يا جناب الخان، هل أنت الركن الرابع؟ أفدني لأني متعطش لعرفان الركن الرابع لأني أحب أن أكون من عارفيه". ولما كان في محضر الخان المذكور جمع من الأمراء السياسيين والعسكريين، أجاب بقوله: "أستغفر الله، إنني بريء من كل من ادعى أنني الركن الرابع، وأنا لا أدعي ذلك، ومن روى عني مثل هذا الادعاء
فهو كذاب أشر وعليه لعنة الله". ثم زاره پهلوان رضا للمرة الثانية بعد أيام قلائل وقال له: "إنني قد تصفّحت (مؤلّفكَ) الكتاب المعروف ب إرشاد العوام كله، وعلمت منه أنك من الواجب المفروض معرفة الركن الرابع. وأنك، والحقيقة هذه قد ساويته بنفس الإمام صاحب الزمان، ولهذا أرجوك كل الرجاء أن تعرّفني إياه وأين هو، وإني أكرر رجائي أن تدلني عليه". فاشمأز الحاجي المشار إليه وقال: "إن الركن الرابع ليس شخصًا موهومًا بل شخص معلوم ومعروف كشخصي وأنا لابس عمامتي وفوق ظهري عباءتي وعصاي في يدي". فتبسّم پهلوان رضا وقال: "عفوًا يا جناب الحاجي، إن أقوالك متناقضة، إذ قلتَ لي في المرة الأولى شيئًا والآن تقول شيئًا آخر". فحنق الحاجي جدّ الحُنق، ثم قال: "ليس لدي الآن متسع من الوقت، وسنتكلم في هذه المسألة في وقت آخر فاعفني الآن". والمقصود أن هذا الشخص، پهلوي رضا، وإن كان في الظاهر أميّا غير أنه كان مصداق ما قاله العلام الجلّى قد أوقع الركن الرابع في الركن الرابع وألزمه الحجة وحيّره.
ومختصر القول، إن فارس الميدان وغضنفر العرفان هذا (پهلوي رضا) كان كلما حرّك لسانه في المحافل أدهش المستمعين، وكان ملجًا للاجئين، ومساعدًا للطالبين، واشتهر باسم الحق في جميع الآفاق. ثم ترك الرخيص والغالي وصعد إلى الملكوت الأبهى.
أما أخواه العزيزان، فقد وقعا أسيرين في يد الأعداء، ودخلا في عداد المظلومين في السجن الأعظم. وأما هو فقد أسرع إلى الملكوت الأبهى بينما كان في حالة الانقطاع الكلي، وكمال الانجذاب وذلك في أول أيامنا في عكاء التي كان هواؤها في ذلك الحين مسمومًا، حتى
جعل كل وارد عليها عرضة للمرض وملازمةفراشه، وما لبثت الأمراض أن نشبت أظفارها في كل من جناب محمد باقر وآقا محمد إسماعيل ولم يكن هناك وجود للأطباء والعلاج. وصعد هذان النوران المجسمان إلى عالم الأبدية في ليلة واحدة حاضنيْن بعضهما البعض، فتحسّر عليهما الأحباء جدّ التحسّر وبكاهما الكل ليلة صعودهما.
ولما أتيتُ في الصباح لآخذ الرفاتيْن المطهريْن للدفن، حال دون ذلك الحراس وقالوا: "لا يجوز لأحد منكم الخروج من القشلة (الثكنة) فأعطونا الرفاتين حتى نغسلهما وندفنهما وعليكم دفع التكاليف". ولسوء الحظ، لم يكن لدينا ما ندفعه للمصاريف، بل كانت هناك سجادة موضوعة تحت قدمي الجمال المبارك الذي تكرّم حضرته، روحي له الفداء، برفعها من تحت قدميه بغية بيعها وإعطاء ثمنها للحراس لتجهيز الرفاتين ودفنهما. ثم بعنا السجادة المشار إليها بمائة وسبعين قرشًا وسلّمنا هذا المبلغ للحراس، فما كان من هؤلاء الظالمين إلا أن واروا الرفاتين بثيابهما دون غُسلٍ في قبر واحد. ولما كانت روحاهما متحدتين في الملكوت الأبهى، فجسماهما أيضًا يحتضنان بعضهما تحت الثرى.
كانت عناية الجمال المبارك بشأن هذين الحبيبين لا حدّ لها، إذ كانا مشموليْن بالألطاف طوال أيام حياتهما وقد جرى القلم الأعلى بذكرهما في الألواح المباركة بعد وفاتهما.
أما قبراهما ففي عكاء. عليهما التحية والثناء وعليهما البهاء الأبهى وعليهما الرحمة والرضوان.
(65) جناب آقا أبو القاسم السلطان آباديكان في عداد المسجونين جناب آقا أبو القاسم السلطان آبادي، رفيق المدعو آقا فرج في أسفاره. فهذان الشخصان المؤمنان الثابتان المستقيمان، قد بارحا إيران إلى أدرنه بقلب سليم وروح أحيتها نفثات الروح الأمين لأنهما لم يستطيعا البقاء في وطنهما العزيز من ظلم أولي الشأن واعتساف الأعداء، وأخذا يطويان الصحارى والهضاب طليقيْن غير مقيديْن، وتحملا وعثاء الطريق وركوب البحار، ينامان على التراب ويلتحفان السحاب، غذاؤهما ما تنبت الصحراء رغم ندرة الماء، ترعى عيونهما في الليالي نجوم السماء، وبعد التي واللتيّا وصلا إلى أرض السر (أدرنه) في الأيام الأولى من ورود الجمال المبارك إليها فأخذا أسيريْن وذهبا في معيّة الجمال المبارك إلى السجن الأعظم.
وهنا أصيب جناب آقا أبو القاسم بالحمى الشديدة وفارق الحياة، وحكاية دفنه لا تقل،ّ عما حدث للأخوين آقا محمد باقر وآقا محمد إسماعيل السالف ذكرهما، ولا تزيد غير أنهم دفنوه خارج عكاء حيث جسده المطهر الآن. وقد أظهر الجمال المبارك بشأنه كمال الرضاء وقد بكاه جميع الأحباء بكاء مرًا، واحترقت قلوبهم من هذا الفادح الجليل عليه البهاء الأبهى.
أما جناب آقا فرج فقد كان في جميع الأحوال رفيقًا حميمًا لأبي القاسم المذكور وملازمًا له. وما أن ذاع خبر الظهور الأعظم في عراق العجم، حتى تزلزلت أركانه وردد صداه مهللاً وظعن إلى العراق العربي فوجد ضالته وكان سروره لا يقدّر عندما أتى إلى الساحة المقدّسة ودخل في محفل الأنس وفاز بشرف الحضور، وبعد برهة عاد إلى سلطان آباد، يحمل أعظم البشارات، في حين كان أهل النفاق مترصدين للأحباء مشعلين نيران الفساد، وكانوا يفتكون بالأحباء ويسقونهم كأس الشهادة ظلمًا وعدوانًا. وكان بين من استشهدوا ظلمًا واعتسافًا تلك النفس الطاهرة المقدسة (الملا باشي). أما آقا أبوالقاسم وآقا فرج فكانا قد تواريا عن أعين الظالمين ثم سافرا إلى أرض السر (أدرنه) ومن هناك إلى السجن الأعظم (عكاء) في معيّة المحب المحبوب. وهنا انفرد آقا فرج بشرف خدمة الجمال المبارك وملازمة العتبة المقدسة، لا يألو جهدًا في تسلية الأحباء وكان الخادم الصادق في أيام الجمال المبارك والخل الوفي لجميع أهل البهاء. وظلّ بعد الصعود المبارك ثابتا على العهد والميثاق وكالنخلة الباسقة في إظهار عبوديته للأحباء. دام هذا الشخص البارع الصادع ناسجًا على منوال القناعة صابرًا في موارد البلاء.
وبالإجمال، إنه رحل من هذا العالم وهو في كمال الإيمان والإيقان والتوجه، وكان في أيامه مظهر الألطاف اللانهاية. عليه الرحمة والرضوان وعليه التحية في جنة الرضوان وعليه الثناء في فردوس الجنان.
(66)كانت في عداد المهاجرات أمةالله – فاطمة بيگم – حرم حضرة سلطان الشهداء. وقعت هذه الورقة المقدّسة، ورقة الشجرة الإلهية، من أول شبابها في غمار البلايا اللامتناهية وذلك في سبيل الله وكان أول ما انصبّ عليها من المصائب وفاة والدها ذلك الجوهرة النقية بعد أن أضناه التعب ووهن العظم منه في الغربة مما قاساه في طي الصحاري وعظيم المشاق والكروب التي لا حد لها ووافاه الأجل المحتوم في إحدى النزل الريفية في ضواحي بدشت. فتيتّمت هذه المخدّرة من بعده إلى أن ساقتها العناية الإلهية ودخلت في عصمة حضرة سلطان الشهداء.
ولما كان سلطان الشهداء مشهورًا بين الجميع ببهائيته وبانقطاعه الكلي للجمال الرحماني حتى أصبح حيرانا هائما في ذلك الميدان، وحيث إن ناصر الدين شاه كان مولعًا بسفك الدماء والأعداء يقفون بالمرصاد للأحباء ويقومون ضدهم بالسعاية وإثارة كوامن الفتن والاضطرابات. لهذا كله، كانت أسرة سلطان الشهداء غير مطمئنة عليه وتترقب استشهاده في كل لحظة، فاستولى عليهم الاضطراب الشديد لأن الأسرة كلها كانت مشهورة بالبهائية، وكان الأعداء يناوئون أفرادها ظلما وعدوانا، وكانت الحكومة تتعرض لهم باستمرار وكذلك شاه إيران كما ذكرنا.
ومن هذا يتبين حال هذه الأسرة وكيف كانت تعيش والشعب يُظهر لأفرادها كل الكراهية، وتقوم عليهم الغوغاء في كل حين ويشهّرون بهم حتى وقع حادث استشهاد حضرة سلطان الشهداء وحدّث ولا حرج عما أظهرته الحكومة من الوحشية المتناهية التي فزع وجزع لهولها البشر. وما اكتفت بذلك بل نهبت أمواله وبددت ممتلكاته الأمر الذي جعل كامل أفراد الأسرة في حاجة إلى القوت الضروري. أما فاطمة بيكم فقد أخذت في البكاء والنحيب والتحسر ليل نهار وكانت تخفي ذلك على أطفالها رأفة بهم وعليهم رغم التهاب نار الحسرة والأسى بين ضلوعها غير أنها كانت تتلو على الدوام آيات الشكر لله الواحد الأحد لأنها اعتبرت أن كل هذه المصائب والنوائب كانت، والحمد لله، في سبيل نيّر الآفاق وفي محبة كوكب الإشراق. وكل هذا جعل أفراد أسرة سلطان الشهداء ممتازين بين أهل الإيمان، وكانت أمةالله المذكورة كلما حلّت بهم مصيبة قالت بكل إخلاص: "الحمد لله الذي ساوى هذه الأسرة بالأسرة النبوية".
ولما كان التضييق على هذه الأسرة من قبل الحكومة والأعداء على أشده، أمر الجمال المبارك بإحضار جميع أفرادها إلى السجن الأعظم (عكاء) ليعيشوا مطمئنين بجوار الموهبة الكبرى. فأمضوا زمنا هانئين في الجوار الرحماني ورغم كل هذا فقد أصيبت هذه العائلة بوفاة نجل سلطان الشهداء المدعو آقا ميرزا عبدالحسين، فما كان من والدته فاطمة بيگم إلا التسليم والرضاء ولم تجنح إلى النحيب والعويل حتى إنها لم تقِم له عزاء ولم تفه بشيء يدل على التأثر أو التحسر.
كانت هذه السيدة (فاطمة بيگم) متردية برداء الصبر الجميل والوقار شاكرة لله بدرجة تفوق الحدّ، ومع وقوع المصيبة الكبرى والرزية العظمى بصعود
سراج الملأ الأعلى (حضرة بهاءالله) عيل صبرها ونفد استقرارها وزاد اضطرابها وحرقة قلبها حتى أصبحت كالحوت المتبلبل على التراب من شدة العطش ولم تهدأ لها حال ولم تقوَ على تحمل الفراق، فودعت أطفالها وعاجلها الأجل المحتوم وصعدت في جوار الرحمة الكبرى منتقلة إلى ظل عناية حضرة الأحدية واستغرقت في بحر الأنوار.
عليها التحية والثناء، وعليها الرحمة والبهاء، وطيب الله ثراها بصيّب الرحمة من السماء، وأكرم الله مثواها في ظل سدرة المنتهى.
(67)كانت أمةالله المنجذبة بنفحات الله حضرة خورشيد بيگم الملقبة ب شمس الضحى والدة حرم سلطان الشهداء في عداد المهاجرات والمجاورات. وأمةالله المفوّهة هذه، هي ابنة عم الحاج سيد محمد باقر المعروف بالعلم في جميع الآفاق والذي كان أمير العلماء في أصفهان.
ولما فقدت أمةالله هذه، المنجذبة، والديها وهي في سن الطفولة، تولت جدتها أمر تربيتها فترعرعت واشتدت في سراي ذلك العالِم الذي لا يجارَى والمجتهد المشهور سالف الذكر، ونمت في أحضان العلوم والفنون والمعارف. ولما بلغت سن الاحتلام، تزوجت جناب آقا ميرزا هادي النهري. ولما كانت مشام الزوجين قد تعطرت بنفحات العرفان من ذلك النجم الساطع البارع الصادع ألا وهو حضرة الحاج سيد كاظم الرشتي، لهذا رحلا إلى كربلاء صحبة المدعو آقا ميرزا محمد علي النهري شقيق ميرزا هادي المذكور وأخذا يحضران مجالس دروس السيد كاظم لاقتباس أنوار المعارف حتى أصبحت أمةالله المنجذبة (شمس الضحى) متفقهة في المسائل الإلهية وما ترمي إليه الكتب السماوية وتتبعت الحقائق والمعاني بكل دقة. ثم أنجبت ولدًا وبنتًا وهما السيد علي وفاطمة بيگم التي تزوجت بعد سن البلوغ من حضرة سلطان الشهداء.
في أثناء آقامة تلك الأم النورانية (شمس الضحى) في كربلاء، وإذ ارتفع نداء الرب الأعلى من مدينة شيراز قالت: "بلى!"، وآمنت على الفور. وفي تلك الآونة، سافر إلى شيراز قرينها المحترم آقا ميرزا هادي النهري وأخوه المبجّل لأنه قد سبق لهذين الأخوين أن شاهدا جمال النقطة الأولى (الباب)، روحي له الفداء، في ضريح سيد الشهداء (الحسين بن علي) عليه الصلاة والسلام وعند ذلك أخذتهم الحيرة بمجرد مشاهدة شمائله النورانية وخصاله وفضائله الرحمانية حتى قالا لبعضهما: لا شبهة في أن هذا الرجل رجل عظيم ولذا أجابا ب "بلى" بمجرد استماع النداء واشتعلا بنار محبة الله لأنهما كانا يسمعان المرحوم السيد كاظم كل يوم ينادي في مجالسه المملوءة بالفيض ويقول صراحة: "إن الظهور لقريب!"، وإن هذا المطلب غاية في الدقة والرقة وعلى الكل أن يتنسموا أخباره ويتفحصوا أيضًا لعل حضرة الموعود يكون حاضرًا وموجودًا بين الناس. لكن الكل غافلون كما أشير إلى ذلك في بعض الأحاديث (الشريفة).
وما أن بلغ الشقيقان إيران حتى بلغهما أن حضرة الأعلى (الباب) قد سافر إلى مكة المكرمة. لهذا ذهب حضرة آقا سيد محمد علي إلى أصفهان، أما آقا ميرزا هادي فقد عاد إلى كربلاء. وكانت شمس الضحى قد تعرفت في تلك الأثناء بأمةالله ورقة الفردوس أخت جناب باب الباب (ميرزا حسين البشروئي) ثم تقابلت بواسطة هذه الأخيرة مع جناب الطاهرة، وتمكنت عرى الألفة والمحبة والمؤانسة بينهن، وكن يجتمعن ليل نهار ويشتغلن بأمر التبليغ. ولما كان الأمر الإلهي في بدايته كان القوم ينفرون منه بعض النفور. وأدت ملآقاة شمس الضحى بحضرة الطاهرة إلى زيادة انجذابها واشتعالها واستفاضتها التي لا حدّ لها وقد
استمرت في عشرة حضرة الطاهرة في كربلاء مدة ثلاث سنوات تجالسها ليل نهار، وكانت كلما تحدثت تدفق من فمها الحديث كالبحر الزاخر بنسائم الرحمن وهي هائجة مائجة تتكلم بلسان فصيح.
ولما اشتهر أمر الطاهرة في كربلاء وانتشر صيت أمر حضرة الأعلى (الباب)، روحي له الفداء، في أنحاء إيران قام علماء آخر الزمان على تكفير معتنقيه وتحقيرهم وتدميرهم وأصدروا فتوى بقتل عموم أتباع الباب. وقام علماء السوء في كربلاء على تكفير جناب الطاهرة ثم هاجموا بيت شمس الضحى ظانين أن حضرة الطاهرة فيه، ثم أحاطوا بأمةالله المنجذبة (شمس الضحى) وأوسعوها ضربًا وشتمًا ولعنًا وزجرًا وتأنيبًا بدرجة لا توصف ثم سحبوها من الدار إلى السوق، فهجم عليها الأعداء وأوسعوها ضربًا بالعصي وقذفوها بالحجارة وبينما هي على هذه الحال إذ أتى والد زوجها المحترم الحاج سيد مهدي وصاح في القوم قائلا: "إن هذه السيدة ليست بجناب الطاهرة". فلم تصدقه الشرطة والعامة ولم يتركوها ثم طلبوا من حضرة الحاج سيد مهدي أن يأتي بمن يشهد على ما يقول وما لبثوا أن سمعوا أحد الغوغاء يصيح قائلا: "إن قرة العين قد قبض عليها"، ولهذا تركوا شمس الضحى.
ومختصر القول، إن الحكومة وضعت بعضًا من الحراس في بيت جناب الطاهرة ومنعوا الناس من الدخول والخروج حتى تأتي الأوامر من بغداد وإسلامبول. ولما طالت مدة انتظار الأوامر طالبت جناب الطاهرة لها ورفيقاتها بالذهاب إلى بغداد ريثما تأتي الأوامر بشأنها من إسلامبول ويفعل الله ما يشاء. فلبّت الحكومة طلبها فسافرت من
كربلاء هي وجناب ورقة الفردوس ووالدتها وجناب شمس الضحى إلى بغداد وكان الرعاع يرجمونهن بالحجارة على مسافة من كربلاء ولما وصلن بغداد نزلن في بيت حضرة الشيخ محمد شبل والد جناب آقا محمد مصطفى البغدادي. ولما كثر الوافدون على جناب الطاهرة هاج أهالي ذلك الحي فاضطرت إلى الانتقال إلى منزل خاص بجهة أخرى من المدينة وداومت على التبليغ وإعلاء كلمة الله ليل نهار وكان يفد عليها العلماء والمشايخ وغيرهم، ويلقون عليها بعض الأسئلة فكانت تجيبهم بما يقنعهم واشتهرت في بغداد شهرة عجيبة لأنها كانت تتكلم في المسائل الإلهية ذات الشأن والدقة. ولما علمت الحكومة بذلك نقلتها هي وشمس الضحى وورقة الفردوس إلى دار المفتي حيث أقمن مدة ثلاثة شهور حتى وصلت الأوامر من إسلامبول بشأنهن.
أما مفتى بغداد فكان دائمًا يحادثهن ويناقشهن مدة آقامتهن في داره وكن يقمن له الحجج والبراهين القاطعة على دعواهن وكن يشرحن له المسائل الدينية شرحًا وافيًا ويتباحثن معه في مسائل الحشر والنشر والحساب والميزان ويوضحن له معضلات الحقائق والمعاني.
تصادف أن حضر والد المفتي إلى الدار ذات يوم، وما أن وقع نظره على جناب الطاهرة ورفيقاتها حتى انهال عليهن بما لا يليق من الألفاظ النابية، وكان المفتي حاضرًا فاستاء مما كان من والده واعتذر للسيدات ثم أخبرهن بورود الأوامر بشأنهن من إسلامبول تفيد أن السلطان العثماني قد عفا عنهن شريطة مغادرة الدولة. فخرجت في صباح اليوم التالي من بيت المفتي وتوجهت إلى الحمام، وبعد عودتها أخذ جناب الحاج الشيخ محمد شبل وجناب الشيخ سلطان العربي بتهيئة لوازم السفر وبعد ثلاثة أيام بارحت جناب الطاهرة
بغداد هي وجناب شمس الضحى وجناب ورقة الفردوس ووالدة آقا ميرزا هادي ونفر من سادات مدينة يزد قاصدين إيران والذي تولى الصرف على هذه الرحلة من جيبه الخاص هو جناب الشيخ محمد شبل إلى أن وصلوا مدينة كرمانشاه فنزلت المخدّرات في دار على حدة والرجال في بيت آخر واستمر أمر التبليغ على ما كان عليه في بغداد ولما علم العلماء بذلك حكموا بإخراج الجميع من المدينة وهذا حفّز حاكم المدينة وأناسًا آخرين على مهاجمة السيدات ونهب ممتلكاتهن ثم أركبوا السيدات هودجًا مكشوفا وذهبوا بهن إلى الصحراء حيث تركوهن في العراء يتخبطن في البادية بلا زاد ولا فراش. عند ذلك، كتبت الطاهرة لوالي كرمانشاه تقول: "إننا مسافرون وضيوف (وجاء في الحديث): "أكرموا الضيف ولو كان كافرا فهل من اللائق والجائز إهانة الضيف وتحقيره؟"، وما أن وصل ذلك إلى الوالي حتى أمر بإعادة المسروقات وكل ما سلب من السيدات. فأعيدت في الحال إليهن بتمامها ثم أحضروا لهن الركائب من المدينة وأركبوهن إلى همدان حيث توافدت عليهن النساء حتى نساء العائلة المالكة لملاقاة جناب الطاهرة يوميًا.
آقامت جناب الطاهرة ومن معها في همدان مدة شهرين وفي غضونهما سمحت لبعض من كانوا برفقتها بالعودة إلى بغداد ورافقها الباقون إلى مدينة قزوين وبينما هي في الطريق إذ أتى ركب من آقاربها يعني إخوانها وقالوا لها: "إننا أتينا إلى هنا بأمر والدنا وإرادته حتى نأخذك منفردة إلى الدار. أما جناب الطاهرة فلم تقبل ذلك ومن ثمّ وصلوا جميعًا إلى قزوين. وذهبت جناب الطاهرة إلى دار أبيها مع رفيقاتها أما الرجال فقد نزلوا في نُزُل.
وكان جناب آقا ميرزا هادي قرين شمس الضحى قد عاد إلى قزوين منتظرًا إيّاها بعد أن تشرف بحضور حضرة الأعلى (الباب) في قلعة ماه كو (يعني قلعة جبل القمر)، ثم اصطحبها إلى أصفهان، ومنها توجه جناب آقا ميرزا هادي إلى قرية بدشت التي لاقى فيها وفي ضواحيها من الأذى والجفاء والمشاق والابتلاء وما لا يدخل تحت حصر فضلاً عن رجمه بالحجارة حتى أدركته المنية في إحدى النُزُل الخربة فدفنه أخوه المدعو آقا ميرزا محمد علي على رأس الطريق بين أصفهان وبدشت أما شمس الضحى فقد بقيت في أصفهان مشغولة بذكر الله في جميع آناتها قائمة بتبليغ أمرالله بين النساء بلسان فصيح بتوفيق من الله ومؤيدة بالبيان البديع وكانت ماجدات أصفهان يحترمنها كل الاحترام، وكان الكل على بيّنة من زهدها وورعها وتقواها وعفّتها المجسمة وعصمتها المشخّصة وهي مشتغلة إما بترتيلها للآيات ليل نهار أو بتفسير آيات الكتاب أو بشرح غوامض المسائل الإلهية أو بتبليغ أمرالله ونشر النفحات القدسية. فسبب كل ذلك اقتران حضرة سلطان الشهداء، روح المقربين له الفداء، بابنتها المحترمة أما هي فقد سكنت في سراي صهرها حضرة سلطان الشهداء فتوالت عليها الزائرات من النساء الماجدات ممن تعرف وممن لا تعرف من الأحباء والأغيار فزاد ذلك من اشتعالها بنار محبة الله وانجذابها إلى إعلاء كلمة الله بكل ما في مكنتها حتى لقبها الأغيار "فاطمة الزهراء" عند البهائيين.
ولما استمر الحال على هذا المنوال اتفق كل من الرقشاء والذئب (أما الرقشاء فهو المدعو ميرزا محمد حسين إمام الجمعة بأصفهان، والذئب هو المدعو الشيخ محمد باقر الأصفهاني قد جرى القلم الأعلى بتلقيب الأول بالرقشاء والثاني بالذئب) وأصدرا فتوى بقتل
حضرة سلطان الشهداء وشقيقه حضرة محبوب الشهداء فباغتهما بالهجوم عليهما كل من الرقشاء وأعوانه والذئب والجلادون والشرطة المملوءة قلوبهم بالجفاء وصفدوهما بالسلاسل والأغلال وساقوها إلى السجن ثم سطوا على سرايهما وبددوا محتوياتها ولم تنج الأطفال الرضع من أذاهم وصبوا على أقرباء هذين الشخصين المقدّسين سياط الطعن واللعن والسب والضرب والتعذيب بدرجة لا توصف.
وقد حكى لي أثناء وجودي في باريس المدعو – ظل السلطان – مؤكدًا ما حكاه بالأيمان المغلّظة بأنه طالما نصح هذين السيدين الجليلين بالإقلاع عن معتقدهما دون جدوى. وقال: "إنني دعوتهما ذات ليلة وألححت عليهما بترك ما هما عليه، وأريتهما أن حضرة الشاه قد أمر بقتلهما ثلاث مرات، وقد أتى المرسوم الشاهاني بالحكم القطعي في هذا الصدد، وإذًا لا مفر من أنكما تتبرآن من هذا الدين أمام العلماء. فأجابا بما يلي: "يا بهاء الأبهى، إن روحينا مقدمتان قربانًا"، وفي النهاية قبلت أن يقولا: "إننا لسنا بهائييْن، وقلت لهما إنني أكتفي بهاتين الكلمتين وأحرر واقعة الحال لجلالة الشاه متخذا إقراركما وسيلة لخلاصكما ونجاتكما"، فقالا: "إن هذا لا يكون منا أبدًا، إننا بهائيان، يا بهاء الأبهى! إننا لمتعطشان لشرب كأس الشهادة الكبرى". فاغتظت وخاطبتهما بحدة وشدة علّهما ينصرفا عن تصميمهما فما أمكن، فاضطررت أخيرًا إلى تنفيذ ما جاء بالفتوى التي أصدرها الرقشاء والذئب الضاري".
وبالإجمال، إن رجال الحكومة، بعد استشهاد هذيْن الشخصين تعقبوا السيدة شمس الضحى التي اضطرت أن تذهب إلى بيت أخيها، والحال أن أخاها لم يكن مؤمنا تمامًا وهو مشهور في أصفهان بالزهد
والتقوى والعلم والفضل والاعتكاف والانزواء ولذا أصبح محل احترام الجميع واعتمادهم، وظلّت الحكومة تتعقبها وتبحث عنها إلى أن علمت بمكانها فاستدعتها، بالاتفاق مع علماء السوء. فاضطر أخوها أن يأخذها إلى بيت الحاكم، فدخلت إلى محل الحريم أما أخوها فقد انتظرها خارج باب الدار، وما أن وصلت إلى مدخل محل الحريم قابلها الحاكم وأخذ يركلها بكل ما أوتي من قوة حتى سقطت على الأرض مغشيًا عليها، وعند ذلك نادى الحاكم زوجته وقال لها، انظري فاطمة البهائيين الزهراء، ثم نقلوها إلى إحدى الغرف وأخوها خارج السراي محتار في أمره، وأخيرًا تقدم إلى الحاكم ليشفع لأخته، ثم قال: "إن أختي هذه قد أوشكت على الموت من شدة الضرب، فما الفائدة من وجودها في داركم ما دام الأمل في حياتها مفقود، وأملي أن تسمحوا لي بأخذها إلى دارنا، إذ من باب أولى أن تقضي نحبها هناك، مع العلم بأن هذه السيدة من السلالة الطاهرة، لم تقصّر ولم تقترف جرمًا –وذنبها- فقط أنها منسوبة إلى زوج ابنتها". فقال الحاكم: "إنها لمن صناديد البهائيات، ولا بد من أنها سوف تحدث هيجانًا بعد"، فقال أخوها: "إنني أتعهد بأنها لا تنبس ببنت شفة ومن المؤكد أنها سوف لا تعيش إلا أيامًا قليلة، إذ إنها جسم بلا روح ولا حياة، وقد أخذ الضعف منها كل مأخذ، ووهن العظم منها وأصبحت عرضة لمختلف الصدمات".
ولما كان أخوها محترمًا للغاية ومحل اعتماد الخاص والعام، لهذا، سمح له الحاكم وسلّمه أخته (شمس الضحى). فمضت في دار أخيها أيامًا تبكي وتنتحب ليل نهار وكأنها في مأتم وعزاء، وهذا أقلق راحة أخيها، والأعداء لا يفترون عن مناوأتها وقَلْبِ ظهر المجن لها
يوما إثر يوم. ولما شاهد أخوها ذلك، رأى من المصلحة، حسمًا للضوضاء والغوغاء، أن يأخذها إلى مشهد قصد زيارة أهل البيت، وأسكنها في بيت على حدة، بجوار ضريح حضرة علي بن موسى الرضا عليه السلام. ولما كان أخوها غارقًا في بحار الزهد والتقوى، كان لا ينقطع عن زيارة أضرحة آل البيت في كل يوم من الصباح الباكر إلى الزوال وبعد الظهر يذهب إلى البقعة المباركة قصد التعبد والصلاة وتلاوة الأدعية والأذكار إلى آخر النهار. وكانت شمس الضحى، أثناء تغيب أخيها عن البيت، تعقد مجالسًا لنساء الأحباء وتتحدث إليهن لأنها كانت لا تتحمل السكوت لاشتعال نار محبة الله في قلبها، وكانت نساء الأحباء يكثرن من الذهاب إليها ويستمعن لبياناتها التي كانت تلقيها بلسان فصيح وعبارات بليغة.
وعلى الجملة، إنه لما كانت الأحوال في شدة الصعوبة في مشهد، في تلك الأيام، وكان الأعداء يتعقبون الأحباء، حتى إنهم إذا ما عثروا على أحد من الأحباء قتلوه، وانعدمت الراحة والأمان. أما شمس الضحى، فقد أخذ من يدها زمام الاختيار، واستمرت على ما هي عليه ورمت بنفسها في غمار البلايا غير هيابة ولا وجلة ولم تهدأ عن التبليغ. ولم يكن عند أخيها خبر عما تجريه، لأنه لم يعاشر أحدا ويمضي نهاره وليله في الزيارات للأضرحة المذكورة ويعود إلى البيت قصد النوم، ولم يعرف أحدا في تلك الجهة لانزوائه، حتى كان لا يحادث أحدا. ومع كل هذا، فقد شاهد في المدينة غاغة ولغطًا يؤديان إلى شديد التصادم (مما تجريه أخته). ولما كان دائمًا ساكنًا لا يُسمع له صوت، فلم يتعرض لأخته بل أخذها توًا إلى أصفهان وأرسلها إلى دار ابنتها حرم سلطان الشهداء، ولم يُنزلها في داره.
وبالاختصار، إن شمس الضحى أمضت أيامًا في أصفهان وكانت جريئة في إلقاء البيانات الأمرية، وبكل جسارة كانت تنشر نفحات الله. ومن اشتعالها بنار محبة الله كانت تفتح لسانها بالتبليغ لكل طالب، ولما كان متوقعًا وقوع أسرة سلطان الشهداء مرة أخرى في المصائب الشديدة وأن تصبح في شديد المتاعب والقلق، لهذا، تعلقت إرادة المبارك بأن تحضر هذه الأسرة إلى السجن الأعظم، وصدر لها الأمر المبارك بذلك. فسافرت شمس الضحى وحرم سلطان الشهداء وجميع الأطفال إلى الأرض المقدّسة، وأمضى جميعهم فيها أوقاتهم في غاية من الروح والريحان والسرور الذي لا مزيد عليه إلى أن توفي، في مدينة عكاء، نجل حضرة سلطان الشهداء المدعو آقا ميرزا عبدالحسين، متأثرًا بمرض السل الذي أصابه في أصفهان، فضلاً عما لآقاه من المصاعب والصدمات. فتأثرت لوفاته السيدة شمس الضحى وحزنت حزنًا عظيمًا، واكتوت بنار الفرقة والحسرة، وعلى الأخص، لحدوث المصيبة الكبرى والرزية العظمى (وهي الصعود المبارك) فتزلزل بنيان حياتها، وأخيرا وهنت قواها فلازمت الفراش بعد أن كانت كالشمعة المضيئة. مع كل هذا لم تركن إلى السكوت والسكون، إذ كانت طورًا تتحدث عن أيامها السالفة، وطورًا عن الوقائع الأمرية، وطورًا ترتل الآيات البينات، وطورًا تتضرع وتتلو الأنجية، حتى طارت وهي في السجن الأعظم إلى العالم الإلهي، وتخلصت من عالم التراب وخلعت الثوب الترابي، ورحلت إلى عالم الأنوار. عليها التحية والثناء وعليها الرحمة العظمى في جوار رحمة ربها الكبرى.
اللوح الذي نزل بشأنهاوإنك أنت يا إلهي، ترى في جوار روضتك الغناء وحوالي حديقتك الغلباء مجمع أحبائك واجتماع أرقائك في يوم من أيام عيدك الرضوان يوم السعيد الذي فيه أشرقت بأنوار تقديسك على الممكنات وأظهرت أنوار توحيدك على الآفاق. وخرجت من الزوراء بقدرة وسلطنة أحاطت الآفاق، وعظمة خرت لها الوجوه وذلت لها الرقاب وعنت لها الوجوه وخضعت لها الأعناق متذكرين بذكرك منشرحين الصدر بأنوار ألطافك، ومنتعشين الروح بآثار إحسانك، وناطقين بالثناء عليك ومتوجهين إلى ملكوتك ومتضرعين إلى جبروتك، ليتذكروا بذكر أمتك المقدّسة النوراء وورقة شجرة رحمانيتك الخضراء، الحقيقة النورانية والكينونة المتضرعة الرحمانية التي ولدت في حضن العرفان ورضعت من ثدي الإيقان ونشأت في مهد الاطمئنان وانتعشت في حجر محبتك يا رحيم ويا رحمن، وبلغت أشدها في بيت انتشرت منها نفحات التوحيد على الآفاق، وأصابتها الضرّاء والبأساء في صغر سنها في سبيلك يا وهّاب وتجرعت كؤوس الأحزان والآلام منذ نعومة أظفارها حبا بجمالك يا غفار.
إلهي أنت تعلم البلايا التي احتملت بكل سرور في سبيلك، والرزايا التي قابلتها بوجه طافح بالسرور في محبتك. فكم من ليال استراحت النفوس في مضاجعهم، وهي تبتهل وتتضرع إلى ملكوتك. وكم من أيام اطمأنت عبادك في حصن أمنك وأمانك وهي مضطربة القلب مما جرى على أصفيائك.
فيا إلهي، مضت عليها أيام وأعوام، كلما أصبحت بكت على مصائب أرقائك، وكلما أمست ضجت وصرخت واحترقت حزنا على ما ورد على أمنائك، وقامت بجميع قوائها على عبادتك والتضرع إلى سماء رحمتك والتبتل إليك والتوكل عليك. وظهرت بإزار التقديس في حلل التنزيه عن شؤون خلقك إلى أن دخلت في ظل عصمة عبدك الذي أكرمت عليه بمواهبك الكبرى، وأظهرت فيه آثار رحمتك العظمى، ونوّرت وجهه بنور البقاء في ملكوتك الأبهى، وأسكنته في نزل اللقاء في الملأ الأعلى، ورزقته كل الموائد والآلاء ولقبته بسلطان الشهداء. فعاشت أعوامًا في حمى ذلك النور المبين، وخدمت بروحها عتبتك المقدّسة النوراء بما كانت تهيئ الموائد والمنازل والمضاجع لعموم أحبائك، وليس لها سرور إلاّ ذلك. فخضعت وخشعت وبخعت لكل أمَةٍ من إمائك وخدمتها بروحها وذاتها وكينونتها حبا بجمالك وطلبا لرضائك إلى أن اشتهر بيتها باسمك وشاع صيت قرينها بنسبته إليك. واهتزت وربت أرض الصاد بنزول ذلك الفيض المدرار من ذلك الجليل المغوار وأنبتت رياحين معرفتك وأوراد موهبتك واهتدى جمّ غفير إلى معين رحمانيتك، فقاموا عليه جهلاء خلقك والزنماء من بريتك وأفتوا بقتله ظلما وعدوانا وسفكوا دمه الطاهر جورا واعتسافا، وذلك الرجل الجليل يناجيك تحت اهتزاز السيف ويقول: "لك الحمد يا الهي على ما وفقتني على هذا الفضل المشهود في اليوم الموعود واحمرت الغبراء بثاري في سبيلك وأنبتت بأزهار حمراء. لك الفضل ولك الجود على هذه الموهبة التي كانت أعظم آمالي في حيز الوجود. ولك الشكر بما وفقتني وأيدتني وسقيتني هذا الكأس الذي مزاجها كافور في يوم
الظهور عن يد ساقي الشهادة الكبرى في محفل الحبور. إنك أنت المعطي الكريم الوهّاب.
وبعد ما قتلوا أغاروا إلى بيته المعمور وهجموا هجوم الذئاب الكاسرة والسباع الضارية ونهبوا الأموال وسلبوا الأمتعة والحليّ والحطام، فكانت هي مع أفلاذ كبدها في خطر عظيم. وكان هذا الهجوم الشديد عند انتشار نبأ قتل الشهيد. فضج الأطفال وارتعب قلوب الأولاد وبكوا وصرخوا وارتفع العويل من ضواحي ذلك البيت الجليل فلم يرثِ لهم أحد ولا ترق لهم نفس، بل زادوا الظلمة طغيانا واشتد جحيم الاعتساف نيرانا فما ابقوا من عذاب إلاّ أجروه وما بقي من عقاب إلا نفذوه وبقت هذه الورقة المباركة مع أطفالها تحت سلطة الظالمين وتعرض الغافلين بلا ناصر ومعين وقضت أيامها وأنيسها بكاؤها وجليسها ضجيجها وقرينها أحزانها وخدينها آلامها. وما وهنت يا إلهي مع كل هذه الآلام في حبك ولا فترت يا محبوبي مع هذه الأحزان في أمرك فتتابعت عليها المصائب والرزايا، وترادفت عليها المحن والبلايا، وتحملت وصبرت وشكرت وحمدت على هذه المحنة العظمى وعدتها أنها هي المنحة الكبرى يا ذا الأسماء الحسنى، ثم تركت وطنها وراحتها ومسكنها ومأويها وطارت كالطيور مع أفراخها إلى هذه الأرض المقدّسة النوراء حتى تتعشش في أوكارها وتذكرك كالطيور بألحانها وتشتغل بحبك بجميع قويها وخدمتك بقلبها وروحها وكينونتها وخضعت لكل أمَةٍ من إمائك وخشعت لكل ورقة من أوراق حديقة أمرك وانقطعت عن دونك وتذكرت بذكرك وكان يرتفع ضجيجها في الأسحار وصوت مناجاتها في جنح الليالي ورابعة النهار إلى أن رجعت إليك وطارت إلى
ملكوتك والتجأت إلي عتبة رحمانيتك وصعدت إلى أفق صمدانيتك.
أي رب أجبها بمشاهدة لقائك وارزقها من مائدة بقائك وأسكنها في جوارك وارزقها ما تحب وترضى في حديقة قدسك وأكرم مثواها وظلل عليها بسدرة رحمانيتك، وأدخلها في خيام ربانيتك واجعلها آية من آياتك ونورا من أنوارك. إنك أنت المكرم المعطي الغفور الرحيم.
(68) جناب الطاهرةمن النساء الطاهرات والآيات الباهرات اللائي هن قبس من نار محبة الله وسراج موهبة الله – جناب الطاهرة التي كان اسمها المبارك – أم سلمة – وهي ابنة الحاج ملا صالح المجتهد القزويني شقيق الملا تقي إمام الجمعة في قزوين.
اقترنت (الطاهرة) بالمدعو ملا محمد ابن الحاج ملا تقي المذكور ورزقت منه بثلاثة أولاد وهم ذكران وبنت واحدة. هؤلاء الأولاد الثلاثة حرموا من المواهب التي نالتها والدتهم.
وبالإجمال، إن أباها قد عين لها معلّما منذ طفولتها. فجدّت في تحصيل العلوم والفنون حتى طال باعها وعلا كعبها في علوم الأدب بدرجة أن أبويها قالا: "لو كانت هذه الابنة ولدًا ذكرًا لأصبح ربّ المنزل ولأخذ مقام والده بين فضلاء القوم".
وبينما كانت الطاهرة في دار ابن خالتها المدعو – ملا جواد – ذات يوم، إذ عثرت في مكتبته على كتاب من مؤلفات المرحوم الشيخ أحمد الإحسائي فتصفحته، وما كادت أن تأتي على آخره حتى بهرتها عباراته وراقت لها آراؤه ثم طلبت من ملا جواد أن يعيرها إياه لتطالعه في
خلوتها. فأكبر الملا ذلك وقال لها: "كيف أعيرك إياه وأبوك هو ضد كلٍ من النورين النيرين الشيخ أحمد الإحسائي والسيد كاظم الرشتي، والحقيقة، إذا استشم أنه قد وصل إلى سمعك أو أنك قد وقفت على شيء من نفحات المعاني المتضوعة من رسائل هذين العظيمين لقام على قتلى ولحل عليك غضبه الشديد". فقالت الطاهرة: "اعلم أنني، كنت ولا أزال متعطشة إلى تجرّع مثل هذا الكأس الصافي ومتشوقة لمثل هذه البيانات والمعاني منذ أمد غير قصير. وعليه أرجوك أن تتكرم على بكل ما لديك من هذه المصنفات ولو أدى الحال إلى اشمئزاز والدي". فارتاح الملا جواد لجوابها ولهذا أرسل لها كل ما وصل إلى يده من مؤلفات حضرتي الشيخ والسيد.
وتصادف أن دخلت الطاهرة على والدها ذات ليلة وهو في غرفة المطالعة وفاجأته بالتحدث عن مطالب المرحوم الشيخ أحمد الإحسائي وخاضت في مسائله. فما كاد والدها يفهم من كلامها أنها لعلى بينة من مطالب الشيخ حتى انهال عليها بالسب والشتم والتأنيب، ثم قال لها: "إن الميرزا جواد (يعني الملا جواد المذكور) قد أضلك السبيل". فقالت: "يا أبتِ، إنني قد استنبطت من مؤلفات ذلك العالم الرباني – حضرة الشيخ المرحوم – معانٍ لا حصر لها، لأن مضامين كل ما جاء به مستندة إلى روايات الأئمة الأطهار. والمعلوم أن حضرتك، أيها الوالد المحترم، تدعو نفسك عالمًا ربانيًا وتعتبر عمي المحترم فاضلاً ومظهرًا لتقوى الله. والحال أن لا أثر مشهود فيكما من تلك الصفات".
ثم أخذت تباحث أباها في مسائل القيامة والحشر والنشر والبعث والمعراج والوعد والوعيد وظهور حضرة الموعود حتى ضاق والدها
ذرعًا لقلة بضاعته ولم يقوَ على دحض حججها وأخيرًا أمطرها وابلاً من السباب واللعنات. وحدث أنها روت لأبيها ذات ليلة حديثًا من المأثور عن جعفر الصادق عليه السلام لإثبات مدعاها. ورغم أن الحديث كان برهانًا دامغًا على مدعاها فقد جنح أبوها إلى السخرية والاستهزاء. فقالت: "يا أبتِ، إن هذا من البيانات المنسوبة لحضرة جعفر الصادق عليه السلام فَلِمَ تستوحش منه وتظهر السخرية. وفي النهاية، قطعت حبل المذاكرة والمناقشة مع والدها وكانت تكاتب حضرة المرحوم – السيد الرشتي - وتستخبر منه عن جل المسائل الإلهية المعضلة. وهذا ما جعل حضرته يلقبها ب "بقرة العين" حتى إنه قال: "حقًا، إن قرة العين أزاحت الستار عن وجه مسائل المرحوم الشيخ أحمد الإحسائي". وقد نالت هذا اللقب في أول الأمر وهي في مدينة بدشت واستصوبه حضرة الأعلى (الباب) وجرى به قلمه في ألواحه المباركة. فأثّر ذلك في الطاهرة أيّما تأثير وأهاجها حتى إنها سافرت إلى كربلاء قصد التشرف بملآقاة الحاج سيد كاظم الرشتي. وما أن وصلت كربلاء حتى علمت أن السيد قد انتقل إلى الملأ الأعلى قبل وصولها بعشرة أيام ولذا لم يتيسر لها ملآقاته.
كان حضرة السيد الرشتي المرحوم يبشر تلاميذه، قبل وفاته، بظهور الموعود ويقول لهم: "اذهبوا وجوسوا خلال الديار وطوفوا في الأرض وابحثوا عن سيدكم". فذهب نفر من أَجِلَّةِ تلاميذه إلى الكوفة واعتكفوا بمسجدها واشتغلوا بالرياضة (التنسّك). وذهب بعضهم إلى كربلاء مترصدين ظهور الموعود وكان من جملتهم حضرة الطاهرة التي أشغلت نفسها بالصوم نهارًا وبالتهجد وتلاوة الأنجية ليلاً. وبينما هي سابحة في هذا الخضم إذ رأت رؤية صادقة في وقت السَّحر وهي
منقطعة عن العالم فرأت سيدًا شابًا بعمامة خضراء يرتدي عباءة سوداء وما أن وقع قدمه على الأرض حتى ارتفع إلى أوج الهواء ثم انتصب يصلي ويتلو في قنوته بعض الآيات. فحفظت حضرتها آية مما كان يتلوه. ولما استيقظت دوّنتها في مذكرتها. ولما انتشر، بعد ظهور حضرة الأعلى (الباب) كتابه الموسوم بأحسن القصص (قيوم الأسماء)، تناولته وبينما هي تتصفحه إذ وقع نظرها على نفس الآية التي حفظتها في المنام (كما ذكرنا) فقامت على الفور بشكران الله وخرّت على الأرض للحق وأيقنت أن هذا الظهور حق لا ريب فيه. وعندما بلغتها البشرى بظهور الموعود وهي في كربلاء أخذت في التبليغ وكانت تترجم للقوم أحسن القصص وتفسير آياته لهم. ثم إنها وضعت مصنفات باللغتين الفارسية والعربية ولها منظومات في الغزل وغيره من الروحانيات وكانت عظمة خضوعها وخشوعها ظاهرة للعيان ولم تترك مستحبًا حتى أوردته.
ولما بلغ علماء السوء في كربلاء خبرها، وتأكدوا أن هذه السيدة تدعو الناس إلى أمر جديد، وأن دعوتها قد انتشرت، رفعوا شكايتهم إلى الحكومة وكانت النتيجة قيام المعارضة والتعرض الشديد من قبل الهيئة الحاكمة، بل ومن كل الجهات. وعندما قامت الحكومة بالتحقق في الأمر اعتقدت بأن شمس الضحى هي جناب الطاهرة ولهذا تعرّضوا لها. وعندما علم الأعداء بأنه تمّ إلقاء القبض على جناب الطاهرة أفرجوا عن شمس الضحى، ومن ثمّ أرسلت جناب الطاهرة رسالة إلى الحكومة تقول إنها مستعدة لإجابة كل ما تطلبه الحكومة ولا لزوم للتعرض لشمس الضحى. وما لبثت الحكومة أن وضعت دار الطاهرة تحت المراقبة وطلبت من رئاسة الحكومة في بغداد أن تحدّد لها أسلوب معاملة هذه السيدة. واستمرت
دارها تحت المراقبة ثلاثة شهور ولم يصرّح لأحد بدخول دارها أو بمحادثتها. ولما طال أمد حضور الجواب من حكومة بغداد، قامت حضرة الطاهرة بالاستفهام عما تم بشأنها. عند ذلك، رأت الحكومة إرسالها إلى بغداد حتى يأتي الجواب بشأنها من إسلامبول ثم صرحت لها بمغادرة بيتها والذهاب إلى بغداد على أن تأخذ معها كلا من السيدة شمس الضحى وورقة الفردوس أخت جناب (الملا حسين البشروئي) باب الباب ووالدتها أيضاّ. وما وصلن بغداد حتى أنزلهن حضرة الشيخ محمد شبل والد حضرة محمد مصطفى البغدادي في داره. ولما ضاق سكنها بالزائرين والزائرات اتخذت لها مسكنًا فسيحًا فاتسع لها مجال التبليغ ليل نهار فازدادت المراودة والاتصال بينها وبين أهالي بغداد وذاعت شهرتها في المدينة وهاج القوم واضطربوا وعلا صياحهم بينما كانت الطاهرة في معمعة الأخذ والرد مع علماء الكاظمين الذين كانوا يباحثونها ليقفوا على حقيقة الحال وكانت تقنع كل من حادثها من العلماء بأدلة واضحة وبراهين دامغة. وفي النهاية، كتبت لعلماء الشيعة بأنها ستقوم على مباهلتهم (يعني مناظرتهم) إن لم يقتنعوا بما تقيمه من الأدلة الواضحة والبراهين القاطعة. فأثار ذلك حفيظة العلماء الذين أجبروا الحكومة على أن ترسلها هي وبعض النساء إلى دار مفتي بغداد المدعو "ابن الآلوسي". فآقامت في دار المفتي ثلاثة شهور في انتظار الأمر من الآستانة. كان المفتي، خلال مدة آقامتها في بيته يباحثها في مسائل علمية معضلة فكانت تجيبه بأجوبة كافية شافية، وكان ذلك يثير فيه عوامل الغيظ والغضب مستغربًا مما كانت عليه من طلاقة اللسان وآقامة الحجج والبراهين الدامغة. واتفق أن ابن الآلوسي قد رأى رؤية وقصها على حضرة الطاهرة وطلب منها تعبيرها قائلا: "إنني رأيت في
منامي أن علماء الشيعة أتوا إلى ضريح سيد الشهداء (الحسين بن علي) المطهر ورفعوا مقصورة الضريح ونبشوا قبره المنور وعروا جسده المطهر وكشفوه للعيان ثم أرادوا أن يأخذوا رفاته المباركة، فمَنَعْتهم عن ذلك ورميت نفسي على الرفات". فقالت له السيدة الطاهرة: "إن تعبير رؤياك هو أنك ستخلّصني من يد علماء الشيعة". فقال ابن الآلوسي: "وهذا هو تعبيري لها أيضًا".
ولمّا وقف ابن الآلوسي على مدى اطلاعها وطول باعها في حل المسائل العلمية وشواهد التفسير كان يصرف أغلب أوقاته في طرح الأسئلة عليها فكانت تجيبه بأجوبة شافية وعلى الأخص فيما يتعلق بالحشر والنشر والميزان والصراط وما إلى ذلك. وكانت تروق له أجوبتها. واتفق أن أتى حضرة والد ابن الآلوسي إلى الدار وما أن وقع نظرة على حضرة الطاهرة حتى انطلق لسانه بأنواع السباب والشتائم واللعنات والطعن في الطاهرة بكل وقاحة وقلة حياء. فخجل ابنه من ذلك وأخذ في تقديم الأعذار لحضرة الطاهرة وقال لها: "إن الأمر بشأنك قد أتى من إسلامبول وفيه يأمر السلطان بإطلاق سراحك شريطة ألا تقيمي في الممالك العثمانية، وعليه يجب عليك أن تعدي عدة السفر وتبارحي المملكة". فما لبثت الطاهرة أن خرجت من بيت المفتي مع بعض النسوة وتهيأن للرحيل وبارحت بغداد في حراسة بعض الأحباء العرب بسلاحهم راجلين وكان من جملتهم حضرة الشيخ سلطان والشيخ محمد شبل ونجله الجليل محمد مصطفى البغدادي والشيخ صالح وهؤلاء الأربعة كانوا يمتطون جيادهم. وقد قام جناب الشيخ بدفع جميع النفقات حتى وصلوا مدينة – كرمانشاه – فنزلت النساء في دار على حدة والرجال في دار أخرى. فتوافد أهل المدينة
على حضرة الطاهرة بلا انقطاع للوقوف على ما لديها من مواضيع جديدة. وبعد أيام قلائل، هاجت العلماء وحكموا بإخراجها من المدينة فهاجم دارها مأمور الشرطة وأعوانه ونهبوا متاعها وبدّدوا كل ما كان بالدار ثم حملوا النساء في هودجٍ مكشوفٍ وساروا بالجميع من رجال ونساء إلى الصحراء وتركوهم يهيمون في البادية بلا زاد ولا فراش. عند ذلك كتبت الطاهرة إلى أمير المقاطعة تقول: "أيها الحاكم العادل، نحن بمنزلة ضيوف على حضرتك، فهل يستحق الضيوف مثل هذه المعاملة؟"
ولما وصلت رسالة الطاهرة إلى حاكم كرمانشاه قال: "إنني براء من مثل هذه المعاملة ولا علم لي بهذه السيدة. إن العلماء هم الذين أيقظوا هذه الفتنة". ثم أصدر أمرًا صارمًا بإعادة كل ما سلبه أو بدده المأمورون فورا إلى دار الحكومة، وقد كان. وبعد ذلك، أمر الحاكم بإحضار الركائب وأركبوا الطاهرة ومن في معيتها من وسط الصحراء إلى مدينة همدان. فتخلصوا من تلك الورطة وآقاموا في همدان هانئين حيث زار الطاهرة لفيف من علماء المدينة وكامل أفراد الأسرة الشاهانية قصد الاستفاضة من بياناتها القيّمة ثم سافرت إلى قزوين مع بعض رفاقها وأرسلت البقية إلى بغداد. وبينما هي في طريقها إلى قزوين إذ لآقاها كل من حضرة شمس الضحى والشيخ صالح وطلبا إليها أن تذهب معهما منفردة إلى دار أبيها فأبت إلا أن يكون معها رفيقاتها وعلى هذا الشرط ذهبت هي ورفيقاتها إلى بيت أبيها في قزوين، وأما الرجال الذين كانوا يحافظون عليها فقد نزلوا في النزل المعد للقوافل. ثم انتقلت الطاهرة بعد أيام معدودات إلى دار أخيها حيث جاء لملآقاتها نساء الأعيان واستمر الحال على هذا المنوال إلى أن وقع
حادث قتل الملا تقي عمها. فألقت الحكومة القبض على جميع البابيين في قزوين وأرسلت بعضهم إلى طهران ثم أعادوهم إلى قزوين وقتلوهم.
أما السبب المجهول لقتل ذلك الظالم– الحاج ملا تقي – فهو كونه صعد على المنبر وأمطر حضرة الشيخ الأكبر الجليل أحمد الإحسائي وابلاً من السباب والطعن واللعنات فأوقد بذلك نار الفتنة ووقع القوم في نزاع وخصام وبلغ مسامع القاصي والداني ما زلف به لسان الملا تقي من الشتائم والألفاظ النابية والعبارات الركيكة الدالة على قلة الحياء وكان من بين الذين سمعوا ما قاله الملا تقي شخص من أهالي شيراز حديث العهد باعتناق الأمر وقد كبُر عليه ما تفوه به الملا تقي من الألفاظ الخشنة في حق الشيخ أحمد الإحسائي فانتظر إلى أن جن الليل ثم ذهب إلى المسجد حيث الملا تقي المذكور ودس في حلقه رمحًا وركن إلى الفرار. ولما قابله الأحباء في الصباح أنّبوه وزجروه على ما فعل. وما كادت الحكومة تقف على ما وقع حتى أمرت باعتقال بعض الأتباع قصد التحقيق معهم أما هم فقد نفوا علمهم بالحادث وهذا مما زاد الأمر إبهامًا. وبعد عدة أيام سلم القاتل نفسه للحكومة واعترف بما اقترفت يداه وقال: "إن السبب الذي جعلني أقتل الملا تقي هو كونه قد سبّ ولعن المرحوم الشيخ أحمد الإحسائي علانية وعلى مسمع مني فهاجني ذلك فقتلته، وها أنا أسلم الآن نفسي لتطلقوا سراح من اعتقلتموهم بسبب هذا الحادث وتخلوا سبيلهم لأنهم أبرياء وأنا وحدي الجاني" فاعتقلوه وكبلوه بالسلاسل والأغلال وأرسلوه مع بقية المعتقلين الأبرياء إلى طهران مكبلين بالأصفاد.
وفي طهران، لم تُخْلِ الحكومة سبيل المعتقلين دون جرم مع اعتراف القاتل بارتكاب الجريمة. أما القاتل فقد تمكن من الهرب من السجن ليلاً إلى دار من هو حقًا صدفة اللؤلؤ الوحيدة، الصادق في محبة
الله، ذلك الكوكب المضيء في برج الفداء (حضرة رضا خان) بن رئيس ديوان محمد شاه المدعو محمد خان، وآقام لديه عدة أيام ثم فرّ خفية هو ورضا خان المذكور رادفَين على صهوة جواد واحد إلى قلعة مازندران. ولما علم محمد خان المشار إليه بفرارهما أرسل في طلبهما عددًا من الراكبة إلى جميع الجهات، فلم يعثروا عليهما بعد أن أعياهم البحث والتنقيب، أما هما فقد وصلا الطبرسي واستشهدا فيها.
أما الأحباء الذين اعتقلوا ظلمًا وعدوانًا فقد أُرسل بعضهم إلى قزوين حيث أسقوهم جام الاستشهاد.
وحدث أنه، بينما كان القائل في دار رضا خان المذكور، إذ دعاه ذات يوم أحد رؤساء الديوان وهو المدعو – ميرزا شفيع – وقال له: "يا حضرة الفاضل، هل أنت من أرباب الطرق أم من أهل شريعة من الشرائع؟ فإن كنت تنتمي إلى شريعة ما فكيف تقدم على قتل ذلك المجتهد الفاضل بأن أحدثت في عنقه جرحًا عميقا أدى إلى موته! وإن كنت من أرباب الطرق فليس من شروط أي طريقة كانت إيصال الأذى إلى مخلوق. فكيف أقدمت على قتل ذلك العالِم الشفيق المرحوم الملا تقي؟" وكانت القاتل يجيب بقوله: "يا صاحب الديوان هناك حقيقة واحدة وهي أنني قد جازيته جزاءًا يستحقّه".
وبالإجمال، إن هذه الحوادث وقعت قبل ذيوع الأمر وقبل أن تتضح حقيقته، لأنه لم يَدُرْ في خلد أحد، في ذلك الحين، أن دورة ظهور حضرة الأعلى (الباب)، روحي له الفداء، تنتهي بظهور الجمال المبارك، وعند ذلك يمحى أساس الانتقام من بين البرية ويوطّد أساس شريعة الله وهو "وأن تُقتلوا خير من تَقتلوا"، وينهار بنيان الحرب والقتال ولا تكون لمثل هذه الحوادث من أثر. هذا، وقد سطع بظهور
الجمال المبارك، والحمد لله، نور الصلح والسلام وحلّت المظلومية الكبرى. إذ حدث أنّ الرجال والنساء والأطفال في مدينة يزد، كانوا هدفًا للسهام وعرضة للسيوف والانتقام، وحدث أن هجم على هؤلاء المظلومين علماء السوء وأرباب الحكومة يدًا واحدة وسفكوا دماءهم وهم أبرياء وقطعوا أجساد المخدّرات إربًا إربًا، وطعنوا الأيتام بخناجر الجفاء وأبانوا أعناقهم وألقوا بأجسامهم في النيران بعد تمزيقها. ومع كل هذا، لم يتطاول أحد من الأحباء على هؤلاء الأعداء، بل كان الأحباء في كربلاء كلما شاهدوا الأعداء قادمين عليهم شاهرين سيوفهم ليقتلوهم وضعوا في أفواه تلكم الأعداء قطعًا من السكّر النبات قائلين: "هذا ليكون طعم حلاوة السكر في أفواهكم عندما تقتلونا نحن المساكين. لأن هذا مقام القداسة والشهادة الكبرى ومنتهى آمالنا".
وانتهى الحال، بجناب الطاهرة في قزوين بعد مقتل عمها غير الورع، أن وقعت في مخالب المصائب والأحزان والسجون وكاد قلبها أن يتفتت من هذه الوقائع المؤلمة رغم عظيم تضايقها من كثرة المراقبة من الشِحنة والشرطة. وبينما هي على هذا الحال، وإذا بالجمال المبارك قد أرسل المدعو جناب آقا ملا هادي القزويني زوج خاتون جان المشهورة من طهران إلى جناب الطاهرة قصد إحضارها إلى طهران فتمكن بحسن تدبيره من إحضارها إلى طهران فوصلتها ليلاً وذهبت إلى السراي المبارك حيث سكنت في الطابق العلوي. وما أن وصل خبر مجيئها إلى حكومة طهران حتى أخذت في البحث عنها، وأصبحت حديث القوم ولم يعلم مكان وجودها. ورغم كل هذا، كان يرد عليها الأحباء حيث هي بلا انقطاع وكانت تخاطب الرجال من وراء حجاب.
حدث أن حضر ذات يوم جناب آقا سيد يحيى الوحيد، ذلكالشخص الفريد، روح المقربين له الفداء، وجلس في غرفة الضيوف وكانت الطاهرة جالسة وراء الحجاب وكنت أنا نفسي (عبدالبهاء) إذ ذاك طفلاً جالسًا على حجرها وما لبثنا حتى أخذت الآيات والأحاديث تتدفق كالدر المنثور من فم جناب الوحيد في إثبات هذا الأمر وما لبثت الطاهرة أن هاجت ثم قالت: "يا يحيى، فأتِ بعمل إن كنت ذا علم رشيد. ليس الوقت وقت الأقوال والروايات إنما الوقت وقت الآيات البينات، وقت الاستقامة وهتك الأستار والأوهام وإعلاء كلمة الله، وقت تضحية الروح في سبيل الله. العمل! العمل! لابد من العمل!"
وبالإجمال، كان الجمال المبارك قد هيأ ما يلزم لراحة الطاهرة، من خدم وحشم، وما إلى ذلك وبعث بحضرتها إلى بدشت، وبعد عدة أيام تحرك الركاب المبارك إلى تلك الجهة ونزل خفية في بستان لجناب القدوس، روح المقربين له الفداء. أما هذا البستان فواقع في ميدان بمدينة بدشت تحيط به المياه الجارية والحدائق الغناء من ثلاث جهات وكأن ذلك البستان غبطة الجنان. أما حضرة الطاهرة، فكانت تقيم على حدة في بستان مجاور. وبعد قليل انتقل الجمال المبارك إلى بستان آخر ونصب خباءه ليقيم فيه حضرته. أما الأحباء، فقد نصبوا خيامهم في البستان الواقع في وسط الميدان وكان جناب القدوس وحضرة الطاهرة يتشرفان أثناء الليل بملآقاة الجمال المبارك. ولم تكن، إلى ذلك الحين، قد أعلنت قائمية حضرة الأعلى (الباب) (يعني أنه هو القائم الموعود). فقرّر الجمال المبارك هو وجناب القدوس إعلان الظهور الكلي وفسخ الشرائع الموجودة ونسخها. ثم اعتكف الجمال المبارك حكمة منه قصد النقاهة، وبعد ذلك، بارح جناب القدّوس خيمته وذهب على مرًاى من
الجميع إلى فسطاط الجمال المبارك ولما علمت الطاهرة باعتكاف جمال القدم، أرسلت إليه ترجوه أن يشرف بستانها مدة النقاهة فأجابها حضرته بقوله: "إنني أفضّل الآقامة في بستاني هذا ويمكنك أن تحضري لدينا". فخرجت من بستانها سافرة وتوجهت إلى خيمة جمال القدم. عند ذلك صاحت قائلة: "إن هذا لنقرة الناقور ونفخة الصور وإن الظهور الكلي قد أعلن". وقع الكل في حيرة وارتباك وهم يقولون: "كيف نسخت الشرائع وكيف خرجت هذه المرأة سافرة؟ "فتفضل جمال القدم في ذلك الحين بقوله: "اقرءوا سورة الواقعة". فقرأها أحد القراء، ثم أعلنت الدورة الجديدة وظهور القيامة الكبرى. ففرّ جميع الأصحاب لأول وهلة وانصرف بعضهم بالكلية ودبّ في روع بعضهم عامل الشكّ والارتياب غير أن بعضهم قد عاد إلى الحضور المبارك بعد التردّد. فاختلط الحابل بالنابل في مدينة بدشت بعد إعلان الظهور الكلي. وما لبث جناب القدوس أن توجه إلى قلعة الطبرسي وتأهب الجمال المبارك أيضًا للسفر إلى بلدة نيالا ليلاً ليتمكنوا من دخول قلعة الطبرسي. ولما علم بذلك حاكم بلدة آمل المدعو ميرزا تقي أتى ليلاً إلى نيالا على رأس سبعمائة جندي حاملين بنادقهم وحاصروا البلدة وأرجعوا الجمال المبارك إلى آمُل يحرسه اثنا عشر نفرًا من الراكبة، وهنا تكرّرت البلايا وتوالت المصائب على حضرته.
أما حضرة الطاهرةأنتيبمستيبنمتسيمبأما حضرة الطاهرة فقد ارتبكت واشتد قلقها في بدشت ووقعت فريسة النكبات. وأخيرا، ألقت الحكومة عليها القبض وأرسلتها إلى طهران وأنزلوها في بيت المدعو محمود خان كلانتر
محافظ المدينة بصفة سجينة. ولكن شدة انجذابها وعظيم اشتعالها جعلاها لم تستقرّ ولم تسكت عن التحدث في الأمر، وكان يزورها سيدات من أعيان وأكابر أهل طهران وغيرهم بحجة استماع حديثها والإصغاء لبياناتها.
واتفق أن آقامت إحدى العائلات عرسًا في بيت المحافظ المذكور فأقيمت الولائم ومدت الموائد وعليها من ألوان الطعام الفاخر ما لا يدخل تحت حصر وكان ضمن المدعوات سيدات الأسرة المالكة ونساء الوزراء وعقيلات الكبراء والعظماء والأعيان. وأخذت العازفات في العزف على آلات الطرب المتنوعة كالكمان والعود والسنطير وما إلى ذلك وغنّى بعضهن بعض المقطوعات الغزلية بألحان شجيّة واستمر ذلك طول الليل إلا أقلّه والكل غارقات في بحر الطرب العظيم. وبينما هن في لجة الفرح والمرح إذ شرعت الطاهرة في البيان والتقرير بحديثها الشيق فاسترعت الأسماع وجاءت السيدات من البيوت المجاورة وابتعدن عن سماع الطار والطنبور وآلات الطرب وتركن الفرح والمرح واللهو والتفَفْنَ حول الطاهرة ولَهَيْنَ عن النغمات باستماع حلو حديثها وشهيّ كلامها إلى أن انفضّ العرس بسلام.
أما الطاهرة، فقد استمرت سجينة في دار المحافظ إلى أن وقعت حادثة الشاه فصدر الأمر بقتلها ثم أخرجوها من بيت كلانتر المذكور بحجة الذهاب بها إلى منزل رئيس الوزراء فتزيّنت ما استطاعت ولبست أفخر ثيابها وطلَت وجهها بالعطر وماء الورد ودهنت شعرها بالروائح المسكيّة النفسية وبارحت دار المحافظ فقادها الحراس إلى بستان لينفّذوا فيها حكم الإعدام. ولما حان وقت قتلها تردّد الجلادون وامتنعوا عن قتلها. فأحضروا زنجيًّا نشوان يترنح وأعطوا لذلك الأسود
ذي القلب الأسود منديلاً ليدسه في حلقها ففعل ثم خنقها. وبعد أن فاضت روحها الزكية ألقوا بجسدها المطهر في بئر واقع في وسط البستان ورجموه بالحجارة ثم أهالوا عليه التراب. أما هي فكانت تتلقى كل ما حلّ بها (وهي على قيد الحياة) هاشة باشة مسرورة للغاية وفدت بروحها مستبشرة بالبشارات الكبرى متوجهة إلى الملكوت الأعلى. عليها التحية والثناء وطابت تربتها بطبقات من النور النازلة من السماء.
تمت ترجمة هذا الكتاب بعون الله تعالىفي يوم السبت الواقع في 2 سبتمبر سنة 1950- بالقاهرة
1